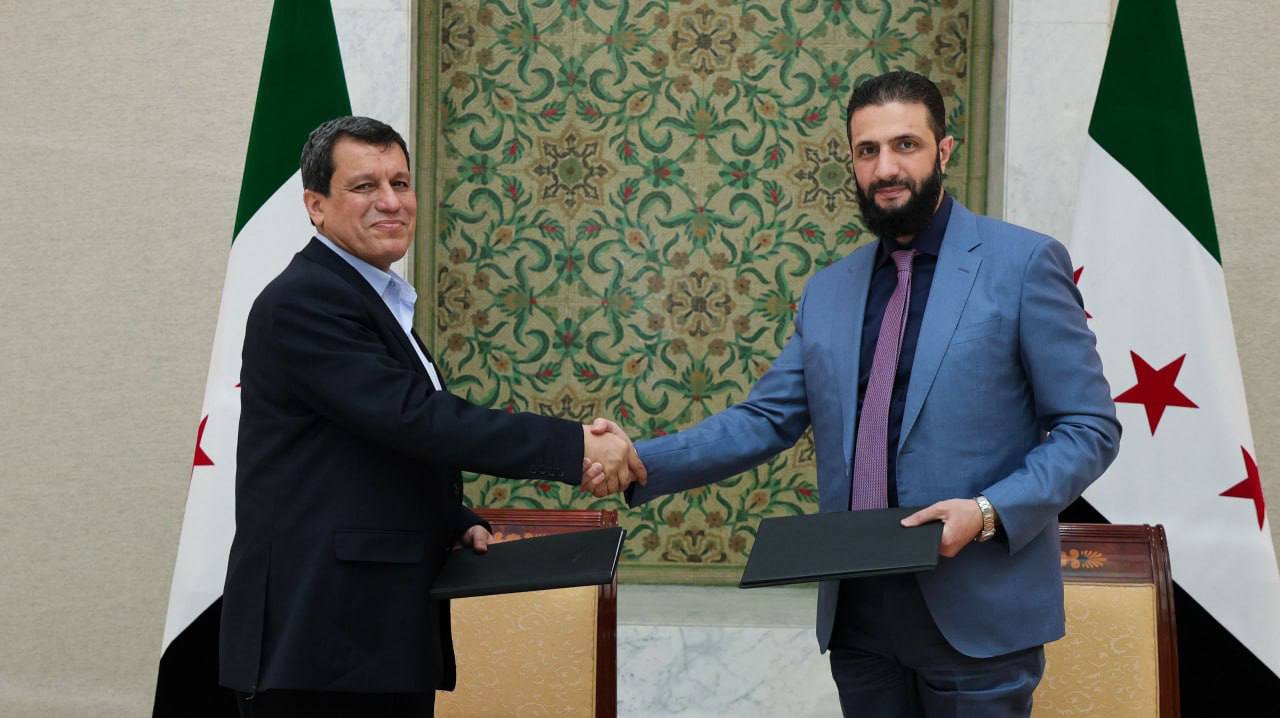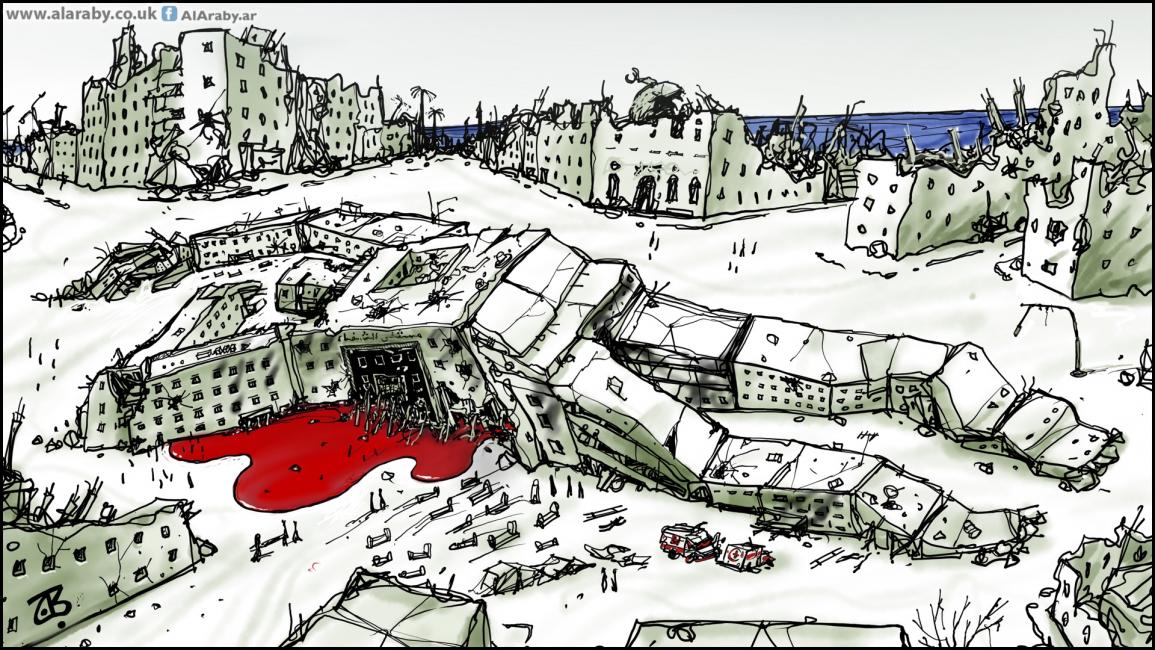بقلم: الحاج بكر الحسيني
منذ قرون بعيدة يحاول خصوم الأمة العربية أن يلصقوا بها صورة مشوّهة، فيختزلون العرب في جماعات من البدو الرحل الذين حفاتاً لا يعرفون غير الرمال والخيام والإبل. يزعمون أنهم لم يعرفوا دولة ولا مدينة ولا علماً، وأنهم عاشوا على هامش التاريخ حتى أتى الإسلام فغيّرهم. هذه النظرة ليست مجرد خطأ، بل افتراء متعمد لتشويه هوية العرب والتقليل من شأنهم الحضاري. والحقيقة التي تشهد بها الآثار والمرقومات الحجرية والقلاع والقصور، وما سطّره العلماء والمفكرون، أن العرب كانوا منذ آلاف السنين أهل عمران وثقافة، بناة دول، صناع علوم، حملة رسالة إنسانية عبر الزمان والمكان.
اليمن هو الدليل الأول الذي يفنّد هذه المزاعم. ففي مأرب وصرواح وذمار وعدن، قامت حضارات سبأ ومعين وقتبان وحِمير، وتركت وراءها نقوشاً حجرية تشهد على وجود عربي عريق. تلك المرقومات لم تكن حروفاً على صخر وحسب، بل وثائق كاملة: معاهدات سياسية، قوانين ضرائب، اتفاقيات تحالف، ونقوش دينية. وسد مأرب العظيم، الذي ظل قائماً قروناً طويلة، لم يكن عملاً بدائياً بل إنجازاً هندسياً وإدارياً بالغ الدقة. أسماء الملوك مثل كرب إل وتر وياسر يهنعم وشمر يهرعش تشهد أننا أمام تاريخ دول وممالك لا أمام قبائل شاردة. وحين نعلم أن طرق التجارة العربية – طريق البخور واللبان – وصلت من اليمن إلى الهند وفارس والشام، ندرك أن العرب كانوا جزءًا من الاقتصاد العالمي قبل الميلاد بقرون.
ومن اليمن إلى عُمان، نرى وجهاً آخر للعمران العربي. عُمان لم تكن مجرد صحراء وبادية، بل أرض قلاع وحصون وأساطيل. قلعة نزوى الشهيرة، وقلعة بهلاء المدرجة اليوم في قائمة التراث العالمي، وحصون صحار ومسقط، كلها شواهد على أن العرب أتقنوا فنون التحصين والسيطرة على طرق التجارة البحرية. لقد تحولت عُمان إلى قوة ضاربة في بحر العرب والمحيط الهندي، حتى صارت مدنها الساحلية مراكز للتبادل التجاري والثقافي. العرب في عُمان أثبتوا أن البحر امتداد طبيعي للصحراء، وأنهم قادرون على بسط نفوذهم براً وبحراً معاً.
أما في بلاد الشام والعراق، فقد تواصل العمران العربي مع الحضارات المجاورة وأبدع ملامحه الخاصة. الغساسنة والمناذرة شيّدوا قصوراً عظيمة مثل قصر الخورنق والسدير في الحيرة، حتى أن ملوك الفرس انبهروا بفخامتها وروعة زخرفها. وفي القدس، تجلّت عظمة الحضور العربي الإسلامي ببناء قبة الصخرة الذهبية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، فكانت تحفة معمارية فريدة تزين المدينة المقدسة وتعلن هوية الأمة، بقبابها المذهبة وزخارفها القرآنية البديعة التي مثّلت أول منجز معماري إسلامي ضخم ما زال شاخصاً حتى اليوم. ثم جاءت دمشق الأمويين لتشهد بناء المسجد الأموي الكبير، الذي يعد أعظم مساجد الإسلام قاطبةً. وكان موضعه في الأصل كنيسة صغيرة، لكن الأمويين لم يأخذوها عنوة، بل استرضوا القساوسة وبنوا لهم ثلاثين كنيسة في المدينة، حتى لا يقال إنهم غصبوها. هكذا ارتفع المسجد الأموي على أسس من العدل والحكمة، جامعاً بين الفسيفساء الملوّنة والرخام البديع والخط العربي في لوحة مهيبة لا يزال العالم يقف أمامها مبهوراً. إن هذه المنجزات، من قصور الحيرة إلى قبة القدس الذهبية إلى مسجد دمشق الأموي، تثبت أن العرب لم يكونوا قوماً منغلقين على الصحراء، بل بناة مدن وفنون وحملة رسالة حضارية جامعة .
ومع بزوغ الإسلام، دخل العرب عصراً جديداً من العمران والدولة. المدن الجديدة التي أسسوها – الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان – لم تكن معسكرات عابرة، بل تحولت إلى عواصم مزدهرة للعلم والأدب والفقه. الكوفة والبصرة صارتا منارات للغة والشعر والنحو، والفسطاط تحولت إلى مركز إداري وعلمي كبير، والقيروان صارت بوابة المغرب العربي إلى الحضارة. وفي الأندلس، بلغت العمارة العربية ذروتها: جامع قرطبة بأعمدته الباسقة، قصر الحمراء بقبابه وزخارفه وحدائقه، إشبيلية بحدائقها المائية. كل ذلك كان تعبيراً عن هوية عمرانية لا مثيل لها.
غير أن العمران لم يكن حجراً وحده، بل كان بناءً للعقل أيضاً. ففي بغداد، أنشأ الخليفة المأمون بيت الحكمة، أول أكاديمية عالمية تجمع الترجمة بالبحث بالتأليف. هناك وُلدت نهضة علمية كبرى: الخوارزمي ابتكر علم الجبر والخوارزميات، الرازي أسس أول مستشفى تعليمي واعتمد المنهج التجريبي، ابن سينا ألّف “القانون في الطب” الذي صار مرجع أوروبا لخمسة قرون، ابن الهيثم وضع أسس علم البصريات التجريبية، وابن رشد أعاد قراءة الفلسفة بعقل نقدي فأثر في الفكر الأوروبي.
ولم يكن العلماء يبدعون فرادى بلا سند، بل في ظل رعاية الدولة العربية الإسلامية. المأمون أغدق الأموال على المترجمين والعلماء حتى كان يعطيهم وزن كتبهم ذهباً. الرازي حين بُعث لتأسيس بيمارستان في بغداد اختار الموقع بالتجربة والملاحظة، وهو ما لم يكن ممكناً لولا تمويل الدولة. ابن سينا وجد الدعم من الأمراء الذين وفّروا له المعامل والكتب. مكتبة الحكم المستنصر في قرطبة ضمّت مئات آلاف الكتب، وخلقت بيئة علمية لأمثال ابن رشد وابن زهر. حتى ابن الهيثم في مصر، حين نُفي، وُفرت له إقامة آمنة ليواصل أبحاثه. الدولة لم تترك العلماء لمصيرهم، بل كانت تموّلهم وتتبنى مشاريعهم، وهذا سرّ الازدهار.
وهنا تبرز الحقيقة الجوهرية: العلماء يُنسبون إلى الحضارة التي احتضنتهم. لو أن شاباً عربياً اليوم ذهب إلى فرنسا، ودرس في جامعاتها، وأجرى بحوثاً في مختبراتها، ثم اكتشف علاجاً أو قانوناً علمياً جديداً، فإن العالم سيقول عنه: عالم فرنسي. لن يقولوا: عربي في أصله. الهوية الحضارية تُنسب إلى الكيان الجامع، لا إلى العرق الفردي. وعلى هذا القياس نفهم أن سيبويه الفارسي الأصل هو عالم عربي لأنه كتب بالعربية وخدمها، وأن البخاري من بخارى عالم عربي–إسلامي لأنه خدم الأمة، وأن الفارابي والبيروني والطبري وغيرهم صاروا جزءًا من الحضارة العربية الإسلامية لأنهم أبدعوا في إطارها.
والأجمل أن العربي، وإن عاش في القصور والقلاع، ظل وفياً لرموز أصالته. محبٌّ للخيمة التي ترمز إلى الحرية والانتماء، محبٌّ للدلة التي تغلي قهوته رمزاً للكرم والضيافة، محبٌّ لفرسه التي تمثل شرفه ورفيقه في الحرب والسلم، محبٌّ لسيفه الذي يدافع به عن الأرض والعرض. هذه العناصر ليست مظاهر بدائية كما يصوّرها البعض، بل هي جزء من تكوين الهوية العربية. الخيمة لم تكن نقيض القصر، بل امتداد له، والدلة لم تكن نقيض الكتاب، بل رفيقة لمجالس العلم، والفرس والسيف لم يكونا بديلاً عن العمران، بل وسيلة لحمايته وصيانته. بهذا ظل العربي يجمع بين الأصالة والتجدد، بين البداوة التي تحفظ والتمدّن الذي يبني.
وعندما نطل على الأندلس، نجد أن العرب جمعوا بين العمران والعلم بأبهى صورة. لم تبق إنجازاتهم هناك محصورة في قصور الحمراء وحدائق إشبيلية، بل امتدت إلى المدارس والمكتبات والمستشفيات. أوروبا التي كانت غارقة في ظلام العصور الوسطى، وجدت نفسها أمام حضارة عربية مشرقة، فنقلت كتب ابن رشد وابن سينا والخوارزمي إلى اللاتينية. مصطلحات مثل algebra وalgorithm وzenith دخلت مباشرة من العربية إلى اللغات الأوروبية. وهكذا كان العرب جسر النهضة الأوروبية.
كل ذلك يضع أمامنا درساً بليغاً: العروبة ليست بدواً ولا صحراء فقط، بل مشروع حضاري ممتد. من المرقومات الحجرية في اليمن إلى قلاع عمان، من قصور الحيرة إلى مسجد دمشق، من بغداد إلى قرطبة، العرب كتبوا وجودهم على الحجر والعلم معاً. اليوم نحن بحاجة إلى استعادة تلك الروح: روح المبادرة، روح الاستثمار في العلم، روح احتضان المبدعين.
إن محاولة تصوير العرب كبدو رحل لا يعرفون غير الرمال والخيام ظلم للتاريخ. نحن أبناء سبأ وحِمير، بناة سد مأرب وقصور غمدان، نحن أحفاد قادة الأساطيل العُمانية الذين جابوا المحيطات، نحن ورثة بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة، نحن حملة مشعل الخوارزمي والرازي وابن سينا وابن رشد. نحن الأمة التي احتضنت غيرها فأغنته وأغناها، وصدّرت علومها إلى الإنسانية جمعاء. هذه هي العروبة: حضارة حيّة، إنسانية، قادرة على أن تنهض من جديد، لا يمحوها افتراء ولا ينال منها حقد.