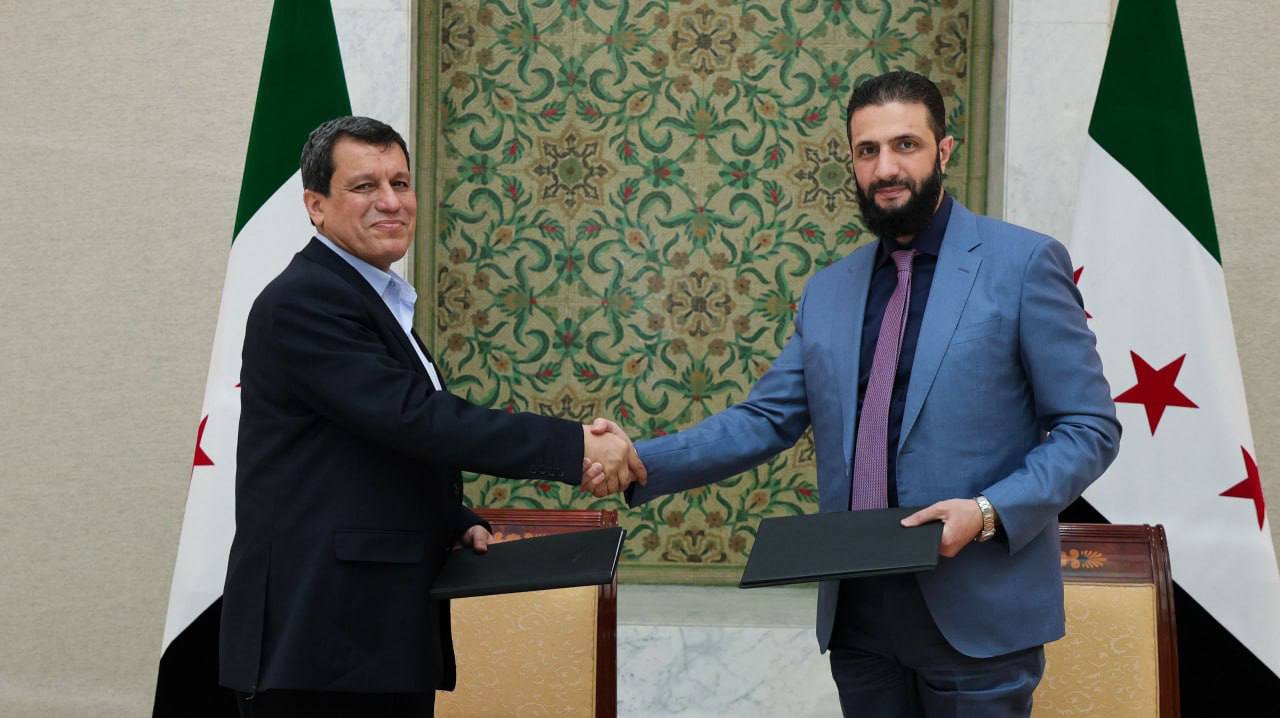المصدر: مجلة Prospect
الثلاثاء 19 كانون الاول , 2023
تراجع أمريكا – سارة موريس
يعتبر البروفيسور صامويل موين – أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل – في هذا المقال الذي نشرته مجلة ” prospect” الإنكليزية وقام بترجمته موقع الخنادق، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصارها في نهاية الحرب الباردة، تعهدت بقيادة البشرية في نظام عالمي جديد. مضيفاً بأن صراعا غزة وأوكرانيا قد كشفا بأنها باتت أضعف من أي وقت مضى في سياق هذا الدور. واللافت بانه حدّد تاريخ عملية طوفان الأقصى كنقطة تحوّل للدور العالمي لأمريكا.
النص المترجم:
سيُسجل تاريخ 7 أكتوبر 2023 في التاريخ، كنقطة تحول للدور العالمي للولايات المتحدة. وقد تلقى وعد البلاد بالدفاع عن الديمقراطية وتقديم نموذج لها على الساحة العالمية ضربة قوية، ومن المشكوك فيه أن تتمكن من التعافي منها. وعندما بدأت حرب أوكرانيا في عام 2022، واستجابت الولايات المتحدة بمساعدات عسكرية هائلة، انتعشت مصداقية هذا الوعد لفترة وجيزة بعد كابوس رئاسة دونالد ترامب. والآن تحطمت مرة أخرى، لتنضم إلى أنقاض شوارع غزة.
كان اليوم الرهيب الذي شهد احتجاز الرهائن والمذبحة الجماعية التي راح ضحيتها 1200 إسرائيلي، أغلبهم من المدنيين، على أيدي حماس، سبباً في اندلاع حرب بغيضة في غزة، حيث تركزت كل الأنظار على التكاليف البشرية غير المسبوقة الناجمة عن أعمال العنف. لكن أكبر تداعيات ذلك اليوم تتجاوز المصير المؤسف لقطعة أرض صغيرة ومكتظة بالسكان، ويبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة. وسرعان ما وضع هذا التوغل الوحشي حداً لحالة الحنين إلى الماضي بشأن سعي الولايات المتحدة الوهمي إلى تحقيق الديمقراطية على مستوى العالم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب لا تحصى بالنسبة لمجيء نظام عالمي جديد.
قبل عام واحد فقط، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إحياء الآمال في استعادة العالم بقيادة الولايات المتحدة. وتحدث الساسة والإعلاميون عبر الأطلسي عن المواجهة بين “الديمقراطية” وأعدائها، وهي المواجهة التي لم تطالب بأقل من ذلك. ويتعين على القيادة الأميركية، المألوفة منذ الحرب الباردة وما بعدها، أن تتخذ شكلاً جديداً، يتجاوز الأخطاء الصارخة التي جعلتها غير شعبية. ولكن المحنة التي تعيشها أوكرانيا أثبتت الحاجة إلى هذه الزعامة وتشير ضمناً إلى احتمال قدرة أميركا على الإصلاح. إن القيادة الأميركية المصححة لم تكن مرغوبة فحسب؛ كان ضروريا. ووفقا للصحفي الليبرالي جورج باكر، لم يكن ذلك أقل من “آخر أفضل أمل”.
الأمل الكاذب الأخير هو أشبه به. واليوم، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود. فبعد أن تعثرت الولايات المتحدة في مستنقع الانتقادات الموجهة إلى التيار الرئيسي للسياسة الخارجية، ودمرها سجلها من المستنقعات العسكرية، لم تعد تتمتع بالمصداقية باعتبارها العمود الفقري للحرية والعدالة في مختلف أنحاء العالم. وقد عززت غزة هذا الاستنتاج من دون الانتظار المليء بالمذابح الذي شهدته أوكرانيا؛ وبعد أن تصرفت حماس، تحطمت التطلعات الوهمية لاستعادة المصداقية للقيادة الأمريكية في غضون أيام، وليس أشهر أو سنوات. وسوف يأتي الأسوأ، إذا وضعت أمريكا ديمقراطيتها على المحك، حتى في الوقت الذي استثمرت فيه في حرب أخرى لا نهاية لها.
صعد جو بايدن إلى الرئاسة الأميركية ووعد بإنقاذ الديمقراطية من التهديدات الداخلية. في البداية، وافقت إدارته دون قيد أو شرط على بدء إسرائيل غزواً برياً على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يكون شاقاً ودموياً كما أصبح في الواقع. وفي خطاب متلفز مساء يوم 20 أكتوبر، تجاهل المعارضة المتزايدة في الداخل والخارج بشأن هذا الأمر وفشل سياسته في أوكرانيا، وبدلاً من ذلك انتهز الفرصة للدعوة إلى استعادة أمريكا بدلاً من التراجع على المسرح العالمي. واستحضر “مسؤولياتنا كأمة عظيمة”، وأشار إلى المقولة المفعمة بالأمل التي قالتها “صديقته مادلين أولبرايت” (وزيرة الخارجية الراحلة) بأن الولايات المتحدة هي “الأمة التي لا غنى عنها”. وضع بايدن أوكرانيا وغزة في نفس الإطار وأصر على أنهما يقدمان مناسبة أخرى للإشراف الأمريكي.
لم تعد الولايات المتحدة ذات مصداقية باعتبارها العمود الفقري للحرية والعدالة في جميع أنحاء العالم
وكتب فينتان أوتول في مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس: “كان رد الرئيس على هجمات حماس في 7 أكتوبر هو دمج الحربين في إسرائيل وأوكرانيا في صراع واحد”. وفي كلتا الحالتين، أكد بايدن أن الشر يضرب أولاً ومن دون أي استفزاز. وقال إنه في كلتا الحالتين، كان المستبدون يأملون في “القضاء التام” على الديمقراطية. وفي كلتا الحالتين، كانت أمريكا، من خلال حلفائها وأفعالها، مدعوة إما للدفاع عن الحرية أو تموت. لم تكن المصالح التافهة للدول، بل التوقعات المشروعة للبشرية جمعاء، هي التي كانت على المحك. قال بايدن: “هناك أناس أبرياء في جميع أنحاء العالم يأملون بسببنا، ويؤمنون بحياة أفضل بفضلنا، المحترقين حتى لا ننساهم، والذين ينتظروننا”.
إن تشبيه بايدن – الذي كرره حرفيًا بعد أسابيع من الوضع المعقد – معيب. ولكن الحقيقة هي أن الأزمتين، منفصلتين ومجتمعتين، تظهران حدود قوة أميركا. ويبدو أن كليهما يعمل على التعجيل بانحدار قيادته، في حين يعرض ديمقراطيته للخطر. إن العالم يائس، ولكن لا ينبغي لضحاياه أن ينتظروا الولايات المتحدة، المثقلة بأخطائها في الماضي والحاضر، حتى أنها قد لا تنجح في إنقاذ ديمقراطيتها منها.
لقد انهارت السياسة الخارجية الأميركية بشدة منذ عام 1989، عندما خرجت من عقود من الصراع الداخلي والعنف العسكري باعتبارها المنتصر الوحيد في الحرب الباردة.
وفي أعقاب انتصارها أعلن الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب عن “نظام عالمي جديد” ستقوده الولايات المتحدة، وتستفيد منه البشرية. وكان نجاح بوش في صد العدوان العراقي على الكويت في حرب الخليج الأولى سبباً في نشوء توقعات مبتهجة بالحكم الرحيم من قِبَل قوة عظمى واحدة. لقد نجحت تلك الحرب، التي كانت بمثابة انتصار مثير مقارنة بالعديد من الكوارث التي سبقتها (ومن بعدها)، في تهدئة أشباح الفشل العسكري القديمة الناجمة عن الحرب الباردة، وخاصة في فيتنام. ومن خلال ضبط النفس الذي أبداه بوش في السماح للقوات العراقية بالفرار عائدة عبر الحدود، وبقاء الطاغية صدّام حسين في السلطة، أشارت الأحداث إلى أن الحرية الألفية تحت رعاية الولايات المتحدة لا تنطوي بالضرورة على خلاص أو تهور.
لقد جاءت وعود بوش بنظام عالمي جديد في عام 1990 في خطابة مثيرة للغاية. وأوضح أنه “لا يوجد بديل للقيادة الأميركية”. وفي مواجهة الطغيان، لا ينبغي لأحد أن يشكك في مصداقية أمريكا وموثوقيتها. لا ينبغي لأحد أن يشكك في قدرتنا على البقاء. إن القوة الأحادية الجانب للبلاد من شأنها أن تبشر بـ “عصر جديد – أكثر تحرراً من تهديد الإرهاب، وأقوى في السعي لتحقيق العدالة وأكثر أماناً في السعي من أجل السلام”. عصر يمكن فيه لدول العالم، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، أن تزدهر وتعيش في وئام. لقد بحث مائة جيل عن هذا الطريق بعيد المنال نحو السلام، بينما اندلعت آلاف الحروب عبر نطاق المساعي البشرية.
لقد حطمت سلسلة من الحقائق القاسية هذا الوهم اللطيف. ولم تكن حرب العراق فقط هي التي أمر بها نجل بوش في عام 2003. سواء من أجل إنقاذ المدنيين، كما في حالة تغيير النظام الليبي في عام 2011، أو باسم الدفاع عن النفس، كما في الحرب على الإرهاب. والآن كانت الحروب الأمريكية الألف هي التي اندلعت. ولم تؤدي هذه التدابير إلى جعل العالم أسوأ حالا، بل كانت في نهاية المطاف كافية للمساعدة في جعل ترامب ذا مصداقية في عام 2016، وبالتالي تعريض استمرارية الديمقراطية الأميركية ذاتها للخطر. فعندما صدم ترامب دعاة الحرب من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، الذين واصلوا التبشير بضرورة الدور الذي لا غنى عنه للولايات المتحدة وسط ضباب الحروب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ظل بوسع كثيرين أن يشعروا بالإهانة ــ ولكن تم استبعادهم بشكل غير رسمي من دائرة السلطة لمدة أربع سنوات.
ولكن بدلاً من الحث على حساب كيف أدت الحرب التي لا نهاية لها في الخارج إلى انتصار ترامب غير المتوقع، تعامل كثيرون علناً مع غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 باعتباره من العناية الإلهية. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد زودت كادر نخب بيلتواي (الطبقة السياسية والإعلامية الحاكمة في واشنطن)، الذين أزعجهم الماضي المباشر بـ “إحساس جديد بالمهمة”، و”أعادت تنشيط دور واشنطن القيادي في العالم الديمقراطي بعد أشهر قليلة من الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان الذي أنهى 20 عامًا من الصراع بشكل كئيب”.
ومن الواضح أن تصرف بوتين ــ الذي بدا وكأنه يسعى إلى تحقيق هدف رجعي يتمثل في الغزو الإقليمي، وهو ما لم تنحني له الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية ــ كان شنيعاً إلى الحد الذي جعله يتطلب الرد. وكانت وحشية روسيا في الميدان بمثابة مناسبة مشروعة للاشمئزاز والغضب.
لكن رغبات الترميم كانت تتحقق أيضًا. أتاحت المرتفعات المضاءة بنور الشمس لسبب عادل مشهدًا جديدًا بعد فترة مظلمة. ويمكن للنخب الأطلسية أن تسعى إلى طي الصفحة، وإدانة العدوان الروسي في حين تخفي ذاكرة الغرب بارتياح واضح. تم نفض الغبار عن كتب اللعب القديمة. وقد عاد الدبلوماسيون إلى العمل لتنظيم القرارات والعقوبات؛ وتم تحرير شيكات كبيرة لصديق جيد في تجمع الديمقراطيات؛ وتم إرسال المعدات العسكرية لاستخدامها في ساحة المعركة؛ وسافر خبراء يرتدون الزي العسكري لتقديم المشورة؛ همهمة شبكات الاستخبارات. بين عشية وضحاها، أعادت الحرب منظمة حلف شمال الأطلسي إلى هدف ما. وفي الواقع، وعلى الرغم من الادعاءات بأن توسع حلف شمال الأطلسي قد أدى إلى التعجيل بالصراع، فقد أدى ذلك إلى انضمام فنلندا إلى الناتو، كما أن السويد تسير على طريقها الخاص أيضًا. وعلى المستوى الدولي، تمت إعادة تدوير الخطاب المألوف حول الديمقراطية والحرية. لقد تحركت أميركا إلى الوراء من التعقيدات الأخلاقية التي خلفتها حربها ضد الإرهاب إلى حرب باردة جديدة وأرضية أخلاقية مألوفة.
خلال الأشهر الأولى من الحرب في أوكرانيا، كان هناك إجماع مهيمن حول “الوحدة الغربية” في مواجهة الهمجية الروسية. وإلى جانب الرعب الحقيقي من عدوان ووحشية غزو بوتين، جمع العديد من السياسيين والإعلاميين بين الشماتة حول قضية جديدة خالصة للقيادة مع ارتياح واضح بشأن وضع عصر ترامب، مع هجماته على حلف شمال الأطلسي وتسليط الضوء على الحروب غير المثمرة، وراء ظهرهم.
ولكن النشوة التي ساهمت في صد بوتين بهذه السرعة، في انعكاس بطولي للتكهنات بانتصاره الخاطف، لم تتمكن من إخفاء خطر الوقوع في المستنقع. إذا لم يكن من الممكن طرد روسيا إلى ما وراء الحدود السيادية لأوكرانيا قبل الغزو، ناهيك عن حدودها الأصلية التي انتهكت عندما ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014، فلا بد من التوصل إلى اتفاق ما. وقد دعا عدد قليل منهم إلى إجراء محادثات سلام منذ البداية، ولكنهم غرقوا في الأصوات المنتقدة التي أصرت على أن الديمقراطيات لا يمكنها الاستسلام للطغاة أو استرضاء الإمبريالية التي ترتكب إبادة جماعية، حتى لو كانت التكلفة من الدماء والأموال باهظة.
وفي غضون فترة قصيرة، تحولت حرب أوكرانيا إلى حرب مواقع في الشرق، مع أكبر خسارة إقليمية لروسيا في مايو/أيار 2022، عندما تم استعادة منطقة خاركيف. منذ ذلك الحين، تغيرت خطوط المعركة بشكل مجهري، حتى بعد “هجوم مضاد” صاخب.
وقد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 80 مليار دولار (بما في ذلك ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية). وقد شارك الأوروبيون بحماس، مع تخلي ألمانيا عن أي بقايا من تراثها السلمي وتخلي بلدان الشمال عن حيادها التاريخي. ويمكنهم أن يزعموا تحقيق انتصار دفاعي في إنقاذ الديمقراطية الأوكرانية – ولا شك أن أوكرانيا لم تكن لتتمكن من محاربة روسيا حتى طريق مسدود دون مساعدة أمريكية وغيرها. لكن ذلك كان صحيحاً منذ الأسابيع الأولى للحرب. ولم تفعل الأموال والأسلحة شيئا منذ ذلك الحين لطرد بوتين من حيث أتى. ورغم أن الثمن كان باهظا بالنسبة لروسيا، حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 100 ألف قتيل وكميات غير عادية من العتاد، فإن بوتين كان أيضا على استعداد لدفعه. وبعد مرور عام، يبدو أن المتشككين قد ثبت أنهم على حق. لاحظت ليلي لينش في مجلة نيو ستيتسمان مؤخراً أن “الضجة التي اتسمت بها التغطية الإعلامية المبكرة قد تحولت إلى الهلاك”.
والأمر الأكثر لفتاً للانتباه في الرد الأميركي الموازي بعد مرور ثمانية عشر شهراً على توغل حماس عبر سياج غزة هو أن مصداقية العلاج الأميركي فيما يتصل بالديمقراطية ودفاعها انهارت منذ البداية تقريباً، وبشكل أكثر وضوحاً. وهذه المرة لم تتمكن أميركا من إيقاظ العالم حول سياستها وخطابها المحاصرين.
لم يكن ذلك بسبب عدم المحاولة. في الأيام الأولى من الرد المروع على هجوم حماس، لم يكن بايدن يشبه أحداً أكثر من جورج دبليو بوش في رده المتشدد على الإرهاب. كان الخصوم “شرًا محضاً خالصًا”، ولم تكن هناك حلول سياسية سوى تدميرهم. وعلى نحو مماثل، ظهرت هيلاري كلينتون – التي لم تتعلم أي شيء من سجلها الحافل بالتحريض على الحرب الفاشلة في تغيير النظامين العراقي والليبي – على شاشات التلفزيون لتكرر نفس العبارات المجازية عن “همجية” و”وحشية” حماس، كما لو كانت إمبريالية القرن التاسع عشر. كانت بمثابة نص قابل للتطبيق لسياسة القرن الحادي والعشرين. ومن الواضح أن قضية عالم الديمقراطيات الحر تعني إصدار شيك على بياض لإسرائيل.
في هذا الجو المانوي (نسبة للديانة المانوية التي تقسّم كل شيء إلى خير أو شر)، تم تسجيل بوش نفسه على أنه يوافق على الرد غير المحظور على الإرهاب في إسرائيل – لكن رد الفعل العكسي أوضح أن بايدن كان يحاول تضخيم خطاب بوش في وقت كان فيه التسامح معه أقل بكثير. وعلق مايكل شيفر، صحفي في صحيفة بوليتيكو، قائلا: “هناك على الأقل بعض الوعي بمخاطر الاستجابة العاطفية للإرهاب”. “سواء كنت تعتقد أن هذه الحساسية يجب أن تقود السياسة أم لا، فقد يكون ذلك هو الإرث السياسي الوحيد وغير المقصود لبوش في واشنطن”. وحتى قبل بدء العملية البرية الدموية التي شنتها إسرائيل على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، كان رأي العديد من الأميركيين ومعظم دول العالم يشير إلى أن الشيك على بياض الذي تلقته إسرائيل بالفعل قد يحتاج إلى بعض التعديلات.
وكان السبب الأوضح لمزيد من الشكوك المباشرة هو الأخلاقيات المشحونة للصراع في إسرائيل وفلسطين، والتي جعلت من الصعب على بايدن الحفاظ على القياس بين الفلسطينيين والروس. وبعيداً عن كونها واحة للحرية في صحراء الطغيان، فقد اتجهت إسرائيل نحو معاداة الديمقراطية في العقود الأخيرة، تحت قيادة ائتلافها اليميني المتشدد الذي يحكمه بنيامين نتنياهو. وأياً كان رأي المرء في أوراق الاعتماد الديمقراطية التي تخول أوكرانيا للحصول على المساعدة الخارجية، فإن إسرائيل عاشت للتو موجة احتجاجية ضخمة مستوحاة من المخاوف من تخلي ائتلاف نتنياهو عن أوراق اعتماده الديمقراطية.
والأهم من ذلك أن الفساد الذي لا شك فيه لأفعال حماس لا يمكن أن ينفي التاريخ الاستعماري الذي أنتج الوضع في غزة. إن التشابه بين حماس وبوتين يتضاءل بجانب التشابه في خضوع الشعب الفلسطيني لتاريخ الإمبريالية الروسية الذي يحلم بوتين بإحيائه. وفي غضون أيام، حتى الرئيس السابق باراك أوباما، كما قالت صحيفة نيويورك تايمز بدقة، كان “يحاول على ما يبدو تحقيق التوازن بين عمليات القتل على جانبي الصراع”. وتساءل أوباما بشكل مثير للدهشة: من لم يكن “متواطئاً إلى حد ما” في دورات العنف – وهو بعيد كل البعد عن الإجماع بعد أحداث 11 سبتمبر على أن الأقوياء في العالم أبرياء، وأن الأعمال المرتكبة ضدهم لا يمكن تفسيرها، وأن العنف الذي يرتكبونه في الرد لا يمكن لومه.
ومع ذلك، فإن إدراك أن مجرد الانحياز إلى إسرائيل لن ينجح، استغرق وقتاً طويلاً مؤلماً بالنسبة لبايدن وكبار موظفيه.
قد تم ضبط التعاطف الافتراضي مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، وخاصة بين الشباب الأميركي. والواقع أنه اعترافاً بالتحولات العميقة في الرأي الأميركي الليبرالي واليساري، ومواكبة الدعم العالمي الطويل الأمد للقضية الوطنية الفلسطينية، سرعان ما أبلغ بايدن وموظفوه إسرائيل بأن المجال المتاح لها للمناورة قد لا يستمر إلى أجل غير مسمى. وذكرت شبكة “سي إن إن” في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر أن “بعض المستشارين المقربين للرئيس يعتقدون أنه لا يوجد سوى أسابيع، وليس أشهر، قبل أن يصبح رفض الضغط على الحكومة الأمريكية للدعوة علناً لوقف إطلاق النار أمراً لا يمكن الدفاع عنه”.
وفي غضون أيام من السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، اتضح أن حسابات بايدن الاستراتيجية كانت تتمثل في تأجيل هذا الاحتمال لأطول فترة ممكنة من خلال الإصرار على التزام إسرائيل بالحدود الإنسانية في ردها. وتماشياً مع إصرار أمريكا على الحق غير المحدود عملياً في الدفاع المسلح عن النفس، والذي يتوازن مع وعد “الإنسانية” في الحرب، حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل من الحرص على عدم إيذاء الكثير من المدنيين. وكما لاحظت صحيفة لوموند، فإن البيت الأبيض “اضطر إلى تحريك الإبرة” من خلال التأكيد على أهمية “قوانين الحرب”.
في الأيام الأولى، اقترنت هذه التذكيرات بالتطمينات بأن تلك الحدود تم الالتزام بها، على الرغم من عدد القتلى – ما يقدر بنحو 15 ألف فلسطيني في وقت كتابة هذا التقرير، بما في ذلك 6150 طفلاً على الأرجح. وكان الأميركيون مدعوين إلى الاستنتاج بأنه من المقبول أخلاقياً، مهما كانت مأساوياً، أن يموت الناس بشكل عرضي (أو كدروع بشرية) على أحد جانبي الصراع بأعداد تفوق عشرة أضعاف أولئك الذين ماتوا في هجمات إرهابية مباشرة على الجانب الآخر. ومن المثير للدهشة أن أحد المسؤولين الأميركيين اعترف علناً بأن السبب وراء الحديث الجديد عن الحدود الإنسانية في الحرب كان سبباً في إدارة العلاقات العامة في وقت لاحق: “إذا ساءت الأمور حقاً، فإننا نريد أن نكون قادرين على الإشارة إلى تصريحاتنا السابقة”.
سارت الأمور بشكل سيء بسرعة. اضطر بلينكن (جزئيًا بسبب ثورات الموظفين) إلى الاعتراف بأن موت المدنيين كان غير متناسب – على الرغم من أنه حتى الآن، لم يربط أي مسؤول أمريكي دعمه لإسرائيل علنًا بضبط النفس، مما قلل من مخاوفهم الأخلاقية بشأن الموت الذي مكنته المساعدات والأسلحة الأمريكية من رصد المخاوف الأمنية. ويبدو أن إسرائيل كان بوسعها أن تتجاهل ذلك بكل بساطة. بعد الإعلان عن وقف المذبحة لمدة 4 أيام ثم تمديده – ومع تبادل الرهائن – أشارت إدارة بايدن إلى رغبتها في رؤيتها ممتدة أكثر، دون التراجع عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، أو التشكيك في هدفها المتمثل في القضاء على حركة حماس.
إن افتقار أميركا إلى المصداقية باعتبارها منقذاً عالمياً للديمقراطية، أو وسيطاً نزيهاً ومحايداً في الصراع الطويل الأمد في إسرائيل وفلسطين، بزغ فجره على الجنوب العالمي قبل الآخرين.
وعلى الرغم من التصويت الساحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان العدوان الروسي في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة قادرة على توحيد شمال الأطلسي، ولكن ليس العالم، في تصويرها لقضية نقية. وفي خطاب رائع ومثير في شهر مايو الماضي، عرضت المسؤولة الأمريكية السابقة فيونا هيل، المشهورة بدفاعها عن السياسة المتشددة تجاه روسيا في سنوات ترامب، أن الجنوب العالمي لديه أسباب مفهومة لعدم شراء الضجيج المتعلق بالديمقراطية، وأعربت عن أسفها لأن دفاع أوكرانيا أثبت أنها رهينة التراجع الأمريكي وإرثها من المعايير المزدوجة. “إن تصورات الغطرسة والنفاق الأمريكي منتشرة على نطاق واسع”. وقالت: “ثقوا في النظام (الأنظمة) الدولي الذي ساعدت الولايات المتحدة في اختراعه وترأسته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية منذ فترة طويلة”.
والآن تسببت سياسة أميركا تجاه إسرائيل في تآكل الدعم لأوكرانيا، فضلاً عن آخر بقايا الإيمان بالفضيلة الجيوسياسية للزعامة الأميركية. ليست كل أسباب شكوك الجنوب العالمي بشأن المواقف المانوية الأمريكية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط مقنعة، لكن الجنوب العالمي يقف على أرض صلبة في التعامل مع كلام الغرب المتدين، في الماضي والحاضر، مثل العديد من المبررات التي تبرر العنف في العالم. الأقوياء ضد الضعفاء، وستار من الدخان لاستمرار التسلسل الهرمي العالمي. إذا كان شعار بايدن الجديد المتمثل في “نظام دولي قائم على القواعد” يعني سياسة أمريكا في غزة، فإن الجنوب العالمي “لن يستمع إلينا مرة أخرى أبدًا”، كما قال أحد المسؤولين بشكل لاذع.
التقى بايدن وشي جين بينغ في سان فرانسيسكو بعد شهر من بدء المرحلة الجديدة من الصراع في إسرائيل، لكن النتائج التافهة بالكاد تشير إلى أن الحرب الباردة الناشئة في الغرب ضد بكين قد تم تأجيلها أو تخفيفها. وفي الواقع، أعرب البعض عن قلقهم من أن حرباً أخرى ترعاها الولايات المتحدة -إسرائيل على رأس أوكرانيا- قد تتداخل مع الحملة ضد الصين التي يعتبرونها حملة وجودية حقيقية. تستطيع أميركا أن تتحمل تكاليف خوض العديد من الحروب في وقت واحد، هذا ما أكدته وزيرة الخزانة جانيت يلين لكل من يستمع. ولكن حتى لو كان هذا صحيحا، فإن مصداقية وشرعية العداوات الأميركية العالمية ليست مشتركة على نطاق واسع بالقدر الكافي لاستمرارها.
إن الجنوب العالمي لا يقتنع بالشعارات الإحيائية التي يطلقها صناع السياسات في منطقة بيلتواي (الطبقة السياسية الحاكمة في واشنطن)، وهم يهتفون حول الحرية. وبطبيعة الحال، فإنه من المألوف أن يتم تجاوزه وتجاهله. لكن الصراع في غزة يظهر أن المخاوف بشأن الإحسان الأميركي تضرب الأميركيين أنفسهم، وخاصة الشباب. وكان التحول في الرأي سبباً في إلقاء الشك على الزعامة الأميركية العالمية.
في ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدر الصحفي الليبرالي باكر، بياناً يحمل نذيراً بعنوان “نظرية جديدة للقوة الأمريكية”. واعترف بأن التدخل في مختلف أنحاء العالم قبل وبعد نهاية الحرب الباردة في عام 1989 يبدو الآن من الصعب الدفاع عنه، وأن الانسحاب الأفغاني الذي تولى بايدن نفسه منصبه لإكماله يعكس هذا الدرس. لكن أصر باكر على أن الرد على التدخل المفرط لا يتلخص في الإفراط في ضبط النفس.
وأوضح باكر أن هؤلاء “الذين يعيشون في أمان وراحة الغرب” لا يمكنهم إنكار أن “القيم الليبرالية… تعتمد على الدعم الأمريكي”. وبعد أفغانستان جاءت أوكرانيا، التي أكد أنها أنقذت ليبرالية السياسة الخارجية الأمريكية من فترة رهيبة من التقاعس عن العمل والانسحاب. وفي مواجهة أولئك الذين يشعرون بالقلق من أن “الأسلحة الأميركية لن تحقق أي شيء” في الصراع ضد روسيا، اقترح رؤية مصححة للقوة الأميركية: فهي قادرة على إنقاذ الديمقراطية في أوكرانيا، مفضلاً ممارسة إرسال الأموال والأسلحة بدلاً من القوات. لكن الدروس كانت قابلة للتعميم. وخلص باكر إلى القول: “أطلق عليها اسم عقيدة بايدن”. “إن الحدود من شأنها أن تجعل السياسة الخارجية القائمة على القيم الليبرالية أكثر إقناعا في الخارج وأكثر استدامة مع الناخبين الأمريكيين، مما يمنع التذبذب التالي نحو العظمة أو الكآبة”.
لكن التاريخ المعاصر – مع استمرار حرب أوكرانيا، وتدفق المزيد من الأموال والأسلحة للدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية أيضًا – لم يكن لطيفًا مع مثل هذه الرؤية. لاحظ باكر مؤخراً أن حرب أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود: فالأسلحة الأميركية لم تحقق شيئاً على أية حال، باستثناء إبقاء روسيا في مكانها. فهل تختلف النتائج في الشرق الأوسط عندما يتوقع نتنياهو معركة “طويلة وصعبة”، وعندما يحذر الإسرائيليون نظراؤهم المسؤولين الأميركيين من أن العمليات الحالية قد تستمر “ما قد يصل إلى عشر سنوات”؟
إن الضربة التي تتلقاها أي ثقة في أن نخب السياسة الخارجية الأميركية تعرف ما تفعله لا تخفف من وطأتها “نظرية جديدة” تقوم على التدخل الحذر وغير المباشر في الخارج، عندما تثبت تلك النخب أنها أكثر مهارة في رعاية الصراعات المستعصية بدلاً من حلها. إن التسرع في الحرب والتخطيط للنتائج الفوضوية في وقت لاحق هو أمر تعرفه أمريكا كثيراً، نظراً للفشل ليس فقط في تدخلاتها المباشرة، بل أيضاً في سجلها الفظيع في تجارة الأسلحة ودعم الوكلاء. ومن الممكن أن تتورط الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها حتى عندما لا ترسل قواتها. والحقيقة أن الصراع حول إسرائيل وفلسطين، والذي لا يوجد له سوى حل سياسي، ظل أبدياً منذ فترة طويلة.
ثم هناك مسألة الديمقراطية المعيبة في الولايات المتحدة، والتي لم تكن مثالية على الإطلاق، بل إنها تزداد سوءاً بشكل واضح، ويرجع ذلك جزئياً إلى حلم تعزيز الديمقراطية في أماكن أخرى من خلال قوة السلاح.
قال جورج بوش الأب في إعلانه عن نظام عالمي جديد في عام 1990: “إن قدرتنا على العمل بفعالية كقوة عظمى في الخارج تعتمد على الطريقة التي نتصرف بها في الداخل”. ومنذ ذلك الحين، لم يثبت التاريخ وجهة نظره فحسب، بل لقد أثبت العكس أيضاً: ذلك أن سلسلة من الأحداث إن الحروب غير المشروعة يمكن أن تقوض ما كان يعتبر ديمقراطية أمريكية وتتركها فريسة للمشعوذين، ليس مرة واحدة بل مرتين.
لم تتمكن أميركا هذه المرة من إيقاظ العالم حول سياستها وخطابها المحاصرين
ذلك أن العواقب الكبرى لحروب أميركا تتلخص في التدمير الذاتي لنظامها الليبرالي والقائم على القواعد في الداخل، كما كان الحال من قبل. من المفهوم أنه مع تصاعد المذبحة في الشرق الأوسط، أخاف طاقم حملة إعادة انتخاب بايدن لعام 2024 الخطوة الأولى والأكثر وضوحا. كان أحد الأسباب أخلاقيًا: “ركز الرئيس حملته لعام 2020 على “المعركة من أجل روح الأمة”، ولكن يبدو كما لو أن الإدارة تخوض حاليًا معركة من أجل روحها”، كما علق أحد موظفي الحملة حول العواقب الإنسانية للحرب التي تحرض عليها الولايات المتحدة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم أخلاق مختلفة أو لا أخلاقيات على الإطلاق، فإن القلق الاستراتيجي بشأن السياسة الانتخابية الكارثية هو الذي برز إلى الواجهة، حيث أصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل لعام 2024.
بدأت الطبقات الثرثارة بالتفكير في كيفية رد فعل مئات الآلاف من الناخبين المسلمين في ولاية ميشيغان المتأرجحة الحاسمة – وهي الولاية التي فاز بها بايدن بعدد أقل من الناخبين في عام 2020 (والتي فاز بها ترامب في عام 2016). وهتف أحد الأميركيين العرب: “لن أصوت لبايدن أبداً”. لكن المشكلة تتجاوز بكثير أي مجتمع محدد. وانخفض الدعم الأولي لإسرائيل، وأيد أكثر من ثلثي الأمريكيين وقف إطلاق النار. ورغم أن ترامب لم يكن من دعاة السلام، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين يتوقعون أن تكون رئاسته، إذا فاز في عام 2024، الخيار الأقل ميلا إلى الحرب. ويبدو أن سياسات بايدن تعيد الديمقراطية إلى الداخل ــ إذا نجت الولايات المتحدة حتى من ولاية ترامب الثانية ــ نتيجة لادعاء تعزيزها في الخارج من خلال الحرب.
وتجمع التحولات في الكونغرس، بين كل السمات المميزة للوضع الجديد الذي تعيشه أميركا في عالم مصغر. وإلى جانب المنتقدين الجدد لسياسة أمريكا تجاه إسرائيل من اليسار، يضم المجلس أيضًا يمينًا جديدًا يشكك في التوسع الإمبراطوري المفرط. وعلى عكس التصويت غير المتوازن الأول للكونغرس في عام 2022 لصالح تمويل أكبر لأوكرانيا مما طلبه بايدن في البداية، تردد رئيس مجلس النواب الجديد اليميني المتطرف، مايك جونسون. وأكد أحد الزملاء لنفسه بعصبية: “إنه ليس انعزالياً بأي حال من الأحوال”. واقترح جونسون تمويلًا جديدًا لإسرائيل بقيمة 16 مليار دولار، بالإضافة إلى المليارات المخصصة سنويًا، والتي تصل إلى أكثر من 120 مليار دولار منذ الأربعينيات. ولكن لأن جونسون رهن الأموال لرفع المظالم ضد تحصيل الضرائب، فقد رفضها مجلس الشيوخ. وحتى الآن يرفض طلبات الحصول على مزيد من التمويل للحرب المجمدة في أوكرانيا.
إن الحلم الأميركي المتمثل في تعزيز الديمقراطية من خلال قوة السلاح قد عفا عليه الزمن. لقد فشلت في الخارج في الممارسة العملية حتى عندما كان من الممكن الدفاع عنها أخلاقياً من الناحية النظرية، وليس من السهل أن تتحول إلى الوضع الفوضوي في إسرائيل وفلسطين. وهو أمر غير قابل للاستدامة محليا عندما تكون الديمقراطية في الولايات المتحدة على حافة الهاوية. وعلق ستيفن فيرثيم في صحيفة نيويورك تايمز بأن بايدن “لم يتعلم من أخطاء أمريكا، واندفع بتهور إلى الحرب الأخيرة”. بعد أوكرانيا، توفر غزة التأكيد الأخير لجيل من النزعة العسكرية الفاشلة، ولا تحثنا على الوعود القديمة بالأمن، بل إلى الحقائق الجديدة المتمثلة في تراجع الولايات المتحدة وسط حرب لا نهاية لها – والحاجة إلى تصور سياسة جديدة مراوغة يمكن أن تحل محل النظام العالمي العابر نحو الأفضل، لأن الأمور يمكن أن تسوء دائمًا.