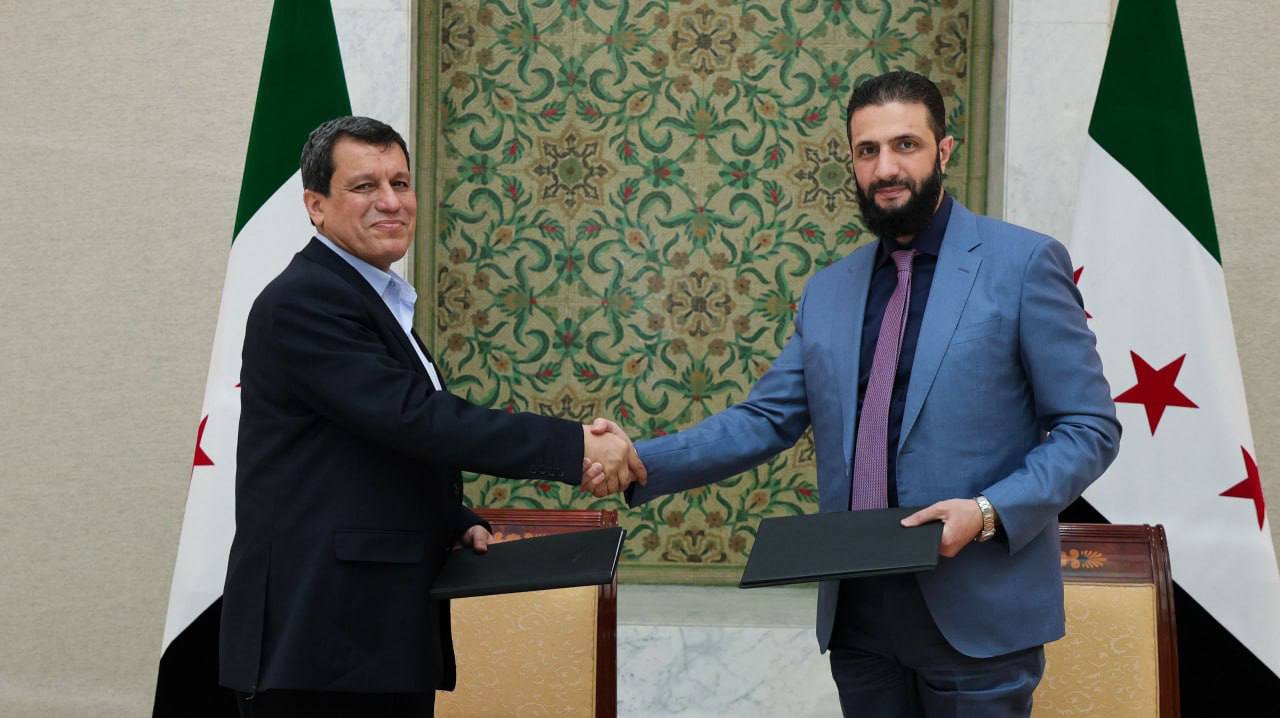محمد علي صايغ
أكتوبر 6, 2022
لم يكن أشد المتفائلين والمتشائمين يظن أن ثورة يمكن أن تحدث في دول ما سمي بالربيع العربي . كما لم يكن أحد يتوقع ان مسار الثورة السورية سيصل إلى ما وصل اليه من دمار وقتل ونزوح وتهجير … وأن يدخل هذا المسار في دوامة العنف والعنف المضاد وما تبعه من تدخل دولي ، واحتلالات ، ونفوذ دول ، ومليشيات متعددة الجنسيات ، وأجندات عملت على تأوير الصراع للتحكم بمآلاته.
ولم يكن أحد يتكهن أن الزمن سيطول الى هذا الحد وسيدخل عنصرا مهماً وفاعلاً في اتون هذا الصراع وفي نهاياته المؤلمة , ويغير من تركيبته واتجاهاته . إذ أن كل المؤشرات تدل على امتداده لسنوات وسنوات , لاستثمار امتداد الزمن في حرف بوصلته ، أو الدفع به الى احتراب أهلي لا يعرف مداه ومنتهاه , منذرا بمزيد من التشظي للمجتمع ، ومهددا النسيج الوطني السوري برمته . حتى بات الكثيرون يتساءلون بعد كل المتغيرات التي اجتاحت الثورة وتحولها الى أزمة معقدة ومستعصية ، عما اذا كان ما جرى فعلاً ثورة ؟ . ثورة للتغيير , أم مجرد سعيا لتغيير سلطة بسلطة مهما كان الثمن ؟؟ . وهل الثورة حقا تكون ثورة بدون ان تصنع تاريخاً جديداً للإنسان . نقيضا لسلطة تحكمت بالبلاد والعباد وأمعنت في الفساد والإفساد ؟؟. وهل ما جرى كان تحطيم للسلطة , أم تحطيم للدولة والمجتمع ؟؟ .
وإذا كانت الثورة تغيير جذري بعيد الأثر في الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي , وإنهاء استمرار الأحوال القائمة في المجتمع والدولة وإعادة بناءها وتنظيمها على قواعد جديدة . فإن السلطة مجموع الصلاحيات المخولة للمسؤولين في الدولة , والتي تعطي لهم القوة والقدرة على اتخاذ القرارات الملزمة للجميع . ويختلف مصدر هذه الصلاحيات التي قد تعود الى الامساك بالسلطة تبعاً للاستيلاء عليها بالقوة كالانقلابات مثلا , أو يكون مصدر شرعيتها عن طريق التداول عبر صناديق الاقتراع .
فالثورة تجاوز للنظام القانوني السائد في إطار التنظيم القانوني للدولة . وتسعى الثورة دائماً لفرض قانونها الجديد الذي قامت من أجله . ولكنها في المراحل الانتقالية حيث تفتقد الثورة للسلطة موضوعياً , فإن المسٱءلة القانونية للثورة لا يمكن عمليا إعمالها أو تطبيق مفاعيلها باعتبارها حق مشروع للشعوب . في حين أن السلطة أو بقاياها باعتبارها الحامي المفترض لسيادة القانون , فإن إنحرافها أو اهدارها للقانون يلزمها ويعرضها للمسائلة القانونية وفقا للقانون الوطني أو الدولي الخاص بجرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية ….
والثورة السلمية المطالبة بالإصلاح أو التغيير , دائماً ما تستند الى النظام القانوني القائم , وتكون مدخلاً لتعديله أو تغييره , وتكون حلاً موضوعيا لمشكلاته الناتجة عن إهدار للعدالة , وتحطيم لإرادات الناس . والثورة السلمية أيضا , مقاومة إيجابية للاستبداد والقهر , واتحاد للإرادات في مواجهة الظلم . إنها حالة انفجار للكتلة الشعبية في مواجهة السلطة الغاشمة بأدوات حضارية كالتظاهر والعصيان المدني .. وذلك لإعادة التوازن الى الفرد والمجتمع . فالقهر الجمعي المرتد للذات قبل الثورة يرتد بالحشد معها وبعدها . ويبدأ عاطفياً , ثم يتطور عبر أشكال متعددة من التنظيم في مواجهة عنف السلطة . وبمقدار ما تتجاوز السلطة حدود القانون بدون رادع , وبمقدار ما تمعن في استخدام القوة والقهر والقمع , فإنها تراكم ردود أفعال داخلية تنفجر بلحظة ما , وتسلك عشوائياً طريق العنف ضد السلطة . إذ أن عنف الثورة غالباً ما يكون رد فعل على عنف السلطة . ولكن عنف الثورة كثيراً ما يتم تغليفه بأيديولوجيات مغلقة أو استناداً لعقائد جهادية تدفع الى الإفناء الوجودي للسلطة , ثم تتحول الى إفناء وجودي لكل من يتصادم وجودياً معها . ولما كانت السلطة الدكتاتورية بالأصل لا تقبل إلا بالإفناء الوجودي لخصومها , فإن الثورة عندئذ ستدخل في حالة الفوضى التي كثيراً ما تدفع اليها السلطة وتحبذها وتعتبرها الملعب الذي تلعب عليه في تشتيت وضرب خصومها بعضهم ببعض . خاصة إذا كانت الثورة لا تستند الى حامل سياسي واجتماعي واع وفاعل يوجه مسارها .
وإذا كان عنف الثورة ليس شرطاً لازماً . فإن عنف الثورة أيضاً لا يأتي من فراغ . ففي المجتمعات المتخلفة وفي النظام العربي خاصة , تتجسد العلاقة بين الحاكم والسلطة وفق تفسير الدكتور فيصل الحذيقي بملمحين : ” الالتحام الأبدي مع السلطة , أو الانفكاك القسري عنها ” . الالتحام التأبيدي : بالموت أو الاغتيال الى توريث الأبناء . أو الانفكاك القسري عبر انقلاب سياسي أو تغيير استثنائي بالثورة
والعنف في ظل انسداد أفق التغيير الطبيعي السلمي يظنه البعض بأنه السبيل الوحيد لتجاوز عقد الخوف , واسترداد الذات وإعادة الاعتبار لها بعد سنوات من جلد الذات , والانتقام منها . وسنوات من الاستكانة والعجز والتبعية للسلطة ورموزها . إذ لا يبقى وفق هذا التوجه أية لغة في مواجهة عنف السلطة وجبروتها سوى لغة مقابلة ومماثلة لها في القوة والفعل . ومع غياب أي انفراج للحوار السياسي السلمي للتغيير في بنية السلطة والدولة , وفي النظام القانوني الذي يضفي المشروعية على تحكم السلطة بالدولة والمجتمع , ويكرس اختلال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فيها . فإن المقولة التي تنتشر بأن الشعب لن يكون أمامه في هذه الحالة الاستثنائية سوى واحد من خيارين : ” المجابهة بالعنف , أو التحول الى ضحية دائمة ونهائية ” .
ويرتبط العنف رمزياً بالموت . ولكن كثيرا ما يمنحه الانسان طابعا ايدولوجيا أو دينيا ليمنح الإنسان القوة في التغلب على خوف الموت . وبذات الوقت فإن تحدي الموت وقهره يحمل معنىً وهمياً مضخماً في الانتصار على الخوف والظلم وعدم الرضوخ لهما . ويوصف الدكتور مصطفى حجازي تحدي الموت بالعنف وانعكاسه النفسي المغلف بوهم الانتصار المبالغ فيه بقوله : ” من هنا تطفو الشعارات في مرحلة الانتفاض والتحدي , باستعذاب الموت والشهادة , وتمجيد العمل المسلح . ويتحول العنف الى عامل قوة للشعب , ويقيم صلحا بين الذات والجماعة ويرد اليهما اعتبارهما الذاتي . ومن خلال السلاح تنقلب الادوار ويتحول الضعف الى قوة , ويتخذ السلاح واستعراضه دلالة سحرية مبالغا فيها للانعتاق من الرضوخ , وتنحسر قيمة الإعداد والتنظيم لحساب القتال والبحث عن النتائج العاجلة والآنية والحلول السحرية , وإحلال العداوة والاضطهاد محل روابط المواطنة والمشاركة في المصير . ويتشرعن فعل القتل والقتل الجماعي بمشروعية الدفاع عن النفس , ويصبح واجبا للدفاع عن الذات وكرامتها أو الدفاع عن الجماعة وقيمها . وقد يقلب حامل السلاح – غير المزود بثقافة سياسية كافية – الأدوار في تعامله مع الجمهور أو مع من هم في إمرته , فيتصرف بذهنية الانتماء العشائري والقبلي , مما يدخل الثورة في خطر تحولها الى فورة , واختزال العمل الثوري في مجرد خوض معارك قتال ” .
وإذا كانت الأنظمة العربية الحاكمة وخاصة تلك التي تنخر في أوصالها الأزمات , لا يمكن لشعوبها أن تبقى تتعايش مع حالة السكون الأبدي . فإن انفجار الثورة يقلب حسابات السلطة وتوقعاتها . وفي هذا الإطار فإن الامتداد الزمني الطويل في التحكم بالسلطة والهيمنة على مؤسساتها يبقى عاملاً مهما في إيقاعها بحالة الاطمئنان والثقة بفعالية وقدرة إجراءاتها في ضبط حركة المجتمع برمته . وفي لحظة اصطدام السلطة بالثورة فإن السلطة إما أن تسقط بالصدمة بشكل دراماتيكي كما حصل في ثورة تونس ومصر , أو بفعل تدخل خارجي كثورة ليبيا واليمن , أو تعمل الانظمة على مقاومة الصدمة بإدارة الأزمة , كما حصل في الثورة السورية , وذلك بإدارة التجاذبات المحلية والعلاقات الدولية وشبكة التوازنات الجهوية والعرقية والمذهبية واللعب بها من أجل إطالة عمر الأزمة , ووسيلة لإدخال العوامل الإقليمية والدولية كعوامل مضافة تستخدمها في خلط اوراق الصراع وتعقيده . ونظراً لطبيعة بنية السلطة وتركيبتها التي لا تستطع الانفكاك عنها , فإنها تبقى محشورة في حدود إدارة الأزمة دون القدرة على مواجهة اسبابها وآثارها ونتائجها الحاصلة . ويزداد الأمر تعقيداً مع إطالة أمد الصراع والاقتتال والأزمات الناتجة عنهما . إذ أن أسلوب إدارة الأزمة لا ينهي الأزمة أبداً , وإنما يولد أزمات جديدة دائماً .
ومن الملفت في هذا السياق أن المعارضة السياسية بالرغم من أنها لم تكن فاعلة في صنع الثورة , ولا حاضنة لها في بداياتها , وقد دفعت بها ظروف الثورة إلى الواجهة لتمثيلها . إلا أنها وقعت في ذات المطب الذي وقعت فيه السلطة وتطابقت معها في أدائها المتمثل في قيادة الثورة بأسلوب إدارة الازمة مما جعل مواقفها تأخذ خطاً بيانياً متأرجحاً تبعاً لردود أفعالهاً , وضغوط القوى الإقليمية والدولية عليها . مما أدى ولا زال يؤدي إلى إحداث شرخاً عميقاً بينها وبين القوى الفاعلة على الأرض . وهي في انقسامها وتوهانها وتفجر الصراعات داخلها وفيما بينها , وفي غياب مشروع موحد لها , قد أجهضت وصول الثورة إلى نهاياتها المأمولة . إضافة إلى أن المعارضة السورية بكافة أطيافها وتكويناتها المدنية والعسكرية لا زالت تقدم نفسها على أنها مشروعاً مفترضاً لسلطة بديلة عن سلطة الدولة , لكنها بالرغم من مرور أكثر من عشرة اعوام على قيام الثورة وتبوؤها السلطة في مناطق واسعة ، لكنها – بتركيبتها وبنيانها – لم تكن تملك مؤهلات السلطة القادرة على إدارة الدولة . إذ أن إدارة أزمة الدولة من خارج سلطة الدولة تختلف ولا تتطابق أبدا مع إدارة السلطة لمؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة .
وقد أسهمت السلطة والمعارضة الخارجية معا في حرق مراحل الثورة , والدفع بها بعيدا عن حراكها السلمي الذي كان عرسا حقيقيا لكل قوى المجتمع وأطيافه . ولأن السلطة لا يمكن أن تتحمل استمرار سلمية الثورة وامتدادها , وهي الاقدر بما تملكه من قدرات في السلاح والتنظيم وإمكانات هائلة في التحكم بٱليات القمع , وآليات الصراع غير المتكافئ . فقد أدخلت الثورة في العسكرة وزجت بها في جحيم العنف والقتل . وفي المقابل فإن المعارضة أيضاً واستعجالاً منها في قطف ثمار الثورة فقد دفعت بها ومن ورائها أوهام التدخل الخارجي والتسليح والمناطق العازلة .. للوقوع في فخ السلطة . لتتحول الثورة الى حرب واحتراب . وعلى أرضية الاحتراب تتكاثر الأجندات , وفي بيئة الحرب تنمو الايديولوجيات الشمولية , والتكفيرية المتطرفة . فالعنف الشديد يقابله تطرف أشد . ولقد عرج الدكتور عبد الإله بلقزيز في احدى مقالاته على العلاقة بين العنف المسلح والنضال السلمي للتغيير بانه ” من غير الممكن لمعارضة مسلحة أن تكون معارضة ديمقراطية، أو حاملة لمشروع ديمقراطي، حتى وإن هي زعمت أنها ما حملت السلاح إلا لتحقيق ذلك المشروع الذي امتنع عليها من طريق النضال السلمي، وحتى لو هي ادعت أنها أُجبرت على حمله للدفاع عن نفسها و”عن الشعب” ضد العنف المسلح للنظام، ذلك أن بين العنف المسلح والديمقراطية بوناً لا يقبل التجسّر والرتْقَ، ولا يمكن اختراع القرابة بينهما باسم أي مبدأ، فهما متجافيان متنابذان لا يقوم الواحد منهما إلا على أنقاض الثاني، وهما لا يتساويان في الوجود وإن تكافآ في العدم “
وهكذا فإن العنف المطلق لا يقود إلا إلى سلطة مطلقة . والثورة التي تستبدل السلطة المطلقة , بسلطة مطلقة أخرى لا تكون ثورة . وعندما لا تقوى القوى الفاعلة في الثورة على ضبط إيقاع عملية التغيير والتحكم بمخرجاته , وصولا إلى إنجاز الدولة المدنية الديمقراطية والمجتمع المدني , دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية .. فإنها تقع في فوضى الثورة .
ولا بد من القول أخيراً , أن الثورة ليست غاية بذاتها وانما وسيلة للنهضة . فلا ثورة في ظل مجموعات تعيش حالة من التناحر والاقتتال , وتفضي الى الكوارث والمآسي , وتتحول من إسقاط النظام القائم الى إسقاط الدولة كنتيجة من نتائج الفوضى العسكرية والمجتمعية . ليجد المجتمع نفسه أمام قادة أو مجموعات لا يختلفون بتركيبتهم العقلية والسلوكية عن النظام القائم , ويقودون عملية استنساخ للسلطة من فوق أنقاض جثث الناس ودمائهم . فلا ثورة بلا نهضة , والثورة لا تكون حدثا استثنائيا بدون نهضة , ولا يمكن للثورة أن تنتج بشكل آلي أو أتوماتيكي النهضة , وإنما لا بد من فعل ثقافي ومعرفي أثناء الثورة وبعد تغيير النظام القائم الى نظام جديد , وإلا تحولت الى ثورة فاشلة , قد تصل الى استلام السلطة ولكنها تتحول الى فعل مضاد لأي نهضة حقيقية ترسم ملامح المستقبل .