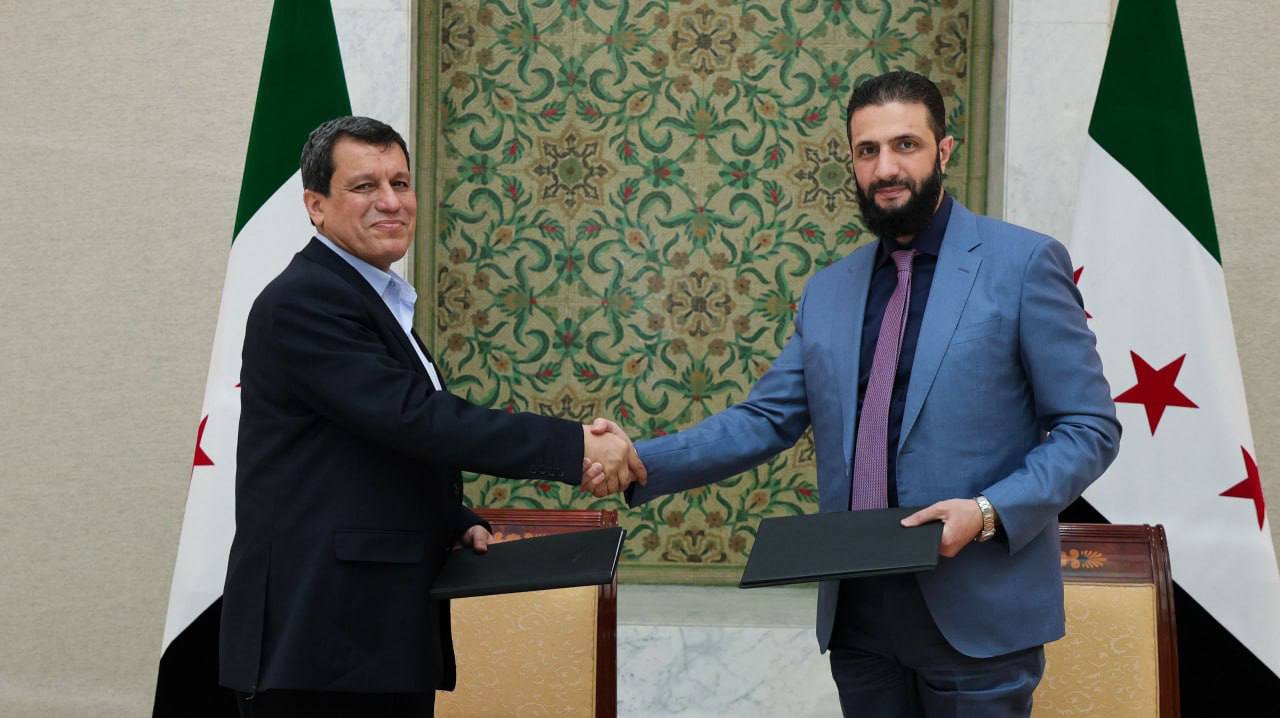عبد الله السناوي – الشروق
الأحد 23 أبريل 2023
لم يكن تقويض العملية السياسية في السودان بأثر مباشر للحرب المأساوية بين طرفي المكون العسكري خروجا عن سياق الإخفاقات التي لاحقت الثورات والانتفاضات العربية.
لماذا.. وكيف انكسرت في كل مرة الرهانات الكبرى التي تبدت في الشوارع الغاضبة؟
الظاهرة برسائلها ورهاناتها وإخفاقاتها تستحق التوقف عندها بالدرس والتعلم.
في موجتين متتاليتين الفارق بينهما ثماني سنوات نشأت ثورات وانتفاضات، اختلفت أسبابها ودواعيها وتقاربت أهدافها المعلنة طلبا لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. ورغم التضحيات الهائلة التي بذلت تعرضت جميعها للإجهاض.
الموجة الأولى، شملت تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا.
بدا النجاح ممكنا في الحالتين المصرية والتونسية، غير أنهما أجهضتا في بدايات الطريق، أو قرب منتصفه. واختطفت ثمار الثورة في مصر من جماعة «الإخوان المسلمين»، دخل البلد في صدامات وصراعات أفضت تداعياتها إلى إجهاض التجربة كلها.
في تونس استفادت حركة «النهضة»، التي تنتمي بدورها لتيار الإسلام السياسي، من الدرس المصري. حاولت في البداية تجنب منزلقاته، غير أنها عندما آلت إليها قيادة البرلمان مالت إلى الاستئثار بالسلطة وتغولت على صلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة الشأن الخارجي باسم «الدبلوماسية البرلمانية»، وكان الفشل ذريعا في إدارة الاقتصاد. كان ذلك داعيا إلى تقبل شعبي واسع لإطاحتها رغم ما أثير عن عدم دستورية الإجراءات. بالتداعيات والأخطاء الفادحة من الطرف الآخر أجهض ما أطلق عليه «الاستثناء التونسي»، وهو تعبير قصد به أنها التجربة الوحيدة الناجية!
في التجارب الثلاثة الأخرى تناقضت بضراوة الأحلام التي حلقت مع النتائج التي جثمت.
التجربة السورية تحولت إلى حرب إقليمية ودولية بالوكالة، أدخلت عبر الحدود التركية جماعات عنف وإرهاب، مزق البلد بمناطق نفوذ إقليمية ودولية وجرى عزله عن محيطه العربي لسنوات طويلة.
جاءت التجربة اليمنية على صورة مأساوية أخرى، جرى توظيف شعارات الديمقراطية لمصالح وحسابات أخرى لا علاقة لها بأية حداثة انتهت بحرب أهلية نالت من وحدة البلد وتماسكه.
وكانت التجربة الليبية مثالا صارخا على الدور المدمر الذي لعبه حلف «الناتو» بمساعدة إقليمية في إسقاط البلد كله باسم تصفية حسابات قديمة مع العقيد «معمر القذافي». وأدخلت ليبيا في حرب أهلية استهلكت طاقاته وثرواته.
رغم الإحباط الذي ضرب موجة الانتفاضات الأولى حول عام (2011) نشأت بعد ثماني سنوات موجة ثانية حول عام (2019) شملت السودان والجزائر ولبنان والعراق.
كان ذلك مؤشرا على استحكام أزمات الشرعية في أغلب النظم العربية وقوة طاقة الغضب التي تستعصى على أي إحباط.
بدت لفترة طويلة نسبيا التجربة السودانية الأكثر تماسكا والأعلى فرصا في النجاح. وأطاحت بحكم «عمر البشير» الذي امتد لثلاثين عاما مستندا على تحالف عسكري إخوانى. نشأت نخبة جديدة شابة وحديثة تحت عناوين «قوى الحرية والتغيير» و«تجمع المهنيين» و«لجان المقاومة».
كان أسوأ ما جرى بعد إطاحة «البشير» الإلحاح على تمديد المرحلة الانتقالية لأربع سنوات، لم يكن ذلك ضروريا لكنها أخطاء الحسابات، المثير أن أغلب مهام الانتقال عطلت، لا تشكلت هيئة تشريعية لوضع دستور جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية والرئاسية وجرت صدامات وارتكبت مذابح لم يتم التحقيق فيها.
أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية التي ترأسها الدكتور «عبدالله حمدوك» ودخل السودان إلى مرحلة سائلة ومنذرة، أحاديث مخاتلة عن نقل السلطة إلى المدنيين دون أن يكون ذلك مصدقا حتى انفجرت حرب مدمرة بين طرفي المكون العسكري، الجيش الوطني وقوات الدعم السريع يصعب الحديث بعدها عن استئناف العملية السياسية في أي مدى منظور.
الصورة تختلف في الجزائر، التي زامن حراكها ما جرى في السودان، كأنهما توأم في التوقيت.
لم تكن هناك مرحلة انتقالية جزائرية، ولا كانت هناك قيادة معروفة لما أطلق عليه «الحراك». حقق ذلك «الحراك» هدفه المباشر في منع ترشح الرئيس المريض «عبدالعزيز بوتفليقة» لولاية خامسة، دون أن يحقق اختراقا جوهريا في بنية نظام الحكم.
في الحراكين السوداني والجزائري تبدت قوة الرفض العام لانسداد القنوات السياسية والاجتماعية وتوحش الفساد وإهدار الموارد العامة وتأبيد الرئاسات في قصور الحكم دون أمل في تداول السلطة بين رجال وتيارات وبرامج.
الأوجاع الاقتصادية كانت الشرارة التي دعت السودانيين للاحتجاج في الشوارع غير أن عمق الأزمة أضفى على الاحتجاجات طابعها السياسي وأحالها إلى ثورة متكاملة الأركان تجاوزت إزاحة «عمر البشير»، إلى التطلع لبناء نظام ديمقراطي جديد على قاعدة السلم الأهلي جرى إجهاضها لاحقا.
بدت التجربة الجزائرية أقل دموية وأكثر سلمية، شعاراتها تطورت بعد إجبار «بوتفليقة» على مغادرة منصبه إلى بناء نظام جديد يغلق صفحة الماضي وحكم الجنرالات من خلف الستار ويحيل الفاسدين إلى المحاكمات دون أن تحقق اختراقا كبيرا فى طبيعة الحكم.
ملفات الفساد المتخمة كانت أحد الدوافع الرئيسية للحراكين العراقي واللبناني. فبدأت الاحتجاجات في الحراكين بدوافع اقتصادية واجتماعية، غير أن البيئة العامة المسممة بالمحصصات الطائفية دعت إلى تطوير الخطاب الاحتجاجي إلى دعوات تطالب بتفكيك النظام الطائفي وإزاحة النخب الفاسدة التي تتقاسم الثروات في محاصصات ويخضع قرارها لحسابات لا علاقة لها بمصالح اللبنانيين والعراقيين.
بتلخيص ما فإن العنوان الرئيسي المشترك للموجتين الأولى والثانية هو: التطلع إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
تصدرت شعارات الغضب في الموجة الأولى رفض التوريث والحكم العائلي، فيما تصدرت الثانية شعارات ترفض الطائفية والتمييز بين المواطنين على أساس المذهب، أو تهميش الأقليات العرقية، أو الحكم باسم الدين. وعلت نداءات دولة المواطنة فوق أي نداء آخر.
كان ذلك أفضل ما أسفر عنه الحراكان العراقي واللبناني اللذان افتقرا إلى أية قيادة معروفة تفاوض باسمهما لكنهما لم يحدثا اختراقا يعتد به في معادلات السياسة والمجتمع وظل القلق من المستقبل ماثلا دون إجابة.
لكل تجربة سياقها وتحدياتها، المراجعة بالتفاصيل ضرورية خشية الوقوع في فخ التعميم، غير أن ما هو مشترك يستدعى السؤال: لماذا لم تعش لنا انتفاضة عربية؟
أهم ما يجب التوقف عنده رغم أي إحباط في كل تجارب الحراك العربي تصدر الشباب المشهد العام وغلبت وسائل العصر الأساليب التقليدية في الحشد والتعبئة. و كأي فعل يمتد عميقا في حركة مجتمعه فإنه لا يمكن مصادرة تداعياته على أي مدى منظور وحضور الأجيال الجديدة في صدارة المشهد رسالة إلى أن المستقبل هنا مهما طال الوقت.