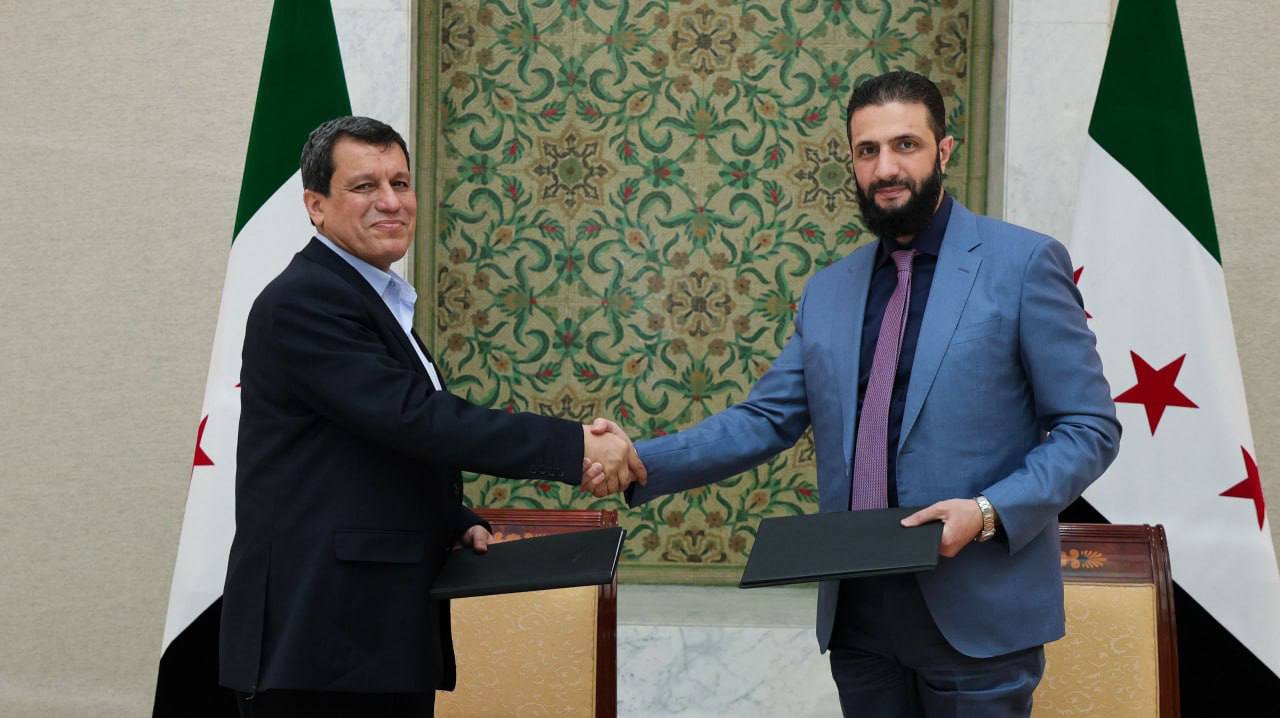عاطف أبو سيف
المصدر: العربي الجديد
الثلاثاء 29 – أكتوبر – 2024
لم أستطع أن أمنع نفسي من الكتابة عن مخيّم جباليا، حين رأيت الصور التي تكشف حجم الدمار الذي تعرّض له، وصور الترحيل القسري الذي يتعرّض له المواطنون هناك، بعدما صمدوا أكثر من عام في وجه حرب الإبادة البشعة. جباليا تُباد، والشمال يُمحى من الوجود بإفراغه من سكّانه وتدمير كلّ شيء فيه، وعدم ترك أيّ أثر للحياة التي كانت هناك. وتنفّذ خطة إفراغ شمال قطاع غزّة نموذجاً قد يمتدّ ليشمل إفراغ مدينة غزّة تدريجياً.
أنظر إلى تلك الصور القاسية كلّها التي تُنشَر من مخيّم جباليا، حيث ما زال جزء كبير من عائلتي، وأهلي وأصدقائي وجيراني. وكما نفعل عادةً ونحن نعيد تكوين الحنين حين ننظر إلى الصور الهاربة من الإبادة، نهرب من حاضرنا إلى عالم الذكريات الأليفة. لم يعد هناك مخيّم، ولم يعد هناك شمال، كما لن يكون هناك غزّة إذا استمرّ المجرم في تنفيذ مخطّطه أمام صمت العالم.
بالكاد أتعرّفُ إلى الشوارع، وبالكاد أستطيع أن أميّز الطرقات أو المباني؛ فالدمار جعل كلّ شيء “كومةً من أخيلة مهشّمة” بكلمات توماس ستيرنز إليوت. ولدتُ هناك وعشتُ حياتي كلّها، باستثناء السنوات التي أمضيتها في الدراسة الجامعية. صحيح أننا لا ننتمي إلى المخيّم بالمعنى الكامل، فانتماء اللاجئ يظلّ إلى المكان الذي هجّر أهله منه، لكنّنا بالمعنى الوطني الكامل ننتمي إلى المخيّم لما شكّله من ذاكرة نضالية وشهادة حيّة على فكرة اللجوء والتهجير القسري الذي تعرّض له أهلنا خلال النكبة. لذلك، يشعُر واحدنا بالزَهْو وهو يقول إنه من مخيّم جباليا، وهو زَهْو اكتسبه المخيّم ولم نكتسبه أفراداً، فهو من أغدقه علينا، وهو من كسانا بحُلّته.
لمخيّم جباليا فصل في كلّ ملحمة بطولة وصمود في مواجهة الاحتلال، منذ وجد المخيّم بعد النكبة فوق الكثبان الرملية في شمال بلدة جباليا التي حمل اسمها. في سوافي الرمل، بين جباليا وبيت لاهيا، وإلى الغرب من بيّارات البرتقال التي تحدّ بيت حانون، وقع نصيب المخيّم أن يحمل إرثاً عاصفاً من ذكريات الناس وأوجاعهم وتطلعاتهم إلى البلاد التي هُجّروا منها قسراً وظلماً. ولد أبي في المخيّم في أول سنتَين للنكبة، وكما ولد بلا بيت استشهد في المخيّم بلا بيت، بعدما قصفت الطائرات البيت وتركته يسكن مؤقتاً في بيوت العائلة الأخرى في المخيّم. هكذا هي ذاكرة المخيّم، ذاكرة المؤقّت.
لم يعد هناك مخيّم جباليا، ولم يعد هناك شمال، كما لن يكون هناك غزّة إذا استمرّ المجرم في تنفيذ مخطّطه أمام صمت العالم
نحن الذين ولدنا في مخيم جباليا وعشنا فيه نشعر بنوع من التميّز لهذا الدور التاريخي للمخيّم منذ النكبة، منذ التشكيلات الأولى للفدائيين التي عُرِفت بمجموعات مصطفى حافظ، التي كان جدّي لأمي، خليل، أحد أبطالها، ثم استشهد، وكان قد أصيب أيضاً خلال دفاعه عن يافا في إبريل/ نيسان عام النكبة. حتى جيش التحرير وقوات التحرير الشعبية ومجموعات فصائل الثورة، خاصّة حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعد ذلك بقيّة الفصائل، بما فيها الإسلامية مع اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى. كانت دائماً ثمّة حكاية لمخيّم جباليا يمكن أن يرويها. حكاية تليق بقوّة حضور اسمه في مدوّنة النضال التحرّري. نعم، فالنواة الصلبة للفعل الكفاحي تقريباً للتنظيمات كلّها كانت في مخيّم جباليا. شهدت طرقاته قتال غيفارا غزّة (محمد الأسود)، ورفيق السالمي، وتلك الحكايات القديمة من الزمن الذي كان فيه الفدائيون يحكمون غزّة في الليل، فلا يقدر الجيش الإسرائيلي على السير في طرقاتها. كما لم يقتصر الأمر على مقاتلي فصائل منظّمة التحرير، بل أيضاً يمكن القول إن أول تشكيل وقائد عسكري لـ”حماس” كان عماد عقل، الذي شكّل فعله النضالي نواةَ عمل جهاز “حماس” العسكري. وربّما ظلّ اسمه أحدَ أبرز ما يرد في ذاكرة الحركة عسكرياً. لذلك، فإن لجباليا قسطاً كبيراً في ذاكرة (كما في الفعل الكفاحي) التنظيمات الفلسطينية كلّها.
صدّقنا ياسر عرفات حين قال عنّا “مخيّم الثورة”، وكان مخيّمنا مخيّم الثورة فعلاً، كان ثوار قطاع غزّة كلّهم يجدون ملاذهم فيه، ويخوضون معاركهم الأشرس في طرقاته، حتى حين اندلعت الانتفاضة الأولى (1987)، وجدت في جباليا مهدها، وأتذكّر ذلك اليوم في الحارة حين استشهد رفيق الطفولة حاتم السيسي، وكان يكبُرني بعام، كان هذا في صبيحة التاسع من ديسمبر/ كانون الأول. كان عرفات يحرص على أن يأتي إلى مخيّم جباليا صباح كلّ عيد، يعايد والدة حاتم السيسي، شهيد الانتفاضة الأولى، ويسلّم على الناس. هكذا كان يبدأ صباح العيد عند عرفات من المخيّم الذي أطلق عليه اسم “مخيّم الثورة”، كما كانت جباليا أول مكان زاره عرفات بعدما وطأت قدماه أرض غزّة، وألقى خطبته الأولى من فوق شرفة المجلس التشريعي، بعدما وصل إلى مدرسة الفالوجا، حيث خاطب الناس قائلاً “يا أهل مخيّم الثورة”، بل ونزل مع الشباب إلى حلقة الدبكة. طبعاً عليكم أن تتذكّروا أن أحد حارات المخيّم هي حارّة الفالوجا حيث المدرسة الثانوية الأساسية في المخيم، وهو اسم ازدانت به من اسم قرية الفالوجا التي لجأ بعض سكّانها إلى المخيم عام 1948، وهي البلدة التي شكّلت صمود جمال عبد الناصر ورفاق دربه خلال النكبة. حين قسُّمت المدرسة بين مدرستَين نظراً لزيادة تعداد السكّان، أُطلِق على مدرسة البنات اسم شادية أبو غزالة، وهي أول شهيدة بعد 1967، وهي من نابلس، كذلك حيّ تلّ الزعتر. لكن الحال هكذا في جباليا، كلّ شيء له ذاكرة ثورية مرتبط بالتاريخ النضالي. كذلك ميدان الشهداء الستّة الذين اغتالهم الجيش قبل أيّام من خروجه من المخيّم بعد توقيع اتفاقية أوسلو (1993).
ثمّة ثأر قديم بين فكرة الثورة التي يشكّلها مخيّم جباليا في وجوده والجيش الذي أهين في كلّ مرة حاول فيها السيطرة على المخيّم
في سبعينيّات القرن الماضي، كان مخيم جباليا قلعةَ العمل المسلّح، الذي شكّل تتويجاً لصعود قوة فصائل العمل العسكري استمراراً لدوره في الخمسينيّات والستينيّات من خلال تشكيل مجموعات مصطفى حافظ، والكتيبة “141” التي كان قد أرّخ لها أحد قادتها يونس الكتري من مخيّم جباليا، ومن ثمّ جيش التحرير وقوات التحرير الشعبية. فتح آرييل شارون في السبعينيّات شوارعَ واسعةً في المخيّم بهدم البيوت حتى يسهّل للجيش المرور بدباباته وجيباته العسكرية آملاً في أن ينجح بقمع القوة المسلّحة فيه، لكنّه لم ينجح. وحين لم يفلح ذلك كلّه خرجت إسرائيل بخطّةٍ لتفريغ المخيّم، وبقية المخيّمات، من خلال المشاريع الإسكانية، التي يهدم معها المواطن بيته في المخيّم ويستلم قطعةَ أرض في “المشروع” لبناء بيت عليها. ومن هنا ظهرت الأحياء السكنية (المشاريع) المجاورة للمخيّمات، وكان مشروع بيت لاهيا أوّل المشاريع، ثمّ ظهر مشروع الأمل في خانيونس، وبالطبع حيّ الشيخ رضوان في مدينة غزّة. وأيضاً لم تفلح إسرائيل بمحو المخيّم، فالناس كانوا يهدمون بيوتهم ويستلمون قطعة أرض في المشروع، ثمّ يعودون إلى بناء البيت أو ضمّه إلى بيتٍ مجاورٍ للعائلة.. وهكذا، حتى بات مشروع بيت لاهيا مثلاً جزءاً متكاملاً مع المخيّم.
الآن، تستعيد دولة الاحتلال تلك الذاكرة الثأرية، وتمحو المخيّم بشكل كامل من الوجود. ثمّة ثأر قديم لم تخمد ناره بين فكرة الثورة التي يشكّلها المخيّم في وجوده والجيش الذي أهين في كلّ مرة كان يحاول فيها دخول المخيّم والسيطرة عليه منذ النكسة، ثأر يجد طريقه عبر المحو والإزالة. المخيّم ليس مكاناً ينتمي إليه الإنسان، لأن سمته الأساسية أنه مؤقّت، لكنّنا نشعر فعلاً بأنّنا من هذا المكان. صحيحٌ أنّنا نحافظ على تذكير أنفسنا بمدننا وقرانا الأصلية، ولا سيّما أن حارات المخيّم تنقسم إلى أسماء القرى والمدن التي هاجر منها من يسكنون فيها؛ فمنطقتنا فيها بلوك اليافاوية (يافا)، وبلوك الهوجا (هوج)، وبلوك السنايدة (دير سنيد)، وبلوك البرابرة (بربرة). ومناطق المخيم كلّها وفق هذا المنوال، لأن المخيّم يحمل خريطة البلاد؛ فحين نُحبّه فنحن نُحبّ هذه الخريطة، ونحفط هذه الذاكرة التي يسجّلها حتى في أدقّ تفاصيله.
مخيّم جباليا، الذي ظلّ طوال العقود السبعة ونيف الماضية شوكةً في حلق الاحتلال، سيظلّ كذلك، حتى لو هدموه بيتاً بيتاً. فالمخيّم ليس بيوتاً وليس شوارع، بل حكايات وذكريات ووعود بالعودة.