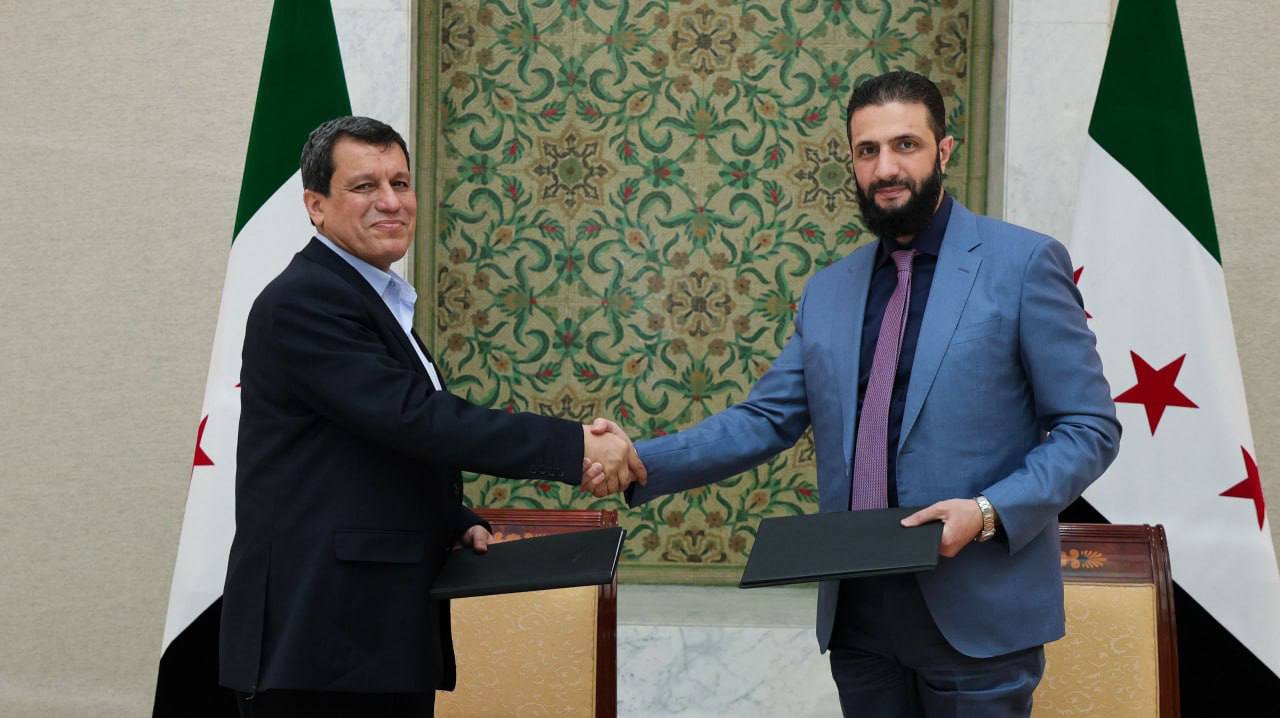السفير العربي – مواضيع
مقدمة
الذات في حالة شابٍ سُجن لسنوات عديدة، انقضى فيها شبابه وخرج من السجن كهلًا أشمط الرأس، لا لشيء سوى عمله الصحافي والبحثي والحقوقي، وارتباطه الوثيق اللصيق بثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011، لا يمكن أن تكون – فقط – ذاتاً فردية، بل هي ذات الشخص الفرد، وذاته الجمعية جيلياً ومهنياً ونشاطاً/نضالاً. وفي هذه الآفاق ما يستحق الكتابة والنشر وإثارة النقاش حوله.
2023-02-02
إسماعيل الإسكندراني
باحث في علم الاجتماع السياسي ــ من مصر
ضياء العزاوي – العراق
على الحد الفاصل بين عالمين: عالم “الداخل” وعالم “الخارج”، حيث كانت إحدى قدميّ قد وطئت أرض السجن والثانية لا تزال في أرض الله الواسعة، وكان جذعي على خط تماس السجن بمحيطه، جاءتني خاطرة تقول: لا تضيّع وقتك في صراعات وهمية وعداوات شخصية، واعتبر تجربة السجن، التي يُرجى أن تكون قصيرة، عملاً صحافياً ميدانياً ممزوجاً بالمخاطر، كما هي العادة، أو منحة تفرغ لدراسة اثنوجرافية أنثروبولوجية لمجتمع السجن. أقنعتني هذه الخاطرة، فاستجبت إليها، خصوصاً أن ظروف سجني لم تكن سيئة مقارنة بالسائد في مصر. وبهذه الروح بدأتُ رحلتي في “دولة الحديد”، لكن الرحلة طالت كثيراً عما توقعته في البداية أو رجوته، واتسع المجال لما هو أعمق وأوسع من دراسة الآخر.. إلى دراسة الذات ومراجعتها!
والذات في حالة شابٍ سُجن لسنوات عديدة، انقضى فيها شبابه وخرج من السجن كهلًا أشمط الرأس، لا لشيء سوى عمله الصحافي والبحثي والحقوقي، وارتباطه الوثيق اللصيق بثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011، لا يمكن أن تكون – فقط – ذاتاً فردية، بل هي ذات الشخص الفرد، وذاته الجمعية جيلياً ومهنياً ونشاطاً/نضالاً. وفي هذه الآفاق ما يستحق الكتابة والنشر وإثارة النقاش حوله.
على مدار الأشهر، التي بلغت من العدد 84 شهراً متصلاً، قضيتُ منها أكثر من 78 شهراً بين تشكيلة شديدة التنوع من السجناء الجنائيين، رأيتُ جوانب من المجتمع المصري، أو بالأدق “المجتمعات” بالجمع، لم أكن أراها في تجوالي وعملي الميداني الذي امتد من شبه جزيرة سيناء، بجميع مناطقها ومدنها ومراكزها، إلى إقليم قناة السويس بمحافظاته الثلاث، إلى وادي النيل من النوبة وأسوان، إلى دلتا المصب، إلى سواحل مصر على البحرين المتوسط والأحمر، ثم إلى الواحات في الصحراء الغربية.
كان تسكيني وسط الجنائيين فرصة للتعرف على مزيج إنساني من جميع المحافظات ومختلف البيئات الحضرية والريفية والبدوية، وخليط من الأعمار والخلفيات الاجتماعية، تعليماً ومهنةً وطبقةً، وهجين من السلوكيات الإجرامية شملت جميع أنواع الجرائم والإدانات (كجرائم النفْس مثل: القتل والتمثيل بالجثث والخطف وهتك العرض والسرقة بالإكراه، وجرائم المخدرات بمختلف أنواعها، سواءً التعاطي أم الاتجار، وجرائم الأموال العامة مثل: جرائم الآثار والتزوير والرشوة والاختلاس وتبديد الأمانات واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.. إلخ). ترتبت عليها جميع درجات العقوبة، من الإعدام المخفف إلى السجن المؤبد، ثم العقوبات الأقل حتى الحبس 6 أشهر، وهي أقصر فترة يمكن لمصلحة السجون أن تقبل فيها نزيلاً، إذ أنّ العقوبات الأقصر لا تُقضى في سجون المصلحة، وإنما في سجون تابعة لمديريات الأمن أو في أقسام الشرطة.
مقالات ذات صلة
هل أتاك حديث السجون السياسية؟
“الزنزانة المصرية” والتجارب الدولية في العفو عن السجناء
قد يلتقي الباحث أو الصحافي بأكثر من هذا التنوع على مدار حياته المهنية، لكنه سيقابل كل فئة من هؤلاء المتنوعين في سياق مختلف عن الآخر، أو في سياق يخدم فيه الريفي الفقير الأمي مخدومه ثري المدينة ذا الحظ الوفير من التعليم بعد الجامعي. لكن المختلِف في حالتي هو أن هؤلاء جميعاً قد أُغلق عليهم – وعليّ معهم – بابٌ واحد، وليس مع أي منا مفتاحه، ولا نملك خيار المغادرة أو تغيير الرفقة. ولاختلاف وضعي القانوني والأمني عنهم، وتباعد الاهتمامات بيني وبين أغلبيتهم، مررت بفترات طويلة من “العزلة وسط الزحام”، أو “الهدوء داخل الصخب”. وبدأتُ أرى موقعي/موقعنا من مجتمعات الشعب البالغ تعداده أكثر من 100 مليون نسمة على ضوء موقعي المؤقت بين هؤلاء “المواطنين” الذين نظن في حراكنا ذي الطموح الأخلاقي، أننا ما نبذل شيئاً إلا من أجلهم!
من هم السجناء الجنائيون؟
لم يعد اللصوص يرتدون ملابس مخططة بالأبيض والأسود، ولا أقنعة تحدد هوياتهم، كما صوّرت الأفلام القديمة وبعض قصص الكارتون. لا يسير تاجر المخدرات في الشارع بلافتة تعلن نشاطه، والقاتل الذي عوقب بالسجن ثم خرج، بعد فترة طالت أو قصرت، قد يجاورك في القطار أو الحافلة، وقد يزاملك في عمل أو نادٍ اجتماعي أو رياضي، من غير أن يكون مكتوباً على جبينه كلمة “قاتل”!
لذلك، فأي شخص يسير في شوارع مصر ويركب مواصلاتها ويرتاد مقاهيها ومحلاتها، هو سجين محتمل، حتى لو لم يتكلم بطريقة “اللمبي” (محمد سعد) أو أي من الشخصيات العنيفة التي مثّلها محمد رمضان، وحتى لو لم يكن في وجهه ندوب أو في رأسه جروح قطعية قديمة كصورة نمطية للبلطجي/الشبّيح. ربما يكون أياً ممن تراهم في الشارع قد مر بالتجربة، أو ربما سيمرّ بها قريباً، لسبب منطقي أو لسبب عبثي أو لغير سبب أصلاً.. فأنتَ في مصر! ولا تختلف الاحتمالات بين السجن السياسي والسجن الجنائي في ذلك، فالسجون زاخرة بالعبث الجنائي بما لا يقل إثارة وتشويقاً عن العبث السياسي. ولذلك، فإني أجادل بأن الخليط الذي عايشته من المولودين والمقيمين في أشهر الأحياء السكنية الموصوفة بـ “الراقية”، جنباً إلى جنب مع المولودين والمقيمين في أعماق الريف وهوامش الحضر، ومعهما الأغلبية من المتوسطين، هم عينة ممثِّلة – أكثر من غيرها – عن تنوع المجتمع/المجتمعات المصرية، خصوصاً مع كثرة أعداد من عايشتهم على مدار السنوات، وكثرة اختلافاتهم الطبقية والسلوكية، وتباين آرائهم وتفضيلاتهم السياسية.
على مدار الأشهر التي بلغت من العدد 84 شهراً متصلاً قضيت منها أكثر من 78 شهراً بين تشكيلة شديدة التنوع من السجناء الجنائيين، رأيت جوانب من المجتمع المصري، أو بالأدق “المجتمعات” بالجمع، لم أكن أراها في تجوالي وعملي الميداني
في هذا السياق، رأيتُ السجناء الجنائيين – أي غير السياسيين – هم المصريين، وذلك بمعنيين: بمعنى أن سجن القضبان والجدران هو السجن الصغير مقارنة بالسجن الكبير، الذي قد يكون مصر المغلقة على من فيها ممن يحاولون الهرب ولا يستطيعون، أو حتى السجن الأكبر، وهو كوكب الأرض الذي لا تستطيع البشرية الفكاك من أسره (حتى الآن!). وسواءً كان السجن الأكبر أمنياً وسياسياً، فالسجناء هم المصريون، أم كان فلسفياً وبيئياً، فالجنائيون في سجون مصر هم نموذج مصغّر من البشر ذوي الخصوصية المصرية. والمعنى الثاني أن نسبتي العددية كسجين سياسي وحيد يسكن مع عشرات من الجنائيين ذكّرتني بنسبة الثوار أو النشطاء أو المهتمين بالشأن العام، التي هي أقل بكثير، لكن الرابط بين النسبتين هو أنهما لا يتجاوزان 1 في المئة بأي حال من الأحوال.
مقالات ذات صلة
سوسيولوجيا الاشتباه
سجن “بدر”.. النسخة الأسوأ من سجن “العقرب” في مصر
ومع تشعب الحوارات والنقاشات في بيئة مغلقة عاطلة عن العمل والإنتاج ولا يملك أحياؤها سوى الكلام، رأيت أصحاب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من غير المشاهير مجسَّدين أمامي، أشخاصاً حقيقيين من لحم ودم. ولم يختلف ما يخرج من أفواههم، في تنوعه وتناقضه، وهرائه أحياناً، عما اعتاده الناس في مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية. الفرق الوحيد هو أن أصحاب التعليقات أمامي وجهاً لوجه، قد يقول أحدهم شيئاً بالعربية المهجّنة باللغة الأجنبية فيرد عليه الآخر بلكنة ريفية صعيدية ثقيلة مشّبعة بمصطلحات السجون ولغتها الخاصة، وهي فرصة لم توفرها بعد وسائل التواصل الاجتماعي، فليس في السجن “حظر” على الكلام يمارسه فرد على فرد مثله، إلا استثناءً.
مراجعات اجتماعية سياسية
في هذه الأجواء، ومع توفر فرصة القراءة المقيَّدة التي استثمرتها في قراءة كل ما أمكن دخوله إليّ أو حصولي عليه، كان لي وقفة مع كتاب “التعددية الثقافية” لمؤلفه المفكِّر تشارلز تايلور، حيث تأملت في تفرقته بين سيادة قيمة الشرف الاجتماعي أو قيمة الكرامة الإنسانية. بالطبع، استقى تايلور مثاله التوضيحي من الثقافة الأوروبية، لكن أبطأ العرب فهماً لن يستغرق كثيراً من الوقت كي يُدرك مدى تشابه هذه الأزمة مع أحوال مجتمعاتنا العائلية/العشائرية/القبلية.
نادينا في ثورة يناير بالعدالة الاجتماعية، تلك التي قد نختلف كثيراً في فهمها وتأويلها وتحويلها إلى خطط تنفيذية وسياسات. كما نادينا بمطلب آخر لم يشتهر شهرة “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية”، ألا وهو الكرامة الإنسانية. وكان سياق الثورة، التي اختير ليوم انطلاقها كمظاهرات احتجاجية يوم عيد الشرطة الموافق 25 كانون الثاني/يناير، ما يعني أن الكرامة المقصودة كانت كرامة الإنسان في أماكن الاحتجاز والتحقيقات، أي ضمان حق المواطن في كرامته الجسدية والنفسية وحمايته من التعذيب. لكن المدلولات الأخرى للكرامة، بما يعني أنها نقيض للشرف كقيمة اجتماعية حاكِمة ومهيمنة، لم ترد في أذهاننا، وهو التباس يستحق البيان..
حين يسود معيار الشرف مجتمعاً ما، فإن وراثة المكانة الاجتماعية – شريفة كانت أم وضيعة – يصير أصلاً معمولاً به وعرفاً لا يخرج عنه إلا منبوذ. والإشكالية في وراثة الشرف أو الضِعة لا تنحصر في وجود “أنساب شريفة” و”أصول عريقة” ذات أفضلية اجتماعية وربما دينية صوفية، على غيرها، ولا تقتصر على الحصانة المبدئية غير المستحَقة التي يتمتع بها جميع أفراد هذا النسل أو ذاك، ولا تقف عند حدود الشعور بالدونية عند غيرهم إذا فُتح باب الفخر والمديح، وإنما الكارثة الكبرى تكمن في موطنين آخرين. أولاً: غياب تكافؤ الفرص في الصعود الاجتماعي، ولو بالمصاهرة، ثانياً: الحرص الشديد على توريث الوظائف والمهن التي اشتهرت بها هذه العائلة أو تلك.
إذاً، فمشروع توريث الحكم من حسني مبارك إلى نجله جمال لم يكن غريباً على المجتمع المصري أو الثقافة العربية والأفريقية. فمصر بلد يورِّث القضاة فيه مناصبهم لأبنائهم، كما يفعل الضباط، والدبلوماسيون، وأساتذة الجامعات، وغيرهم. وجوهر المشكلة ليس كما يقال – كذباً – ضمان مستقبل الأولاد في مجال يعرفه الآباء، وإنما الحرص على توريث الشرف والمكانة الاجتماعية بما يُبْقي كل شيء على حاله، ويغلق أبواب الطموح لدى الأفراد من الدوائر الاجتماعية الأخرى (أي الأنساب الأدنى!)
نادينا في “ثورة يناير” بالعدالة الاجتماعية، كما نادينا بمطلب آخر لم يشتهر كثيراً وهو الكرامة الإنسانية. وكان سياق الثورة التي اختير ليوم انطلاقها، كمظاهرات احتجاجية، يوم عيد الشرطة، يعني أن الكرامة المقصودة كانت كرامة الإنسان في أماكن الاحتجاز والتحقيقات… لكن المدلولات الأخرى للكرامة، بما هي نقيض للشرف كقيمة اجتماعية حاكِمة ومهيمنة، لم ترد في أذهاننا، وهو التباس يستحق البيان..
بدأتُ في السجن أكتشف بعض المداخل المفتاحية، ومنها المفتاح الرئيسي، وهو إعادة تعريف الشرطة المصرية لتكون “البيروقراطية الريفية المسلحة”. ومنها كذلك أن الورم الأكبر والأخطر في جسد الشرطة المريض ليسوا الضباط، بل الأفراد. وقد فهمت، أو أزعم أنني فهمت، لماذا يشعر ضباط الشرطة بالتفوق الاجتماعي على أغلب مكونات المجتمع المصري، وما هي أسبابهم الواعية أو غير الواعية في ذلك.
فأي ديمقراطية يمكن أن تفيد مجتمعاً كهذا؟ هل هي الديمقراطية التمثيلية، التي يحشد فيها ذوو الأنساب العريقة قبائلهم ومنتفعيهم والمحْتمين بهم ليضمنوا مقعداً برلمانياً يتفاخر به أبناؤهم وأحفادهم؟ أم الديمقراطية الشكلية التي ترسِّخ توارث الشرف والمكانة بتشريعات وسياسات وضعها ونفّذها ويراقبها من أنتجتهم آليات وراثة الشرف والمكانة ذاتها؟!
وأي نضال أولى بنا، نضالٌ من أجل كنس سلم السلطة من أعلى الى أسفل؟ أم النضال من أجل بناء سلم جديد، على أساس مختلف، من أسفل إلى أعلى؟ وهل المجتمع الذي تسوده قيمة الشرف وتوارثه يقبل بزرع الديمقراطية فيه؟ أم أن مناعة هذا الجسد سترفض أنسجة الديمقراطية وتقاومها وتلفظها كما يلفظ الجسد البشري عضواً بشرياً متبرَعاً به من إنسان له فصيلة دم مختلفة أو أنسجة غير متوافقة مع الجسد المريض؟
الفارق بين المثالين هو أن الفرد المريض لا يمكننا تغيير فصيلة دمه ولا أنسجة جسده، ولا يصح ذلك أخلاقياً، أما المجتمعات المريضة فإننا نرفض تغييرها من الخارج باستعلاء استعماري لم يكن أبداً حسنَ النية، لكننا يمكننا أن نغيرها من الداخل بدأب ووضوح رؤية وطول صبر، بل يجب علينا ذلك!
ربما يكون أياً ممن تراهم في الشارع قد مر بالتجربة، أو ربما سيمرّ بها قريباً، لسبب منطقي أو لسبب عبثي أو لغير سبب أصلاً.. فأنتَ في مصر! ولا تختلف الاحتمالات بين السجن السياسي والسجن الجنائي في ذلك، فالسجون زاخرة بالعبث الجنائي، بما لا يقل إثارة وتشويقاً عن العبث السياسي
أحد أهم أركان مراجعاتي وتأملاتي كانت المراجعات الأمنية. فهذا الجهاز الشُّرطي الذي يختلف واقع ممارساته اختلافاً ظاهراً وعميقاً عن النصوص الدستورية المؤسِّسة لشرعية وجوده، والنصوص القانونية المنظِّمة لعمله، ظل بالنسبة إلينا لغزاً مزعجاً مؤذياً. فلا نحن نعرفه جيداً ولا نفهم تكوينه وطريقة عمله، ولا ضباطه يفهموننا أو يعرفون أفكارنا ومشاعرنا.
وفي هذا المضمار، كانت لي مراجعات أخرى مع قضية الخيال السياسي، إذْ دائماً ما انشغلنا بالخيال السياسي عند الفاعلين المنظّمين من أحزاب وجماعات وحركات، أو حتى نقابات واتحادات مهنية وطلابية، لكننا لم نسائل أنفسنا عن الخيال السياسي للمجتمع! ما هي صورة الناس، عموم الناس، عن الحاكم الجيد؟ هل هو الرجل القوي؟ أم الإنسان العادل ولو لم يكن رجلاً؟ كيف يرى الناس، عموم الناس، البرلمان والمجالس المحلية؟ والحكومة والإدارة المحلية؟ وأيهما أهم في “ثورة شعبية”: خيال الثوار المشوّش؟ أم خيال من يزعم الثوار أنهم ثاروا من أجلهم، وهو الأكثر تشويشاً؟!
والمجتمع، الذي عرفت في السجن كم تسوده ثقافة “الركوب المجاني” – وهو مصطلح سوسيولوجي يُقصد به وصف أنصار الحركات الاجتماعية من غير أعضائها، حيث ينتفعون من حراك الأعضاء من دون مخاطرة ولا أعباء – هل هو مجتمع جدير بما طمحت إليه شعارات ثورة يناير؟ أليس هو المجتمع نفسه الذي أفرز عدداً مهولاً من “المواطنين الشرفاء” محترفي الوشاية المرحِّبين بسلطة الوصاية؟
مقالات ذات صلة
هل مات اليسار بينما ما زال لبه يُحرِّك الناس؟
السجون المصرية تعمّق جراح الفقراء
وإذا كنا نرفض فذلكة مدّعي الثقافة الذين طالب أحدهم بأن يكون للمتعلم ضعف الحق التصويتي للمواطن الأمّي، وإذا كنا منحازين – ثورياً – للضعفاء والفقراء والمهمشين بغرض رد حقوقهم، ثم تمكينهم من فرص عادلة متكافئة مع غيرهم من المواطنين، فهل بعد ما عايشته لأكثر من 70 شهراً في السجن أغالط نفسي وأزعم أنه ما من رابط بين “الجهل” التعليمي والمعرفي و”الجهالة” السلوكية؟ هل سأكابر، بغرض النكاية الفكرية في الليبراليين ومكايدة ذوي الانحيازات الطبقية الوسطى والعليا، وأقول إن الأميين وقليلي الحظ من التعليم أفضل من غيرهم من حمَلة الدرجات العلمية العليا ممن ساءت اختياراتهم وضلّت السبيل؟ ألم تقم مثل هذه الخطابات بدور شبه تخديري تجاه أزمَتَي الجهل والجهالة؟ فمن كان وقود الثورة المضادة – إذاً – من الذين فتكوا بنا ميدانياً؟ أليسوا هم الأميّين الجَهُولين من المدنيين والمجندين سواءً بسواء؟!
مشروع توريث الحكم من حسني مبارك إلى نجله لم يكن غريباً على المجتمع المصري أو الثقافة العربية والأفريقية. فمصر بلد يورِّث القضاة فيه مناصبهم لأبنائهم، كما يفعل الضباط والدبلوماسيون وأساتذة الجامعات… وجوهر المشكلة الحرص على توريث الشرف والمكانة الاجتماعية بما يُبْقي كل شيء على حاله، ويُغلق أبواب الطموح لدى الأفراد من الدوائر الاجتماعية الأخرى (أي الأنساب الأدنى!)
وأخيراً، رأيت في السجن، مع الجنائيين، أي عبث راديكالي كان يهرف به بعض رفاقنا الثوار الذين كانوا يمجّدون مواجهات “الشباب العاديين” مع قوات السلطة تمجيداً مطلقاً. وكانوا – لمزيد من العبث – حين يفتخرون بأن بعض هؤلاء المتثوَّرين من “العاديين” لم يكونوا يخوضون “المعارك الثورية” إلا تحت مفعول المخدرات (تحديداً عقار “الترامادول”). كانوا يزعمون أن ذلك يعني تغلغل الفعل الثوري في قطاعات أوسع من غير المسيّسين. ولم يكونوا يفتحون باب الاحتمال لِما تيقنتُ به في السجن، بأن الأغلبية العظمى من الذين رآهم الثوار “عاديين”، بمعنى غير مسيّسين قبل الثورة وبدأوا السياسة من التثوير، هم في الحقيقة “نشطاء” جداً في المجال الجنائي، بل قياديون في مجالهم! ومصلحتهم المباشرة، كما صرّح لي بعضهم، في خلخلة أجهزة الدولة الأمنية وسحقها ميدانياً، ليست مصلحة من أجل الحقوق والحريات، وإنما مصلحة لــ “حقهم” هم في تجارة المخدرات، و”حريتهم” في البلطجة واستعراض قوتهم. فأي حليف اجتماعي ينشده الثوار الراديكاليون؟!
مراجعات حقوقية وأمنية
شهِدتُ أيضاً كواليس إخراج مسرحيات الزيارات الحقوقية والإعلامية لبعض السجون، واختيار بعض السجناء الجنائيين، ممن زاملوني في الغرفة ذاتها، للتمثيل في تلك المسرحيات الهزلية السخيفة. الأمر الجاد الوحيد في هذه الزيارات هو التوتر والارتباك الذي يرافقها، وبعض التضييقات التي تقررها إدارة السجن تحت وطأة “المرور” و”التفتيش” و”المتابعة”.. حتى صرخ أحد السجناء ذات مرة: “هم بتوع حقوق الإنسان عايزين مننا إيه؟!”.
تدريجياً بدأت أطّلع على صورة الحقوقيين عند الجنائيين، الذين هم – كما سبق أن اعتبرتهم – عينة ممثِلة أكثر من غيرها للمصريين، وكيف ينظرون إليهم (إلينا) نظرة نفعية توظيفية تماماً، تحتوي على قدر كبير من عدم الفهم، الذي نُسأل عنه نحن لا هم. فــ”حقوق الإنسان” بالنسبة إليهم ليست “حقوقهم”، وليست مفاهيم ولا قوانين قائمة أو مأمولة، وإنما هي كيان وهمي يختلط فيه “المجلس القومي لحقوق الإنسان” التابع للدولة مع المنظمات المدنية غير الحكومية، ويمتزج معهما قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. هي شيءٌ ما يقول كلاماً منمّقاً للاستهلاك الإعلامي ولا يمثل لهم سوى عبئاً وصداعاً. لكنهم في الوقت ذاته، يرون في تلك الكائنات الحقوقية فرصة لاستثمارها، طبقاً لنظرية المناديل الورقية ذات الاستعمال الواحد، إذا كان لأحدهم مصلحة وأراد أن يستفيد من الضغط الحقوقي، أو حتى يجرّبه.
بعضهم يجعل من جسده مخزناً للمخدرات والممنوعات في السجن، مثل الهواتف المحمولة وشواحنها، فيستعملون فتحتي الإطعام والإخراج في “البلع” و”الرفع”، ويتنافسون فيما بينهم أيهم يمكنه رفع عدد أكبر من الهواتف وشواحنها. وكثير منهم يجرحون أجسادهم جروحاً قطعية تعبيراً عن الحزن أو الاحتجاج. فأي حرمة جسد يفهمونها حين يسمعون الحقوقيين يتحدثون عن جريمة التعذيب، التي لا تزيد عند كثير منهم عن نوع من “التأديب”، أو ربما اللعبة بينهم وبين الضباط وأفراد الشرطة؟
فهل نحن وكلاء عن ضحايا الانتهاكات حين يطالبون بحقوقهم، أم بدلاء عنهم فنطالب من أجلهم بما لا يرون مشكلة في افتقاده أو الحرمان منه أو انتهاكه؟
ويرتبط ذلك بسؤال آخر ومراجعة أخرى: هل يسعى الحقوقيون حقاً إلى التغيير أم أنهم يسجلون مواقفهم من أجل راحة الضمير؟ وهل يدرك الوسط الحقوقي، المأزوم من داخله، الفارق بين الاتجاهين المختلفين في استراتيجياتهما وتكتيكاتهما كل الاختلاف؟ وإذا كان الحقوقيون يناضلون من أجل حقوقهم هم، لا حقوق الأجيال المقبلة، لماذا لا يوفرون أعمارهم ويسعون إلى الهجرة إلى بلدان أكثر رعاية للحقوق وحماية للحريات؟ ألا نعلم علم اليقين أن التغيير في مجتمعاتنا العربية سيستغرق أجيالاً عدة حتى يتمتع أحفادنا بما نادينا به وناضلنا من أجله؟ فإذا قررنا البقاء واستكمال معاركنا، ولو بآليات مختلفة، ألا يعني ذلك – ضمناً – استعداداً للتضحية ببعض حقوقنا التي كنا سنتمتع بها كاملة في بلدان المهجر المحتمل؟
كانت لي مراجعات أخرى مع قضية الخيال السياسي، إذْ دائماً ما انشغلنا بالخيال السياسي عند الفاعلين المنظّمين لكننا لم نسائل أنفسنا عن الخيال السياسي للمجتمع! ما هي صورة الناس، عموم الناس، عن الحاكم الجيد؟ هل هو الرجل القوي؟ أم الإنسان العادل ولو لم يكن رجلاً؟ كيف يرى الناس، عموم الناس، البرلمان والمجالس المحلية والحكومة والإدارة؟
كثير من السجناء يجرحون أجسادهم تعبيراً عن الحزن أو الاحتجاج. فأي حرمة جسد يفهمونها حين يسمعون الحقوقيين يتحدثون عن جريمة التعذيب التي لا تزيد عندهم عن “التأديب”، أو ربما عن اللعبة بينهم وبين الضباط؟ وهل نحن وكلاء عن ضحايا الانتهاكات حين يطالبون بحقوقهم، أم بدلاء عنهم فنطالب من أجلهم بما لا يرون مشكلة في افتقاده أو الحرمان منه أو انتهاكه؟
وإضافة إلى المراجعات الحقوقية، التي لم تنتهِ عند هذا الحد، فإن أحد أهم أركان مراجعاتي وتأملاتي كانت المراجعات الأمنية. فهذا الجهاز الشُّرطي الذي يختلف واقع ممارساته عن النصوص الدستورية المؤسِّسة لشرعية وجوده والنصوص القانونية المنظِّمة لعمله اختلافاً ظاهراً وعميقاً، ظل بالنسبة إلينا لغزاً مزعجاً مؤذياً. فلا نحن نعرفه جيداً ولا نفهم تكوينه وطريقة عمله، ولا ضباطه يفهموننا أو يعرفون أفكارنا ومشاعرنا.
مقالات ذات صلة
شهادتي عن “تمرد” ورابعة: الفواتير المؤجلة
وقد أتاح لي طول الاندماج مع الجنائيين في سجن قليل الكثافة العددية أن أتعامل وأراقب ضباط الشرطة وأفرادها من زاوية لا تتاح لكثير من الزملاء، ولم تتح لي من قبل. وبدأت أكتشف بعض المداخل المفتاحية لحل هذا اللغز، منها المفتاح الرئيسي: وهو إعادة تعريف الشرطة المصرية لتكون “البيروقراطية الريفية المسلحة”. ومنها كذلك أن الورم الأكبر والأخطر في جسد الشرطة المريض ليسوا الضباط، بل الأفراد. وقد فهمت، أو أزعم أني فهمت، لماذا يشعر ضباط الشرطة بالتفوق الاجتماعي على أغلب مكونات المجتمع المصري، وما هي أسبابهم، الواعية أو غير الواعية، في ذلك. أما نظرتهم لما نسميه حقوقياً وقانونياً بجريمة التعذيب، خصوصاً مع التوسع في مشتملاتها، فهو لا يزيد عندهم عن “مبالغة” في عقاب أبوي “كلنا اتربينا عليه”!
وهو ما يحتّم علينا الاعتراف بضرورة فتح آفاق جديدة لفهم هذا الكيان وتفسير مشكلاته، مع الإيمان بأن إصلاح الشرطة جزءٌ من كل وفرعٌ من أصل.