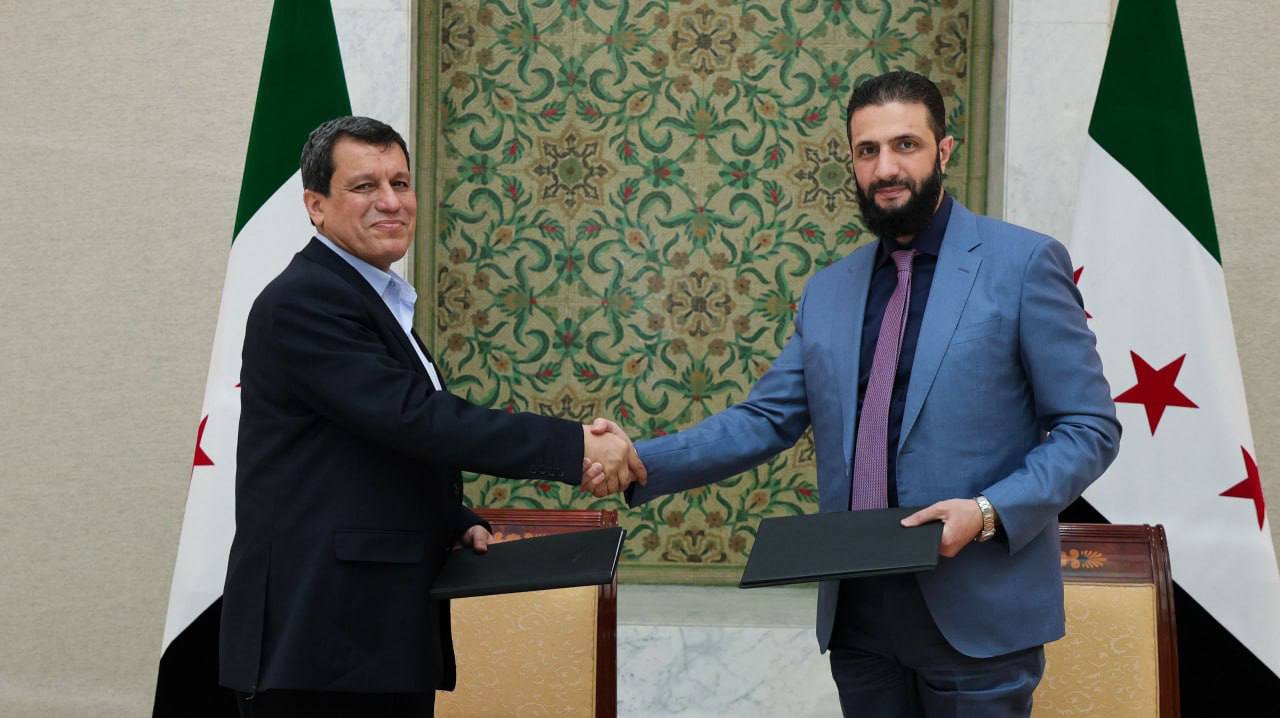عبد الحليم قنديل
قبل 62 سنة من اليوم ، كان العرب فى زمن مختلف تماما ، كانت الأحلام أقرب من أطراف الأصابع ، وكانت أول جمهورية عربية متحدة تقوم فى التاريخ الحديث والمعاصر صباح 22 فبراير 1958 .
لم تكن وحدة مصر وسوريا ، وهما معا قلب القلب فى خرائط الأمة ، لم تكن عملا عابرا ، برغم أن صورتها الاندماجية ، لم تستمر سوى لثلاثة أعوام وما يزيد قليلا على نصف العام ، بعدها وقعت كارثة وانقلاب الانفصال يوم 28 سبتمبر 1961 ، فى سياق معارك صاخبة مدوية ، فى ميادين التحرر الوطنى والتغيير الاجتماعى والاقتصادى والثقافى ، كان فيها ثلاثى أعداء الأمة على حاله المتصل إلى اليوم ، أمريكا فى القلب ، وإسرائيل على يمينها ، والرجعية العربية على يسارها ، كما كان جمال عبد الناصر يرسم الصورة ، لتقريبها إلى أذهان ووجدان الناس .
وكان بوسع جمال عبد الناصر ، وهو القائد الأكثر شعبية فى عموم التاريخ العربى ، أن يوجه ضربة قاضية لحركة الانفصال العميلة فى دمشق ، لكنه لم يفعل بالسلاح ، ربما لحرصه على أن يظل الاتجاه للتوحيد العربى عملا شعبيا صافيا ، لا تشوبه شبهة إجبار ولا قسر ، ولا سيل دماء ، ولا تمزق داخلى كان يهدد سوريا ، التى أحبها جمال عبد الناصر وأحبته ، وإلى أرقى الدرجات العلا من الامتزاج الصوفى الخالص ، ولإيمان عبد الناصر المطلق ، أن تجربة الوحدة التى انتهت بانفصال صادم ، لن تكون الأخيرة ، وأنها صالحة لاستلهام عظات ودروس الإخفاق فيها ، وأن العروبة والتوحيد قدر وحياة أمة ، تتقدم إليها ، بقدر ما تنفك من الجمود والرجعية والتخلف ، الذى دام قرونا ، ويحتاج الخلاص منه إلى حركة وجهد أجيال ، تفتح طرق التقدم والتحديث والعلم والتصنيع ، وإعادة بناء أمة قادرة ، تخوض سباق العصر بأدواته ، وتخلق من الأمة الهرمة أمة جديدة ، طامحة للتوحيد واسترداد المستقبل الذى تستحقه .
وقد مضى وقت طويل على ما كان ، وجرى الانقلاب الشامل على الثورة فى مصر أواسط سبعينيات القرن العشرين ، وسقط عامود الخيمة ، فانهار الوضع العربى كله ، إلا من عناصر مقاومة ، توالى الإيمان بحلم التقدم والتوحيد والتحرير ، وتخوض معارك السلاح والسياسة ، وتتحدى الانهيارات الدراماتيكية ، التى سرت بالتفتيت إلى أقطار عربية معتبرة ، وحولت عشرات ملايين العرب إلى نازحين ولاجئين ومشردين ، وجعلت سيوف العدو التاريخى سالكة فينا ، وحولتنا إلى حطام وركام وغبار ، وإلى حد بدت معه كلمات “العربى” و”العرب” و”العروبة” ، كأنها فى عداد الشتائم والنقائص والمعايب ، وصار مطلب الوحدة الوطنية داخل كل قطر عربى صعب المنال ، وفى أحيان بدا مستحيلا ، كأنه الغول والعنقاء والخل الوفى ، بينما كان مطلب توحيد الأقطار العربية هو مجرى السعى السياسى المباشر قبل نحو ستين سنة .
ولم يكن ما جرى نوعا من سوء الحظ ، ولا بؤس الأقدار ، فإرادة الشعوب من إرادة الله ، والشعوب هى التى تصنع زهوها أو بؤسها ، وأعمار الأمم وحوادثها طويلة المدى ، وليست كأعمار الناس والأجيال ، التى تفنى وتحيا عصرا بعد عصر ، وقد كانت مفارقة دورات عصرنا العربى المتوالية حوادثه ، أن الأمة ما كادت تحقق نصرا عسكريا باهرا فى حرب أكتوبر 1973 ، وبذات القانون ، الذى يجمع مصر وسوريا فى قلب التعبئة العامة للأمة ، ما كدنا نحقق النصر النظامى ، حتى كانت الخيانات النظامية تنتظر النصر ، وحتى بدأت مواسم الهجرة من حلم العروبة والتوحيد والتقدم ، والهزيمة الحضارية بعد النصر العسكرى ، وقطع الطريق على حيوية الأمة المستعادة بنضج أعمق ، ومصر فى قلبها ، وتأكيد للمقدرة على تجاوز هزيمة 1967 ، وتحويلها إلى كبوة خاطفة ، بينما تحول النصر فى 1973 إلى نصر مخطوف بخذلان السياسة المرتدة ، وبالانقلاب الشامل بعد النصرعلى اختيارات النهوض العارم ، وبانفتاح “السداح مداح” ، الذى بدأه السادات فى مصر ، وبخلع وتفكيك ركائز الإنتاج والتصنيع الشامل ، وبقيادة حملة تكفير بالعرب والعروبة ، ووصف السادات المبتذل للعرب بالجرب ، وبالصلح مع العدو الإسرائيلى ، وفك التزامات مصر العربية ، وتحطيم دورها القيادى ، وترك مقاعد التوجيه لفوائض الثروة البترولية الخليجية ، التى كان جل همها ، أن توظف الثروة للانتقام من الثورة ، وإلى آخر ما جرى من انهيارات فى بنية مصر بالذات ، وتغول أدوار اليمين الدينى الموالى عقديا للرجعية العربية ، وكان انهيار دور مصر فى الإلهام القومى العربى ، هو السبب الأساس فيما جرى من انهيارات بعدها ، برغم وجود لا ينكر لبؤر مقاومة ، ظلت صامدة بدرجات ولعقود ، فالأحلام لا تحقق نفسها بنفسها ، بل يلزم أن تتحول الأحلام إلى أهداف على مسرح التاريخ ، وأن تتقدم لتحقيقها قوى مستعدة ، تستند إلى عامود فقرى ناظم ، بدت مصر هى المؤهلة له أكثر من غيرها ، باعتبارات عبقرية المكان ، وتجانس المجتمع ، وكثافة البشر ، وأقدار التوزيع السكانى ، التى جعلت ثلث الأمة العربية كلها فى بلد واحد ، إضافة لكثافة الإلهام الموحى فى حوادث التاريخ القريب والبعيد .
والقاعدة العامة فيما نظن ، ولها وعليها ألف برهان وبرهان ، أنه كلما نهضت مصر نهض العرب ، وكلما كبت خبت جذوة العرب والعروبة ، وبعدت الشقة بآمال التوحيد ، وقد لا ينتبه الكثيرون ، إلى أن تجربة وحدة مصر وسوريا ، وعلى قصر سنواتها العابرة ، لم تكن الحدث الأول من نوعه ، بل كانت القاعدة والأصل لمئات السنوات ، فقد كانت مصر وسوريا ولاية وكيانا سياسيا واحدا ، على مدى 650 سنة ، فى ظل اضمحلال مركز الخلافة فى الزمن العباسى المتأخر ، ومن عهد دولة أحمد بن طولون فى مصر ، إلى الغزو العثمانى الذى فصل مصر عن سوريا مجددا ، وفى عصر وحدة مئات السنوات بمعايير زمانها ، لم يتحقق نصر واحد للأمة ، إلا بفضل وحدة مصر وسوريا الكبرى ، التى كانت تضم سوريا الحالية مع لبنان الحالى والأردن وفلسطين المحتلة ، وكانت هذه الوحدة ، هى الصخرة التى تحطمت عليها غزوات المغول والصليبيين ، وتوالت فيها حروب “عين جالوت” قطز و”حطين” صلاح الدين الأيوبى ، إلى سواها من عشرات المعارك الكبرى ، وإلى أن وقعت المنطقة كلها فى ظلام التخلف العثمانى طويل الأمد ، وبما حطم مناعتها بانفصال سوريا عن مصر، وجعل المنطقة كلها نهبا لزحف الاستعمار الأوروبى بأسلحته الحديثة المتفوقة ، وبرغبته المتوحشة فى التوسع على حساب أملاك “رجل أوروبا المريض” ، وبزاد من العلم والمعرفة ، اكتسبه الطامعون فى قرون غيبوبتنا الطويلة ، التى عادت إلينا ، وتردينا فيها عبر عقود ما بعد النهوض القومى ، الذى اتصلت حلقاته فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين ، وصولا إلى حرب أكتوبر 1973 ، التى بدا العرب فى أعقابها كما لو كانوا مهيئين لاحتلال مكانة القوة السادسة فى العالم ، ثم كان ما كان من انهيار ، بدأ بانكسار عامود العرب الفقرى ، بدءا من مصر بالذات .
وخلاصة ما تقدم فى بساطة ، أن عودة مصر لدورها ، هى حجر الزاوية فى السعى لأى نهوض عربى جديد ، مع استعادة سوريا لعافيتها ، بعد حروب كافرة ، كادت تحطم وجودها ، فوق أنها اغتالت حلم ثورة التجديد فيها ، وحولتها إلى ثورة على سوريا ، لا ثورة فى سوريا ، فلا يصح التوقف عند أى حاكم عابر بطبع النظم المتحولة ، لا فى سوريا ، ولا فى مصر ، وإن كانت ممكنات النهوض أكبر بالطبع فى مصر ، وبشروط خمسة تمهيدية نتصورها ، أولها : تأكيد الاستقلال الوطنى ، وثانيها : أولوية التصنيع الشامل ، وثالثها : رد الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية ، ورابعها : كنس امبراطورية الفساد والنهب المتحكمة ، وخامسها : فتح المجال العام وإطلاق الحريات وصولا لقانون عفو شامل عن كافة المحتجزين السياسيين فى السجون ، لا يستثنى منه سوى المتهمين أو المدانين فى جرائم عنف وإرهاب مباشر ، فتفكيك الاحتقان الاجتماعى والاحتقان السياسى هو الهدف المباشر ، الذى يصح أن يعطى الأولوية فى عمل المكافحين الوطنيين داخل مصر ، وهو شرط مسبق لتجديد دور مصر العربى ، وجعلها مركز الإلهام القومى من جديد ، فلم تقم وحدة مصر وسوريا قبل أكثر من ستين سنة ، إلا فى سياق نهوض تحررى جبار ، قد لا يسوغ استنساخ أدواته مع اختلاف الظروف ، بل يكفى أن نحفظ قانونه ، ونصوغ الأساليب المناسبة لإيقاع اللحظة ، وبجهد الناس الأحرار ، القادر إن أراد وتوحد وصمم ، أن يسترد المستقبل العربى الممكن ، وبصور أبهى مما كان فى زمن ثورات الضباط الأحرار .