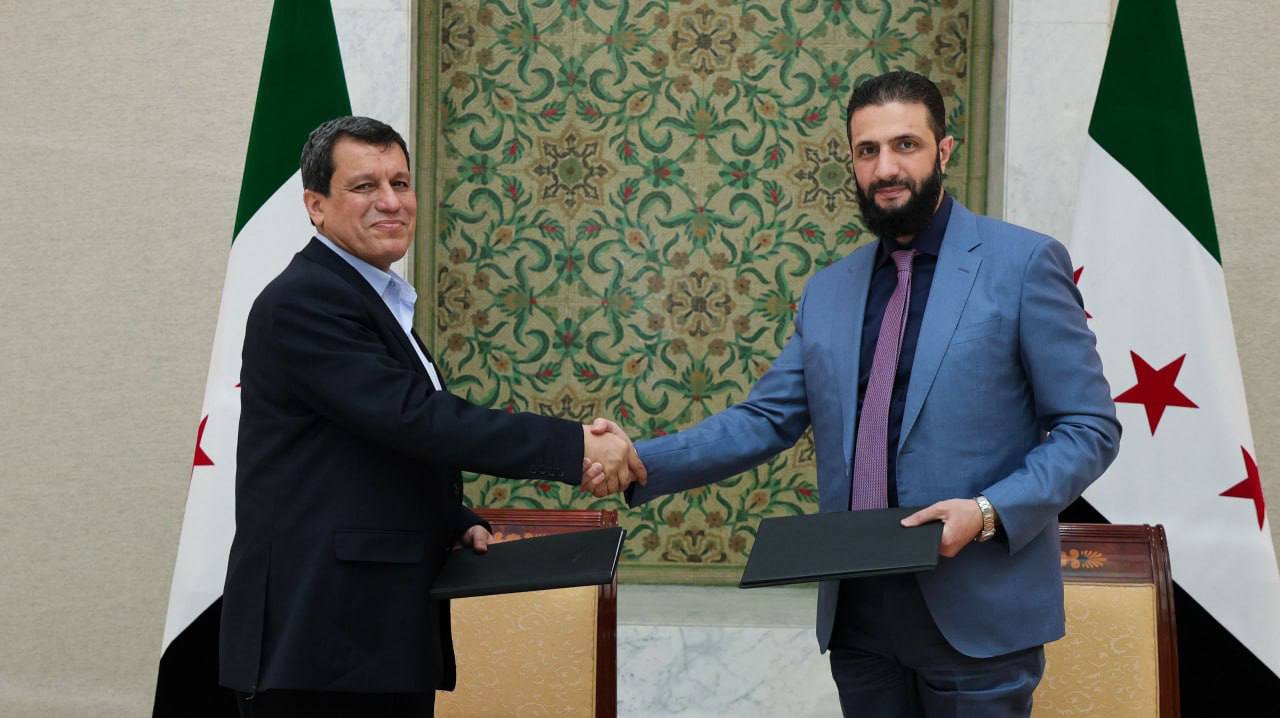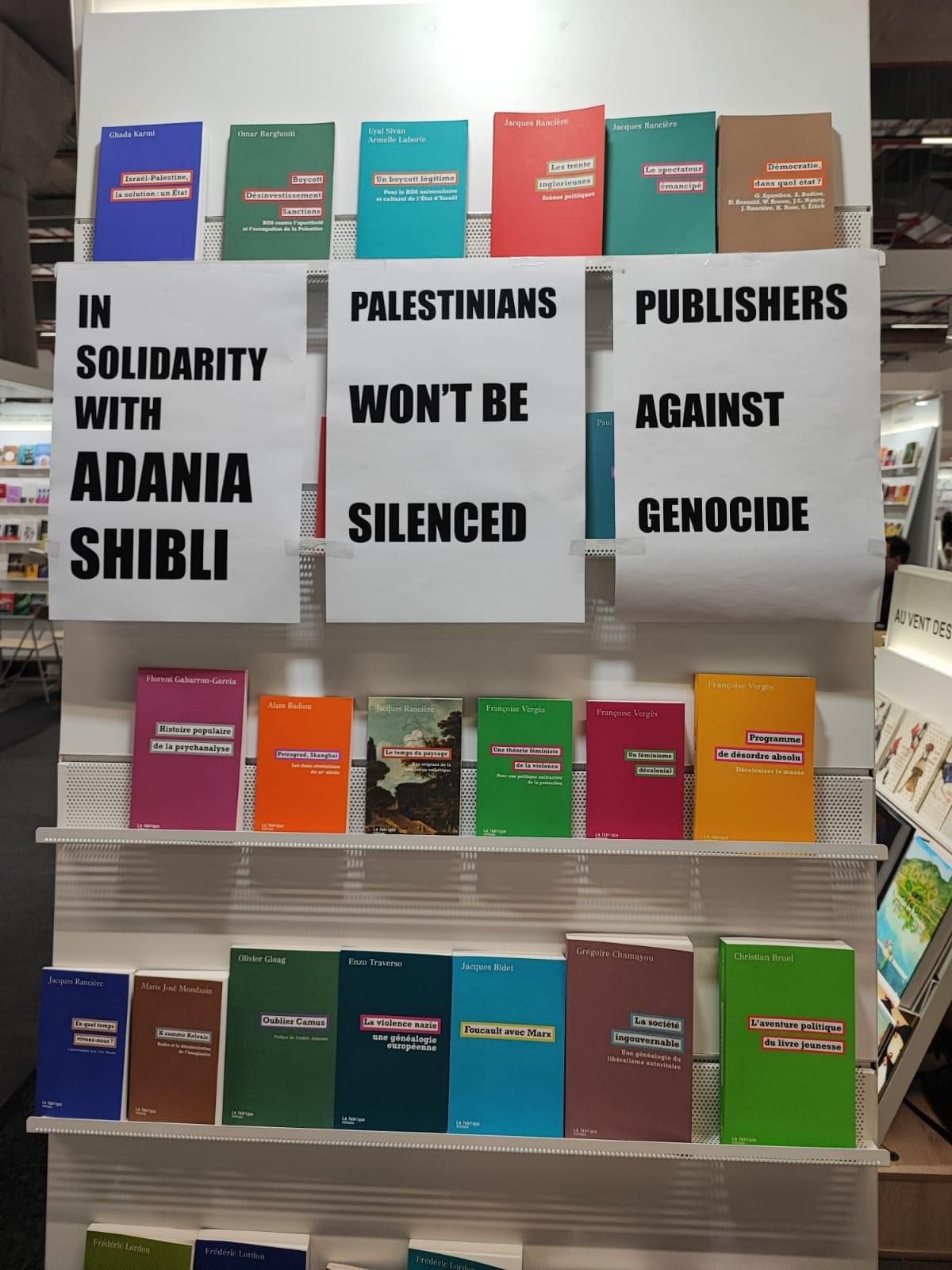بقلم محمد علي صايغ

الدكتور جمال الأتاسي رجل الفكر والسياسة معاً ، لم يكن منظراً كلاسيكياً في الفكر ، والفكر لم يكن دائرة مغلقة عليه في عالمه الخاص ، وإنما كان إهتمامه بالفكر – استناداً إلى تخصصه في علم النفس الطبي – من أجل فهم السلوك البشري والمجتمعي ونقله الى عالم السياسة ، وانخراطه في العمل السياسي الميداني ، ليكون الفكر محركاً لرؤيته ومواقفه السياسية ، ولتكون السياسة ليس اهتماماً عرضياً ، وإنما دفعاً للتغيير في بنية مجتمعاتنا العربية ، وتحولاً بها من مجتمعات هلامية تتحرك بفعل ارتباطاتها القبلية والعشائرية ونزعاتها المذهبية والإقوامية الضيقة إلى مجتمعات موحدة ومنظمة ومنتظمة في هيئات وأحزاب مدنية ، تمارس دورها وحضورها وفعلها في الانتقال بمجتمعها من إطارات الدولة ما قبل الوطنية إلى الدولة العصرية بكل مقاييسها ، مقدمة لا بد منها للانتقال إلى دولة الأمة ، إذ لم يفارق هاجسه بوحدة الأمة العربية كضرورةً من ضرورات النهضة والتقدم طيلة مسيرة حياته وحتى وفاته ..
ولقد خلف الدكتور جمال الأتاسي تراثاً ضخماً سواء في الفكر السياسي أو في الرؤية الاستشرافية والتحليلية في السياسة إن كان في كتبه أو مقابلاته أو مقالاته العديدة جداً التي تأثر بها وتفاعل معها الكثيرين من أبناء جيلنا ، وأزعم بأنني واحد ممن تأثر به بالفكر والسياسة وكان أحد الركائز المهمة في تكوين وعيي السياسي وفهم الديناميكيات اللازمة لتغيير مجتمعاتنا ، تجاوزاً للتخلف والاستبداد المشرقي المملوكي ، وصولاً الى الدولة الديمقراطية التداولية التي تؤسس دعائم القانون وحكم المؤسسات وترسي قواعد المواطنة المتساوية لجميع السوريين . ولكن هذا التراث الضخم للدكتور جمال الأتاسي
وبالرغم من تأثري العميق برؤيتة وخطه ، ومتابعاتي لكتاباته ومواقفه السياسية ، ورغم القيمة المعرفية والسياسية ، والدور الكبير لما قدمه وأنجزه من مقدمات مهمة في رؤيته للتغيير ، وفي مواقفه القطعية بمواجهة الاستبداد وداعميه ، فإنه لا بد من وقفة نقدية لبعض مواقفه السياسية من منظور المراجعة ، ليس من أجل الحط أو التقليل مما قدمه الرجل ، وما رسمه من رؤية في السياسة ، وفي حركة نضالاته السياسية ( فالبشر خطاؤون ) ، وإنما من أجل الاستفادة من الأخطاء في حركتنا ومواقفنا المستقبلية .
وفي هذه الوقفة النقدية سنتطرق الى المحطات التالية :
١- قبل انفصال الوحدة السورية – المصرية ، وفي خضم الصراع بين من يدفع باتجاه الانفصال ، ومن يتمسك باستمرار الوحدة السورية المصرية ، ونتيجة لتغول الشخصيات السياسية في سورية ، والشخصيات الأمنية وصراعاتها ، اتخذ جمال الأتاسي قراراً بالابتعاد عن الصحافة والنشر وأعلن على أن ” الصمت موقف ” .. صحيح أنه بعد الانفصال عاد بقوة ليعلن موقفه ضد الانفصال وطالب بإعادة الوحدة ، لكن موقفه قبل جريمة الانفصال باتخاذه ” الصمت موقف ” لم يكن مبرراً تحت أي ظرف كان .. فالصمت لا يعدل او يصحح المواقف والأخطاء ولا يحرك الساحة الشعبية في مواجهتها ، وكان نضاله السياسي يحتم عليه عدم ترك الساحة للأقلام الانفصالية ، والاستمرار في مقاومتة للتدخل الأمني في الحياة السياسية ، وفي التركيز على أهمية الوحدة وسبل معالجة أخطائها وعثراتها ، وفي كشف ما يروج له الانفصاليون في الهجوم على تجربة الوحدة وعلى الأخطاء الفردية لسلوك بعض القيادات السياسية والعسكرية التي كانت تعمل من أجل التمهيد للانقلاب على الوحدة .
٢- جمال الأتاسي كان من أوائل الداعين الى وحدة القوى الوطنية كخط استراتيجي في العمل الوطني ، وأسس تحالفاً للقوى الوطنية 1968 قبل قيام الحركة التصحيحية ، انتهت بالملاحقة والاعتقال لقيادات هذه الجبهة . وكان قيام الحركة التصحيحية الانقلابية وما أطلقته من وعود ، والدعوة الى الجبهة الوطنية التقدمية ، وما ترافق معها من التوجه الى الوحدة القومية ( اتحاد الجمهوريات ) … ، هذه الوعود بالإصلاح والتغيير ، كانت دافعاً للدكتور جمال في أن يدفع ويضغط على حزبه للانخراط بالجبهة التي طرحها النظام الحاكم ، واستطاع لقناعته بأهمية تحالف القوى التقدمية ، وشخصيته المحورية ، ان يدفع بالحزب الى الموافقة على المشاركة بالجبهة التقدمية بعد أن حصل على موافقة 51 % فقط في اللجنة التنفيذية .
والسؤال المثار دائما ، هل كان الدكتور جمال على صواب في هذه المشاركة ؟؟ وهل خانته رؤيته الحصيفة في أن الانقلابات العسكرية لا يمكن أن تؤسس لحياة مدنية وحزبية وتفتح لجميع الأحزاب وقوى المجتمع المدني المشاركة بالحكم ؟؟.
بعد سنوات من المراجعة والتقييم أظن أن الدخول للجبهة التقدمية مع النظام الانقلابي كان خطأً استراتيجياً ، ذلك لأنه بالرغم من أن القرار الذي اتخذ بالحزب بالخروج من هذه الجبهة بعد سنة ونصف تقريبا، بعدما اكتشف أن العقلية العسكرية السلطوية غير قابلة لإشراك قوى المجتمع بالسلطة والحكم ، فقد كان وهو المفكر والسياسي المخضرم وصاحب الرؤية الاستشرافية أن لا يصل الى هذه النتيجة بعملية التجريب التي خاضها ، أواستنادا للوعود التي تلقاها ، وهو المطلع على تجارب عديدة أثبتت أن الإنقلابات العسكرية في العديد من الدول فشلت في أن تحقق انتقالاً ديمقراطياً ، وأنها بطبيعتها وتكوينها لا يمكن أن تسمح بالمشاركة مهما ادعت في بياناتها الأولى عندما استولت على الحكم .. وكان من نتائج دخول حزبه الجبهة التقدمية – بالرغم حجمه وشعبيته الواسعة في ذاك الوقت – إنقسام الحزب وما جره هذا الانقسام إلى بداية استنزاف جديدة في كوادره ودوره وحضوره في الأوساط الشعبية …
٣- بعد قرار خروج حزب الاتحاد الاشتراكي العربي من الجبهة الوطنية التقدمية قرر أمينه العام الدكتور جمال الأتاسي العودة إلى العمل السري ( تحت الأرض ) ، وذلك حفاظا على الحزب من الملاحقات والاعتقالات التي قد تأتي على كوادره ..
وبالرغم من قناعة الدكتور جمال ووقوفه ضد العمل الانقلابي للتغيير ، فإن العمل السري في جوهره ومٱلاته عملاً انقلابياً ، لا يؤسس لحركة أو حراك شعبي ..
وبالرغم من ثقل حجم كواد حزب الاتحاد الاشتراكي وحضورها في الاوساط الشعبية حتى بعد حدوث انشقاق من كتلة داخله انتهازية رفضت الخروج من الجبهة ، وبالرغم من أن الحركة التصحيحية لم تكن تستجمع بعد كامل عناصر قوتها وقواها ، فإن القرار بالعودة الى قاعدة سرية الحزب وعلنية الأهداف في ذلك الوقت لم يكن موفقاً صحيحا .. خاصة وأنه بعد مرور أكثر من ربع قرن ، وفي المؤتمر الثامن للحزب أعلن الدكتور جمال القطع مع العمل السري ، والخروج الى العمل العلني ، وتفعيل دور الحزب في كافة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ، وطالب بأن تتقدم كوادر الحزب بأسمائهم كمثلين عنه في الأوساط الشعبية وحتى الرسمية إن وجدت .
كان ذلك بعد ثلاثين عاما تقريبا من العمل السري ، وفي ظل الانخفاض الكبير في حجم كوادر الحزب وقدراته ، وفي إطار التضخم الهائل في القوى العسكرية ، والقوة الأمنية للنظام ، تم إعلان العمل العلني بديلا عن العمل السري ..
وفي المقارنة بين مرحلة الولوج الى العمل السري بعد الخروج من الجبهة ، ومرحلة تبني العلنية السياسية والتنظيمية بعد عقود من الزمن، نجد أن الحزب بقيادة الدكتور جمال قد ضيع فرصة استثمار البقاء – بعد إدارة الظهر للجبهة – في العمل العلني ، وفرضه كأمر واقع على النظام وما يمكن أن يشكل ذلك من حضور وتأثير في الساحة السورية ، ولو كان ذلك سيؤدي إلى دفع أثمان بالملاحقات والاعتقالات في ذلك الوقت ، إذ أن العمل العلني أو أي عمل مهم له ضريبةً ستدفع ، وقد دفعها الحزب وهو في العمل السري في العديد من حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات أيضاً ..
٤- لا يمكن أبداً الحط من مكانة الفكر والدور السياسي للدكتور جمال الأتاسي واتساع علاقاته في الإطارات السياسية المتنوعة ، كما لا يمكن الدخول في تقييم ومراجعة ما قدمه من إنتاج فكري وسياسي ، فذلك من أختصاص المختصين من رجال الفكر السياسي .
ولكننا سنتوقف هنا على قيادته لحزب الاتحاد الاشتراكي من عام ١٩٦٦م حتى وفاته عام ٢٠٠٠م .
ولا شك بأنه في الستينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي كان هناك نوع من القيادة الأبوية المنتشرة للشخصيات التاريخية في قيادة الدول وزعامات القوى السياسة .
ولكن جمال الأتاسي الذي طرح بقوة التحول الديمقراطي وتداول السلطة ، كان عليه إعداد البدائل في حزبه لا البقاء على رأس الحزب طيلة امتداد أكثر من ثلاثة عقود حتى وفاته ..
من الصحيح أن الدكتور جمال شخصية كارزمية بفكره ورؤيته السياسية ، كان يتجاوز جميع من كان حوله ، وكان ينال إجماعاً في مؤتمرات الحزب لإبقائه في أعلى الهرم ، وصحيح أنه حاول طلب إعفائه من منصبه كأمين عام للحزب أكثر من مرة، لكن ذلك لايبررأبداً إعمال قاعدة ” الإستمرار – لعدم وجود البديل – ضماناً للاستقرار ” . قد يختلف مستوى الأداء بين قيادة وأخرى نسبياً ، ولكن التجربة العملية تعتبر مجالاً حيوياً لإنتاج القيادات الجديدة ، فكان عليه أن يصر على الصيغة التداولية في القيادة ، ولا يجوز لنا أيضاً التبرير والتعلل بالظروف الناشئة في تلك المراحل ، ذلك لأنه هو الذي كان يؤكد على تجاوز الظروف بالعمل ، وأهمية دور المؤسسات الحزبية ، وكان لا بد من تأسيس وإرساء – بدوره وشخصيته – المعايير المؤسسية التي تفرز قيادات قادرة على الحلول محل أية قيادة بالترك أو الموت ، وبالتالي فالمؤسسات القوية لا تتأثر بغياب أي قائد لها ، وكان من الأفضل للحزب ومستقبله أن يبقى جمال الأتاسي خارج العمل التنظيمي وقيادته ، وأن يبقى مرجعاً فكريا وسياسياً للمؤسسة والقيادة الحزبية التي تحل محله .
ولا بد أخيراً من التأكيد على أن أي تقييم لمرحلة ما أو شخصية تاريخية يجب أن ترتكز في تحليلها وتقييمها على معيار المكان و الزمان وتغير الاحوال والظروف ، ولا شك قد يكون لمواقف جمال الأتاسي محركات موضوعية وذاتية عند اتخاذ القرارات ، ولكننا في تقييمنا اليوم لا نتجه بالتأكيد الى التقليل من حضوره وفعله وجهوده المتواصلة في العمل الحزبي والوطني والقومي ، وإنما ينطلق هذا التقييم من أجل المراجعة والتصويب لدورنا وأدائنا ، تجاوزاً لأخطاء الماضي ، والاستفادة منها في الحاضر والمستقبل .