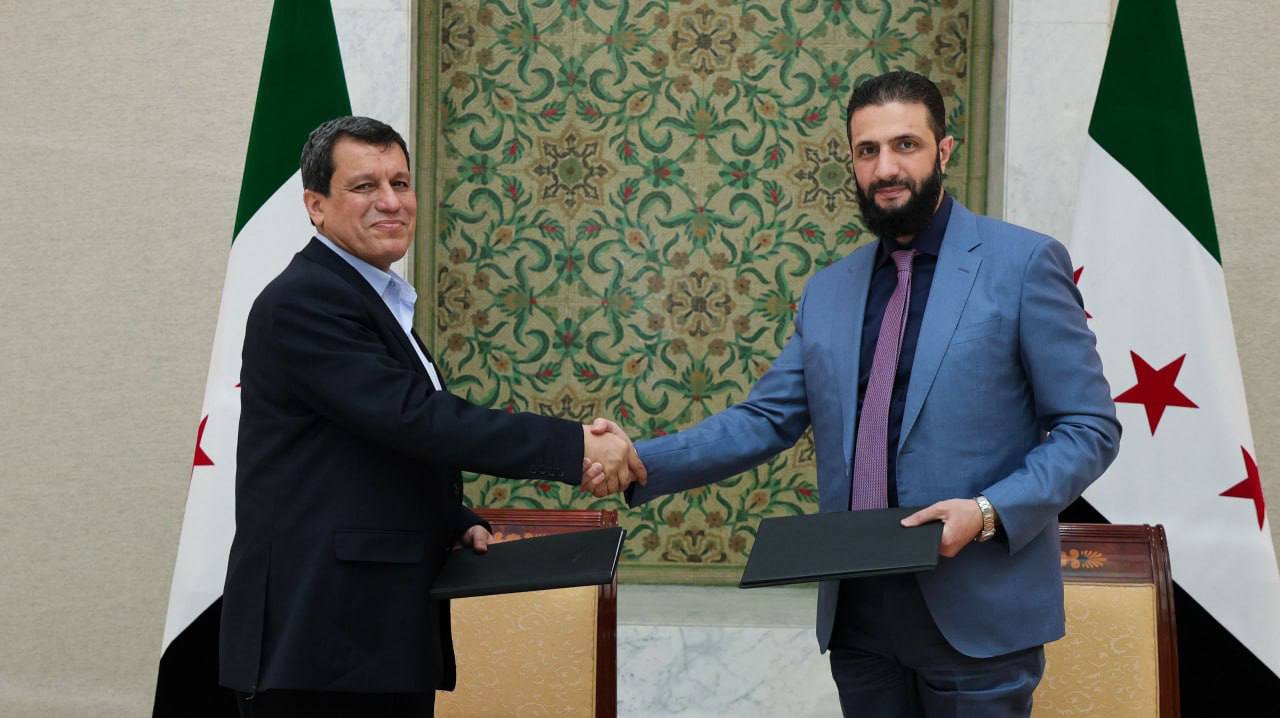صبحي غندور*
كم المسافة الفكرية والسياسية شاسعة بين 22 فبراير 1958 و22 فبراير 2023. فإتّساع المسافة لا يتوقف فقط على البعد الزمني ومرور أكثر من ستة عقود على إعلان الوحدة المصرية – السورية عام 1958، بل المسافة بعيدة جداً من حيث اختلاف ظروف وواقع هذين البلدين، كما هي في عموم الأمّة العربية، بين ما كانت عليه من تضامن ووعي وآمال، وما هي عليه الآن من تخبّطٍ داخلي وبحثٍ عن الهويّة وخوفٍ على المستقبل.
وحينما جرت أول محاولة فعلية لتحطيم اتّفاقيات (سايكس- بيكو) بإقامة “جمهورية عربية متّحدة” تربط جناحيْ الأمّة في المشرق والمغرب، من خلال وحدة مصر وسوريا في 22/2/1958، انقضّت كل القوى الأجنبية عليها لوأدها في المهد، فلم تعش أكثر من ثلاث سنوات، وكان الانفصال في خريف العام 1961 بداية لحقبة جديدة من الصراعات العربية ومن السعي الأجنبي/الإسرائيلي المشترك لمنع مصر نهائيًّا بعد وفاة عبد الناصر في العام 1970 من تكرار تجربة محمد علي في القرن التاسع عشر، وجمال عبد الناصر في القرن العشرين، من توحيد مصر مع بلاد الشام. فهذا التوحيد كان تاريخيًّا وراء قدرة صلاح الدين الأيوبي على هزيمة جيوش “الإفرنج” وتحرير القدس فيما عُرف بحقبة “الحروب الصليبية”.
من عاصروا في القرن الماضي من العرب تلك الفترة الزمنية الغابرة قبل 65 عاماً، أو بعض آثارها، يدركون هذا الفارق الكبير بين ما كان عليه العرب، وما وصلوا الآن إليه. والحديث الآن عن تجربة الوحدة المصرية – السورية في العام 1958، ليس هو بحنين عاطفي لمرحلةٍ ولّت ولن تعود، بل هو لمواجهة من يُغرق الأمَّة الآن في خلافاتٍ وصراعاتٍ ليس الهدف منها نهضة الأوطان وتقدّمها، بل تقسيمها إلى دويلاتٍ طائفية ومذهبية تتناسب مع الإصرار الإسرائيلي على تحصيل اعتراف فلسطيني وعربي بالهُويّة اليهودية لدولة إسرائيل، فتكون “الدولة اليهودية” قائدة وراعية لدويلات دينية ومذهبية منشودة في المنطقة كلّها!.
هو “زمنٌ إسرائيلي” نعيشه الآن، بعد الانقلاب الذي حدث على “زمن القومية العربية”، حين كانت مصر في عقديْ الخمسينات والستينات من القرن الماضي طليعةً له. فاليوم تشهد كل بلاد العرب “حوادث” و”أحاديث” طائفية ومذهبية وإثنية لتفتيت الأوطان نفسها، لا الهويّة العربية وحدها.
هو “زمنٌ إسرائيلي” الآن على مستوى أولويّة الصراعات في المنطقة، إذ جرى تهميش “الصراع العربي/الصهيوني”، وتنشيط الصراعات الأخرى في عموم “الشرق الأوسط”، بحيث ضاعت معايير “الصديق” و”العدو” وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأصبح “المقاومُ” مُدانًا، والمساندُ والحاضن “الدولي” والأميركي للعدوِّ الإسرائيلي، “مرجعيةً إنسانية” مطلوبٌ تدخّلها لحلِّ أزماتٍ عربية داخلية!.
فما يحدث اليوم لا ينفصل عمّا حدث بالأمس القريب من أولويّة الحرص على الحكم لا على الوطن، وحين تحقّقت في المنطقة العربية، إثر المعاهدات مع إسرائيل، أهدافٌ سياسية كانت مطلوبةً من حرب 1967 إسرائيلياً ودولياً، وقد حالَ جمال عبد الناصر دون تحقيقها عقب الهزيمة حينما رفض استعادة الأرض المحتلة عن طريق عزلة مصر وتعطيل دورها العربي التاريخي، فجاء مِن بعده من فعل ذلك بثمنٍ بخيس…
رحم الله جمال عبد الناصر الذي كان يكرّر دائماً: “غزَّة والضفَّة والقدس قبل سيناء.. والجولان قبل سيناء” والذي أدرك أنَّ قوّة مصر هي في عروبتها، وأنَّ أمن مصر لا ينفصل عن أمن مشرق الأمَّة العربية ومغربها ووادي نيلها الممتدّ في العمق الإفريقي.
الآن، يرى البعض في المنطقة العربية الحلَّ في العودة إلى “عصر الجاهلية” وصراعاتها القبلية، ويستهزئون بالحديث عن حقبة “الخمسينات” التي ولّت!!. وبعضٌ عربيٌّ آخر يرى “نموذجه” في الحل بعودة مصر والبلاد العربية إلى مرحلة ما قبل عصر ناصر، أي العقود الأولى من القرن العشرين التي تميّزت بتحكّم وهيمنة الغرب على الشرق! بينما لا يجوز برأي هؤلاء الحديث مجدّداً عن “العروبة” وعن مرحلة ناصر وتجربته، وعن الأهداف التي سعى لتحقيقها في مصر والمنطقة العربية.
دولة الوحدة عام 1958 لم تكن حصيلة ضمٍّ قسري أو غزوٍ عسكري، أو طغيانٍ سياسي جغرافي من دولةٍ عربية كبرى على دولةٍ عربية صغرى مجاورة. كذلك لم تكن دولة الوحدة نتيجة انقلابٍ عسكري في سوريا، ولا بسبب وجود حزبٍ سياسي “ناصري” فيها قام بالضغط لتحقيق الوحدة مع مصر عبد الناصر.
أيضاً، لم تكن وحدة مصر وسوريا بناءً على رغبةٍ أو طلبٍ من القاهرة، بل كانت حالةً معاكسة، حيث كانت القيادة السورية برئاسة شكري القوتلي (والتي وصلت للحكم في سوريا نتيجة انتخابات شعبية في نظام ديمقراطي برلماني)، هي التي تلحّ في طلب الوحدة مع مصر بناءً على ضغوطٍ شعبية سورية.
هكذا كانت مصر وسوريا والأمّة ككل في نهاية عقد الخمسينات، وما تخلّل تلك الحقبة الزمنية المشرّفة في تاريخ العرب المعاصر من هزيمةٍ لعدوان ثلاثي على مصر، ومن تأميمٍ لقناة السويس، ومن دعمٍ لحركات التحرّر الوطني ضدّ الاستعمار، ومن اعتزازٍ بالهويّة العربية ومضامينها الحضارية.
أمّا اليوم، فالعرب هم بلا دورٍ مصريٍّ فاعل، وأرضهم أصبحت مسرحاً لصراعات نفوذ إقليمي ودولي، وغالبية أوطانهم تعاني من استبداد سياسي وظلم اجتماعي، وهم أنفسهم يختلفون حتّى على الهويّة الوطنية وعلى ما فيها من تعدّدية داخل الوطن الواحد، فكيف بالهُوية العربية المشتركة؟!.
فأين كان مكمن المشكلة في تجربة “الجمهورية العربية المتحدة”، هذه التجربة الوحدوية العربية الفريدة التي جمعت مصر مع سوريا، ثم تعثّرت وحدث الانفصال بعد أقلّ من ثلاث سنوات؟
حتماً لم تكن المشكلة في المنطلقات والغايات، بل كانت في الأساليب التي اتّبِعت خلال تجربة الوحدة. فكل عمل إنساني ناجح (على مستوى الأفراد والجماعات) يشترط تكاملاً سليماً بين “المنطلق والغاية والأسلوب”، وهذا ما لم يحدث في تجربة الوحدة بين مصر وسوريا، إذ أنّ المنطلق كان سليماً بحصول الوحدة بإجماعٍ شعبي في البلدين وبضغطٍ شديد من الجانب السوري. كذلك الغاية الوحدوية كانت سليمةً في كلّ أبعادها، لكن العطب كان في الأساليب التي استخدمت من أجل تحقيق الوحدة وفي سياق تطبيقها.
طبعاً، لم يحدث الانفصال حصراً نتيجة عوامل داخلية وسلبيات أساليب التجربة، بل كان أساساً بتحريضٍ خارجي وبدعمٍ كبير من القوى الدولية الكبرى، التي كانت تتصارع فيما بينها بين كتلةٍ شرقية وأخرى غربية، لكنها اتّفقت على محاربة “الجمهورية العربية المتحدة”، ولأسبابٍ مختلفة فيما بينها.
ولم تكن تلك المرّة الأولى التي تلتقي فيها الدول الكبرى على منع وحدة مصر وسوريا، فقد جرى التآمر أيضاً على دولة محمد علي باشا، التي امتدّت في القرن التاسع عشر من مصر إلى سوريا، من قِبَل قوًى دولية متصارعةٍ فيما بينها غير أنّها توافقت على أن تبقى مصر حصراً في حدودها.
أيضاً، كانت “الجمهورية العربية المتحدة” أكبر الأخطار المحدِقة بــ “الدولة الإسرائيلية” الحديثة النشأة آنذاك، فقد وصف بن غوريون دولة الوحدة بأنّها أشبه بالكمّاشة التي ستقتلع إسرائيل من الوجود.
وإذا كانت جريمة الانفصال التي حدثت عام 1961، والتي كانت جريمةً سياسية بحقّ الأمّة ومستقبلها، وكانت أيضاً عاملاً مساعداً على حدوث هزيمة حرب عام 1967، قد حصلت نتيجة خطايا بعض القيادات والأساليب، رغم حسن المنطلقات والغايات، فكيف سيكون الحال الآن ومستقبلاً، إذا كانت السلبيات قائمةً في القيادات وفي الأساليب والغايات والمنطلقات؟ وكيف إذا لم يقتصر الأمر على المسؤوليات الداخلية فقط، بل طال قوًى خارجية فاعلة في المنطقة، تنسج الآن خيوط أثواب هُويّات جديدة للأوطان والحكومات والشعوب معاً؟!.
لقد كان عقد الخمسينات من القرن الماضي بدايةً لإطلاق حركةٍ قومية عربية وسطية “لا شرقية ولا غربية”، ترفض الانتماء إلى أحد قطبيْ الصراع في العالم آنذاك، وترفض الواقع الإقليمي المجزّئ للعرب، كما ترفض الطروحات القومية الأوروبية العنصرية والفاشية، وتنطلق من أرض مصر التي هي موقع جغرافيّ وسط يربط إفريقيا العربية بآسيا العربية، وتعيش على ترابها أكبر كثافة سكّانية عربية تملك، قياساً بسائر الأقطار العربية الأخرى، كفاءاتٍ وقدراتٍ بشرية ضخمة.
تلك مرحلة قد انتهت، لها ما لها وعليها ما عليها، لكن لم تدرك جماعاتٌ كثيرة بعد أنَّ “القومية العربية” أو “العروبة” هي هويّة ثقافية وليست مضمونًا فكريًا وسياسيًا قائمًا بذاته، وبأنّ بديل ما نرفضه الآن من انقسامات وطنية وطائفية ومذهبية هو التمسّك بالهويّة العربية التي تستوعب أيضًا تحت مظلّتها كل الخصوصيات الإثنية الأخرى. فالهوية العربية مثلها كمثل “الهوية الأميركية” التي استوعبت مئات الملايين من أصول عرقية وإثنية ودينية مختلفة، ومثلها كمثل الاتّحاد الأوروبي وما فيه من تنوّع إثني وثقافي ولغوي حتّى. ولم يتحقّق ذلك للأميركيين وللأوروبيين إلاّ بعد قيام اتّحاد بين ولاياتهم وأوطانهم على أساس دستوري سليم، رغم خوضهم في القرنين الماضيين الكثير من الحروب والصراعات الدامية فيما بينهم.
ألا يحقّ للعرب، وهم يعيشون الآن كابوس حاضرهم، أن يعملوا من أجل مستقبلٍ عربيٍّ أفضل يكون عماده بناء “الولايات العربية المتّحدة” القائمة على أوضاع دستورية مدنية سليمة؟!.
إنّ مسألة “الهوية العربية” هي قضية معاصرة الآن، ومهمّة للمستقبل العربي المنشود، ومدخلها العملي هو كيفيّة المحافظة على الهويّة الوطنية الواحدة المشتركة، في مقابل محاولات الفرز الطائفي والمذهبي والإثني داخل الأوطان العربية.
وصحيحٌ أنّ هناك خصوصياتٍ يتّصف بها كلُّ بلد عربي، لكن هناك أيضًا أزمات يشترك فيها كل العرب أو تنعكس آثارها على عموم أقطار الأمَّة العربية، وهي مشاكل وأزمات تؤثّر سلبًا على الخصوصيات الوطنية وعلى مصائر شعوبها. ولذلك هناك حاجةٌ ماسَّة الآن للانطلاق من رؤية عربية مشتركة لما يحدث في الأمّة العربية وحولها، وعدم الانشداد فقط للهموم الخاصّة بكلّ بلدٍ عربي، وبالتالي العمل من أجل نهضة عربية مشتركة، كما هي الحاجة أيضًا لبناء خطاب وطني توحيدي داخل الأوطان نفسها.
*مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن.