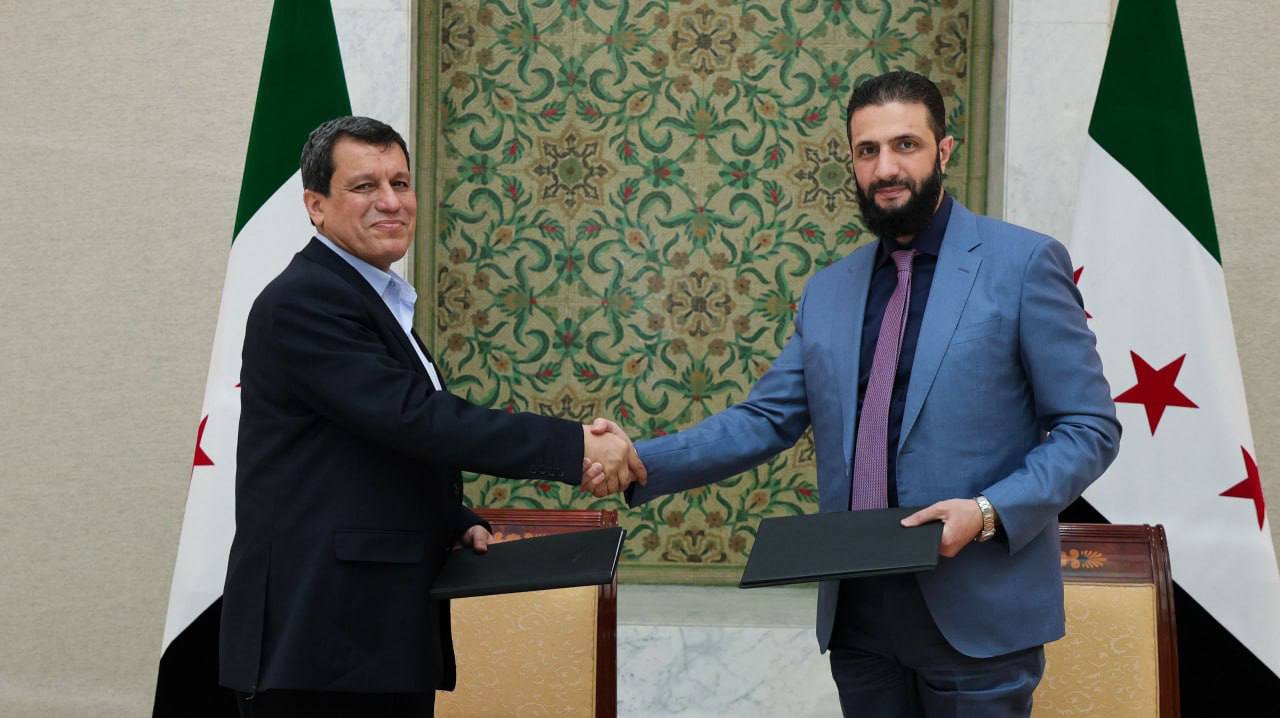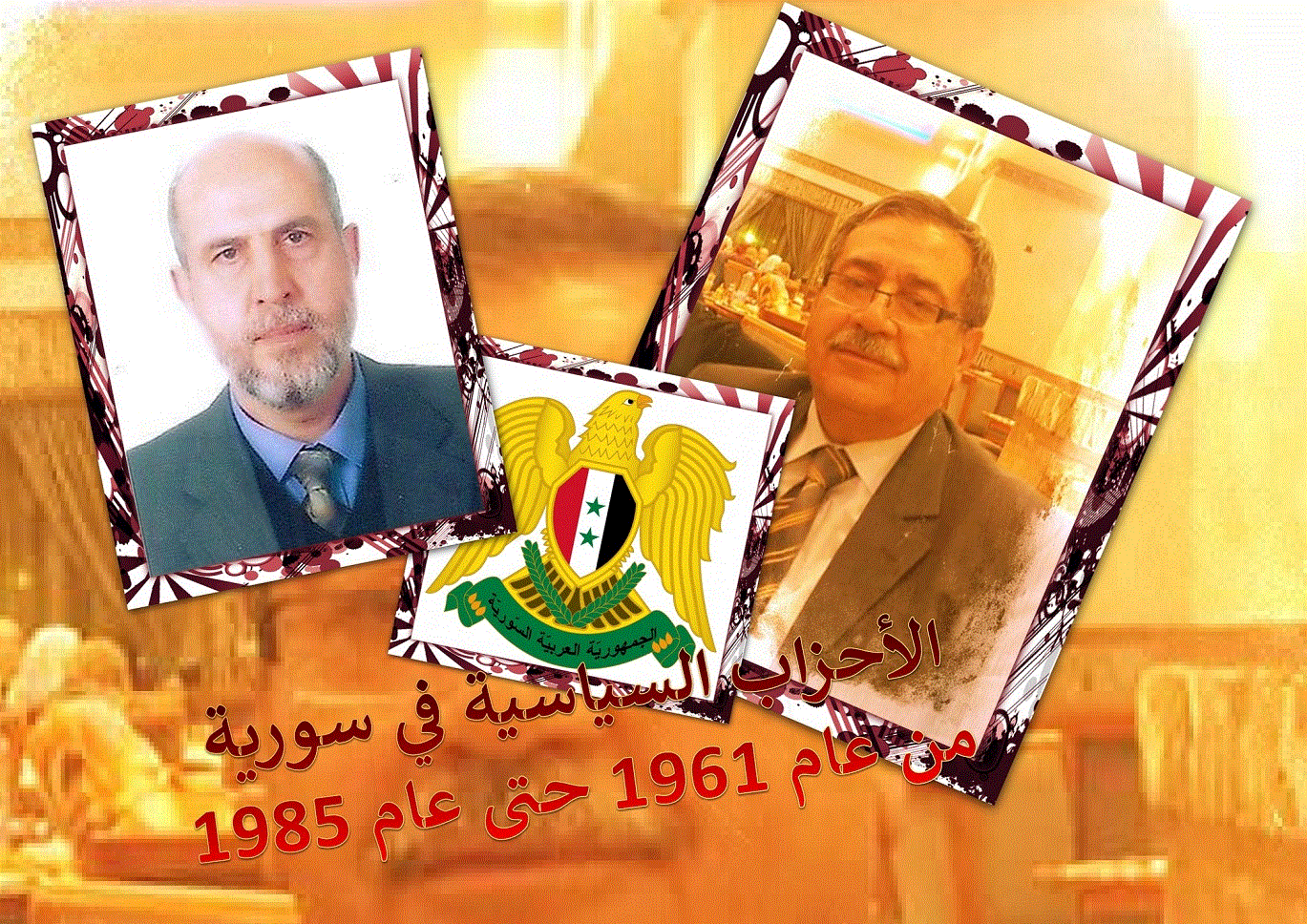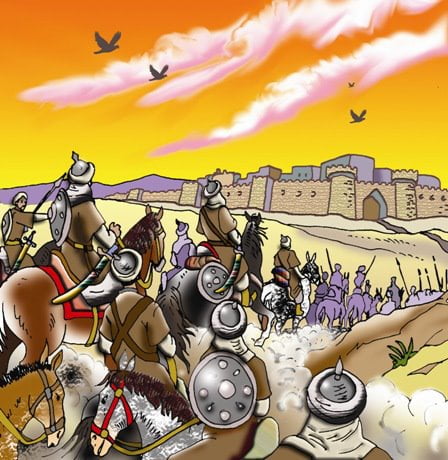رجاء الناصر ـ مخلص الصيادي
يونيو 3, 2023
الحلقة الخامسة الإخوان المسلمون ـ محاولة تفسير 1/6
محطات رئيسية في تاريخ التنظيم ـ مدخل عام
كثيرة هي الفروق بين الاخوان المسلمين في سوريا، والتنظيم الأم في مصر، وتمتد هذه الفروق من القوى الاجتماعية التي استند إليها كلا التنظيمين، إلى السياسات التي اتبعها عبر تاريخه الطويل، إلى المواقف الموثقة التي اتخذها، سواء فيما يتعلق بالوحدة السورية المصرية، أو حديثه عن اشتراكية الإسلام، وأخيرا البرنامج الذي طرحه باسم الجبهة الإسلامية إبان الصراع الدامي بينه وبين النظام السوري في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك فإن الباحث يستطيع أن ينظر إلى تاريخ هذا الحزب على مستوى الوطن العربي باعتباره تاريخا واحدا، يمتلك الخصائص نفسها، ويعبر في أزماته وتطلعاته عن الرؤية ذاتها.
ولا تتأتى وحدة هذا التاريخ من وحدة المنطلق الحركي حيث جميع الفروع انطلقت أساسا من القاهرة، ومن الصلة المباشرة لزعمائها بالقائد الأول والمؤسس لهذا الحزب، المرحوم حسن البنا.
كذلك لا تتأتى من استمرار هذه الصلة وتطورها سواء بالتنسيق أو بالقيادة المباشرة. وإنما فوق ذلك وقبله تجد تفسيرها في ارتكاز هذه الحركة كلها على منهج واحد، وفكر واحد، هو الذي حقق لها ما حققته من مكاسب، وهو الذي أوقعها فيما وقعت فيه من مآزق، وكل هذه التباينات التي يسهل على الباحث رصدها، والتي أشرنا إليها آنفا، سوف يتضح أنها ـ رغم أهميتها ـ تبقى ثانوية، وجزئية، في حياة هذا التنظيم، ومرتبطة أشد الارتباط بظروف خاصة جدا.
يعتبر الإخوان المسلمون أنفسهم تمثيلا حيا لروح “السلف العظيم”، وبالتالي فإنهم مطروحون على أرض الواقع باعتبارهم تجسيدا للأغلبية الإسلامية السنية في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وإذ يعبر الإسلام عن روح الأمة، ويكون الخلفية التاريخية لتشكلها كأمة، فإنهم يسبحون في مياه طبيعية المفروض أن تتيح لهم أقصى درجات الفعل والتأثير في الواقع السياسي والاجتماعي.
وإذ يشير تاريخهم التنظيمي إلى قدرتهم على الانتشار والنماء السريع، فإنه في الوقت نفسه يشير إلى عجزهم البين عن تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها، وإلى تعرضهم المستمر لحملات التصفية والملاحقة من القوى التي وقفوا إلى جانبها وساندوها، ومن القوى التي وقفوا ضدها وصادموها.
وإذا كان من شأن وسائل الاعلام المضادة لهذا الحزب أن تواجههم بصفات “العمالة، والتبعية للخارج”، فإن من شأن الباحث أن يخلص نفسه من آثار تلك الحملات، وأن ينظر بالموضوعية الممكنة إلى هذا التنظيم في محاولة لفهم طبيعته أو سياساته وأزماته، وله بعد ذلك أن ينظر من داخل هذا التنظيم أو من خارجه، من موقع المتعاطف معه، أو المتناقض معه.
محطات رئيسية في تاريخ التنظيم عموما:
بعيدا عن الجزئيات التي يعمر بها تاريخ أي تنظيم، فإننا أمام الإخوان المسلمين مدعوون إلى الوقوف على بعض محطاته الرئيسية التي تبين أن حديثنا عن التناقض بين الإمكانات المتحققة له، وبين النتائج التي حصدها، والتي كشفت عجزا ذاتيا، لم يكن افتراضا مسبقا تحكميا اخترناه لنفسنا، وإنما هو تعبير عن واقع حقيقي يسم تاريخ هذا الحزب/ الجماعة.
نحن هنا لا نرصد كل مواقف الحزب، ولا نخص حديثنا عن سياساته على الساحة السورية، وإنما نقف على محطات رئيسية ظهرت في تاريخ ممارساته على ساحة الوطن العربي كله، نعتقد أن أي باحث مدعو للوقوف عليها، ومحاولة فهم طبيعتها، ومكانتها في فكر الحزب.
1ـ في أوائل العام 1946 كلف الملك فاروق، إسماعيل صدقي بتشكيل الوزارة المصرية، وجاء هذا التكليف في أعقاب حركة شعبية متسعة، وتظاهرات صاخبة شلت كل قطاعات الشعب، وفي أعقاب صدام دامٍ بين الشعب والبوليس سقط على إثره عدد من الشهداء على “كوبري عباس”، كل ذلك رفضا لسياسة الحكومة في التهاون مع الإنكليز، وتأكيدا على حق الوطن في الاستقلال.
ولقد عبر برنامج اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلاب عن الأهداف التي تحرك الشارع الوطني في مصر فكانت ثلاثة:
- الكفاح المسلح من أجل الاستقلال الوطني، والتخلص من السيطرة الاستعمارية، الاقتصادية والسياسية والثقافية.
- القضاء على عملاء المستعمر المحليين من الاقطاعيين، وكبار الماليين المتربطين بالاحتكارات الأجنبية.
- الوحدة الوطنية طريق الشعب لتحقيق ذلك.
ويروي الأستاذ طارق البشري في كتابه” الحركة السياسية في مصر 1945 ـ 1952″ والذي نستند إليه هنا، أن أهم الشعارات التي رفعتها اللجنة كانت أن ” المفاوضات مع المستعمر على حقوق الوطن خيانة”. لقد أصبح الشارع ملكا للناس، وتحت سيطرة قواه المنظمة.
في هذا الوقت بالذات جاء تكليف الملك لإسماعيل صدقي بتشكيل الحكومة، وتاريخ هذه الوزارة محفور بعنف شديد في ذاكرة الشعب المصري:
فالرجل: رئيس اتحاد الصناعات، ومن كبار الرأسماليين المرتبطين بالاحتكارات الأجنبية، وكان هو وراء “أول انقلاب دستوري يحدث بعد عام 1919″، حين قام من موقعه كوزير للداخلية بتزوير الانتخابات، ولما لم يثمر عمله، ونجح الوفد في الانتخابات رغم التزوير، دفع إلى حل المجلس النيابي بعد اجتماعه بست ساعات، وهو صاحب رأي واضح في التحالف مع بريطانيا، والاستناد الكامل إليها، بالمختصر هو غربي بالكامل: روحا، وخلقا، وفكرا، ودون أي طموح وطني مهما كان ضئيلا.
والمهمة: كانت واضحة وهي استرداد الشارع من القوى الشعبية، وإعادته إلى هيمنة وسلطة الحكومة والقصر، وتفتيت وضرب كافة القوى الوطنية، وتصفية قضيتي الجلاء، والوحدة.
وفعل “صدقي” هذا كله، وأضاف عليه الكثير من شراسته، وقبضته الحديدية، فسقط العديد من الشهداء، وقتل كل مظاهر الديموقراطية، وواجه الناس بالحديد والنار، ثم دخل بمفاوضات مع الإنكليز لربط مصر بمعاهدة تحالف مع المستعمر وفق مشروع دخل التاريخ في 26 / 10 / 1946 تحت اسم مشروع ” صدقي ـ بيفن”.
فمن وقف إلى جانب إسماعيل صدقي.؟
غير الملك والإنجليز، لم يكن هناك قوة شعبية واحدة تقف إلى جانب هذا الديكتاتور، الاستثناء الوحيد تجسد في موقف الاخوان المسلمين، هم الوحيدون الذين وقفوا يؤيدونه، ويناصرونه، وسكتوا عن كل ما قام به، وليس من التجني القول إن السطوة والديكتاتورية التي واجه بها الحركة الشعبية كان لها صدى إيجابيا عند الإخوان.
في مراجعة أجراها الأستاذ البشري لكتابه سالف الذكر، يروي على لسان ” محمود عبد الحليم”، أحد وجوه الإخوان وجهة نظر الإخوان في تأييد صدقي، فماذا يقول: “إن تأييد الإخوان لوزارة صدقي كان السند الشعبي الوحيد لهذه الوزارة، وبهذا التأييد أمكن للوزارة الوجود والبقاء، فلما سحب الإخوان تأييدهم سقطت… كان هذا التأييد حدثا غير مسبوق، ومفاجأة في علم السياسية المصرية لم يسبق له مثيل، ولهذا وقف الشعب إزاءها مشدوها”
أما لماذا أخذ الإخوان هذا الموقف فإن التفسير المقدم على جانب كبير من الأهمية، فهو يكشف جانبا من الفكر السياسي لهذا التنظيم، يفسر ـ مع جوانب أخرى ـ ما يبدو غير مفهوم من تحرك الإخوان، وفلسفتهم السياسية، يقول الرجل في تبرير هذا الموقف: “إن من فهم الإسلام يعرف أن دعوته تدور مع الحق، تؤيد من يرفع رايته، وإن كان عدوا، وتضرب على يد من يجادل بالباطل وإن كان صديقا…إن تأييد الإخوان لصدقي كان تأييدا مشروطا، إذ تعهد بالمطالبة بحقوق البلاد، وإلا تخلى عن الحكم، وأذن لهم بمظاهرة 21 فبراير 1946، واستلم منهم بيانا سياسيا يطالبون فيه بالجلاء التام عن أرض وادي النيل، وسحب من أساء إلى القضية الوطنية من ممثلي مصر بالأمم المتحدة، وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن…. ولما شعر الإخوان أن وزارته راغبة بالتساهل مع الإنكليز في حقوق البلاد، اعتبروا ذلك إخلال من صدقي بتعهده لهم، فتخلوا عن تأييده، فسقط”.
هذا التبرير الذي سنتناوله بالتحليل في مكان آخر يحمل في طياته خطأ فاضحا، فحكومة صدقي لم تسقط لأن الإخوان سحبوا تأييدهم لها، وإنما لأن القوى الشعبية دفعت الكثير من دماء أبنائها، وبهذا أسقطت هذه الحكومة، ولقد أكد الأستاذ البشري هذا التاريخ بعين خبيرة، وبصدق مشهود له.
2ـ وتكرر الموقف ذاته مع وزارة النقراشي الثانية، وهي الوزارة التي جاءت لتكمل المسيرة الفاشلة لحكومة صدقي بعد ثمانية أشهر من سقوطها، وفي الحقيقة فإن كل المآخذ التي وضعت على حكومة السلف، هي ذاتها منسحبة إلى حكومة الخلف، على كل المستويات، بدءا من الموقف من الحريات، وحتى الموقف من المفاوضات مع الإنكليز، فقد كانت مهمة هذه الحكومة أن تمرر مشروع “صدقي ـ بيفن” مجددا، ويضاف إلى ذلك أن النقراشي يقف على رأس حزب ” السعديين” وهم أقلية مساندة للملك وتدور في فلكه. ومرة ثانية أيضا فإن الإخوان هم الاستثناء الوحيد على الموقف الوطني العام من هذه الحكومة، ومن المفيد أن نسمع تبرير الإخوان لهذا الموقف، فإن التبرير يحمل في طياته المعاني السابقة نفسها، ويشير إلى الدلالات السابقة نفسها، يورد الأستاذ البشري في كتابه تبريرهم على لسان الشخص نفسه حين يقول: “إن النقراشي لم يكن له مندوحة من اللجوء إلى الإخوان ليستمد التأييد، لأنه لم يحصل على تأييد الوفد، فاستجاب الإخوان، وأيدوا الحكومة، بعد أن أعلنت استجابتها لمطالب البلاد”… وعمل الإخوان على تكوين جبهة، وكان “صالح حرب” هو مفوض عملية توحيد الصفوف، ولكنه أعلن فشله بسبب أن النقراشي أصر على العمل المنفرد…. حين ذاك رأى الإخوان أنهم أمام أمرين أحلاهما مر: إما العمل على إسقاط النقراشي، وفي هذا إضاعة للوقت الثمين، وللجهد الوطني المخلص، وفي هذا مواجهة مباشرة للملك، وإما أن يؤيدوا النقراشي بعد أن قيد نفسه بتصريحات رسمية أنه سيفتح صفحة جديدة في مواجهة المستعمر، واختار الإخوان أمرا اعتبروه أخف الضررين”.
ويتساءل البشري تعليقا على هذا التبرير:
” ما الوقت الثمين، والجهد المخلص الذي كان سيضيع بإسقاط النقراشي؟، كان النقراشي وحزبه يؤازران حكومة صدقي، ومفاوضات ” صدقي ـ بيفن” حتى النهاية، وقد وقع مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى من صدقي رئيس الوزراء، ومن إبراهيم عبد الهادي وزير خارجية صدقي، وهو الرجل الثاني في حزب السعديين وقتها، والذي تولى رئاسة السعديين بعد اغتيال النقراشي.
محطتان رئيسيتان يضاف إليهما تأييد الإخوان للملك فاروق الذي اعتبره “محمود عبد الحليم” دليلا على السذاجة السياسية، رأينا أن نقف عليهما قبل أن نعبر إلى مرحلة جديدة، ومحطات جديدة، وتعمدنا أن نستند بالكامل على كتاب الأستاذ البشري في طبعته الأخيرة (دار الشروق ـ بيروت ـ 1983) لأن الرجل في هذه الطبعة قد أعاد النظر فيما كتبه عن الإخوان، متعمدا أن تأتي دراسته لهم ” دراسة من الداخل”، فيتساوون بذلك مع بقية القوى التي وقف أمامها، ويعطي منطقهم الإنصاف الذي شعر أنه فاتهم فيما سبق من طبعات.
ورغم الجهد الذي بذله في فهم وعرض مدرستهم الفكرية المميزة، وحججهم، فإنه وقف أخيرا يعلن أنه لم يستطع فهم أو تبرير واستساغة هذين الموقفين.
3ـ بعد ما يقرب أربعة عقود على هذا الموقف، وقف الإخوان المسلمون أنفسهم، الموقف نفسه من نظام حكم شبيه بحكومة صدقي في كثير من الجوانب، ويزيد هذا الحكم على ذلك سوءا وينافسه في العداء للوطن، وللحركة الوطنية عموما، بقدر ما جاء موقف الإخوان هنا أكثر التصاقا بهذا الحكم، حتى أن محاولة فرز هذه السوءات وتحديد تبعيتها بين السلطة والإخوان يبدو أمرا صعبا.
بعد كل هذه السنوات يقف الإخوان المسلمون، كقوة وحيدة داعمة ومؤيدة لنظام حكم “جعفر نميري” في السودان، ويشتركون معه في السلطة، ويتسلم العقل السياسي الأول لديهم منصب مستشار النميري، ويقودون وزارات عديدة في المقدمة منها وزارة الداخلية، حيث السجون والمعتقلات وكل أجهزة القمع، ويعيش شعب السودان في ظل القمع المشترك واقعا حالك السواد والسوء.
والنميري غني عن التعريف، لا على مستوى الإقليم السوداني، وإنما على مستوى الوطن العربي كله:
- فهو أبرز مؤيدي اتفاقات الصلح مع “إسرائيل”
- وهو الذي فتح أرض السودان للقوات الأمريكية، وأتبع قوات الجيش السوداني لها.
- وتشير كل الدلائل أن له مساهمة غير منكورة في تهريب ” الفلاشا ـ يهود الحبشة” إلى فلسطين المحتلة.
- وهو عدو الحريات الذي حكم السودان بالحديد والنار كل هذه الفترة.
- وهو الذي يقف على راس تحالف طفيلي ضرب الاقتصاد الوطني وأدخله دوامة المجاعة.
وكل ما يمكن ذكره عن النميري يبقى قليلا، ومبتورا، أمام حقيقة فعله، ومع ذلك وقف الإخوان إلى جانبه، وشاركوه السلطة، والحكم، واشتركوا معه يدا بيد في إقامة محاكمات “للعقل والعقيدة”، أرجعت للذاكرة محاكم التفتيش في عصور أوربا المظلمة، هذه المحاكم التي برئ منها تاريخنا العربي الإسلامي. ولم يكتفوا بذلك، بل وقفوا إلى جانبه وهو يعلن نفسه إماما للمسلمين، وخليفة عليهم.
في مقابلة مع التلفزيون البريطاني على القناة الثالثة خلال شهر فبراير 1985 وقف حسن الترابي مرشد الإخوان المسلمين في السودان يتحدث عن ” حكمة وصدق توجه النميري”، ويدعو إلى السير خلفه، ويقرظ الطريقة التي ينفذ من خلالها الشريعة الإسلامية، وقد اعتبر الإخوان أن الخروج على طاعة” الإمام النميري” خروج على الإسلام.
4ـ شيء شبيه بهذا الذي حدث في السودان حدث بمصر، حينما أصبح الإخوان المسلمون ذراع السلطة المصرية في الاستيلاء على الحركة الطلابية في الجامعات، وعلى ضبط الحركة العمالية، وقد وقف وزير الداخلية آنذاك “النبوي إسماعيل”، والرأسمالي الكبير ” عثمان أحمد عثمان”، وراء شباب الإخوان في الجامعات وأمنوا لهم الدعم الأمني والمالي للقيام بأدوارهم المطلوبة، ومن المعروف أن الرئيس السادات بنى سياسته ـ التي لا تخفى على أحد منذ أن سكتت المدافع عقب حرب رمضان / أكتوبرـ على إقامة تحالف استراتيجي بينه وبين أمريكا وإسرائيل، تحالف ثابت وقطعي وكامل، وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وحينما جاءت اتفاقية الصلح مع العدو الصهيوني فإنها جاءت استنادا إلى هذا التحالف وتتويجا له.
وأثبتت انتفاضة 18 / 19 يناير 1976 التي عبرت عن روح الشعب المصري أن نظام السادات في واد آخر، متناقض ومصادم لكل التطلعات الشعبية، ومع ذلك استمر السادات في نظر الإخوان حتى قبيل توقيع المعاهدة “الرئيس المؤمن محمد أنو السادات”، وعلى لسان السيدة زينب الغزالي يظهر تبرير موقف الجماعة من السادات حينما تقول: “وإنني أقول إن أنور السادات جاء لحكم جمهورية مصر العزيزة وبحار دماء الظلم تجري، فعمل على أن يوقفها، وأوقفها، فعلا،…. أنور السادات رجل مؤمن…. وأعرف إيمان أبيه وتقواه…”.
ورغم معارضة الإخوان لاتفاقية الصلح مع “إسرائيل”، فإنهم رضوا بأن يستقبلوا مفكرين إسرائيليين في مركز مجلتهم، وأن يدخلوا معهم في حوارات، حسب تعبير المرشد العام عمر التلمساني في مذكراته التي نشرتها جريدة الشرق الأوسط السعودية.
5ـ ونحن نذكر محطات رئيسية في تاريخ الإخوان المسلمين فإن صدامهم مع ثورة يوليو في مصر، ثم صدامهم مع نظام الحكم في سوريا في أواخر السبعينات يمثلان محطة رئيسيتين لا بد من الوقوف عندهما في سعينا لتلمس حقيقة العقل السياسي لهذا التيار ومحاولة تفسيره.
إن تحالف الإخوان مع الحكومات الديكتاتورية المرتبطة بالغرب الاستعماري بأوثق الروابط سواء في مصر أو في السودان كان نموذجا قائما بذاته، يقابله تصادمهم مع ثورة يوليو كأنموذج آخر متفرد، ويأتي صدامهم مع نظام الحكم السوري كأنموذج ثالث يحمل خصائصه المتميزة.
في عام 1952، في 23 يوليو، سقط النظام الرجعي الملكي في مصر، وخلال فترة وجيزة ظهر للقادة الجدد للبلد، العسكريين، أن الأحزاب القائمة، وفي المقدمة منها حزب الوفد غير قادرة على تطوير نفسها، ولو خطوة واحدة في اتجاه مطالب الشعب الاجتماعية، وبان عجز هذه الأحزاب أمام هدف ” الإصلاح الزراعي”، الذي طالبت به الثورة، ـ من ضمن أهدافها الستة المعلنة ـ، فقامت بحل الأحزاب وأعلنت موقفا مضادا لها.
هذا الموقف قوبل من قبل الخوان المسلمين بالترحاب، لأنه من الناحية العملية لم يشملهم باعتبارهم بحكم النص القانوني ” جمعية وليسوا حزبا”، ولقد أيد الإخوان حل الأحزاب، وإلغاء دستور 1923، وإعلان فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وحينما أحس الإخوان بالعجز عن السيطرة على مجلس قيادة الثورة، وظهر لهم أن هذه ثورة وليس مجرد تجمع ضباط، وقفوا ضدها، ولعبوا مع الأحزاب الأخرى المنحلة دورا في أزمة مارس 1954، ثم حاولوا اغتيال قائد الثورة جمال عبد الناصر، وكانت محنتهم الأولى مع الثورة.
من المفيد أن نسمع رؤيتهم للعلاقة مع حكم الثورة، ومع أي حكم، وقد صاغ هذه الرؤية سكرتير عام الإخوان آنذاك عبد الحكيم عابدين بقوله:” إن جماعة الإخوان تحدد موقفها من الثورة، ومن أي حكومة على الأسس التالية:
*إما أن تعلن السلطة قيام دولة الإسلام، فنعلن ولاءنا لها، ونذيب وجودنا في وجودها.
*وإما أن تتابع الخطوات الإسلامية تحت أسماء وعناوين إصلاحية، وحينئذ نلتزم بتأييد الحكم مع استمرار تشكيلاتنا لإتمام الرسالة.
*وإما أن تكتفي بالناحية السلبية، فنلتزم السلبية نحوها.
*فإن أبت السلطة ذلك، واستأنفت حملاتها في التنكيل بأهل الدعوة، فنكون مضطرين إلى الدفاع عن أنفسنا”.
منذ أن وجهت إليهم الضربة عام 1954 وحتى اليوم يؤكد قادة الإخوان أن ما عرف بمحاولة اغتيال عبد الناصر “حادثة المنشية في الإسكندرية” في 26 أكتوبر 1954كانت خدعة وتمثيلية، وأن “محمود عبد اللطيف” الذي قام بعملة التنفيذ قد تورط بهذا العمل بدافع من المخابرات المركزية الأمريكية، وأن جمال عبد الناصر كان يلبس حينها قميصا واقيا أتاه مباشرة من الولايات المتحدة قبيل إكمال أطراف هذه التمثيلية.
في العام 1965 وجهت الضربة الثانية للإخوان المسلمين، وكانت التهمة أنهم يخططون لقلب نظام الحكم، ويمتلكون مخططات وأدوات، وتوقيتات، لاغتيال الشخصيات الرئيسية في البلد، وفي المقدمة منهم جمال عبد الناصر، وأيضا تدمير وتخريب المرافق الرئيسية، وعقد المواصلات، ومحطات الكهرباء، والكباري،… وغير ذلك، وكما قال الإخوان عن الأولى تمثيلية، فإنهم وصفوا الثانية بأنها مجرد مؤامرة من السلطة لتصفيتهم.
وإذ تشير كل الدلائل إلى أن الحدثين من صنع الإخوان، فإن تاريخ تاريخهم في التعامل مع نتائج اتجاههم الإرهابي في مواجهة خصومهم يشير إلى أنهم ينكرون دائما كل حادثة يتضح أنهم وراءها، وتنكشف أدوارهم فيها.
في العام 1948 قام الإخوان باغتيال ” سليم زكي” حكمدار بوليس القاهرة، وبعد 24 يوما من هذا الحادث أي في 28 ديسمبر اغتال أحد رجالهم رئيس الحكومة فهمي النقراشي وقاموا في 13 يناير 1949 بمحاولة لنسف دار محكمة الاستئناف في القاهرة، وكانوا قبل ذلك اغتالوا في مارس 1948 أحمد الخازندار رئيس محكمة الجنايات.
ولو جاءت هذه الحوادث ردا على المواقف غير الوطنية لرئيس الحكومة أو على دور الحكمدار في مواجهة الحركة الوطنية لوضع الامر في إطار الرد الوطني على وضع غير وطني ، لكن في الحالتين، وفي الحالة الثالثة أيضا ، فإن موقف الإخوان جاء ردا على موقف السلطة من الإخوان أنفسهم، بغض النظر عن موقفها من القضية الوطنية، ولعل هذا يتفق مع الخطوط المحددة لموقف الاخوان التي أعلنها بعد ذلك عبد الحكيم عابدين، ومع وضوح ارتباطهم بهذه الأحداث فإن المرشد العام المرحوم حسن البنا وقف ليعلن أن من قام بهذه الأعمال ” ليسوا اخوانا، وليسوا مسلمين”، مشيرا بذلك إلى أنهم دسيسة على الجماعة.
ورغم كل ما قيل عن تلفيق التهمة للإخوان في محنتهم الثانية عام 1965 فإن المرحوم سيد قطب يشير في روايته للأحداث التي نشرتها “جريدة المسلمون” السعودية تحت عنوان “لماذا أعدموني”، ـ والتي قالت الجريدة انها آخر ما خطه بخط يده ـ إلى أنهم كانوا يرسمون للقيام بكل الاعمال التي أشار إليها قرار اتهام السلطة لهم، يقول سيد قطب:
” وفقا لهذا جاؤوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجيد قائمة باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان المسلمين في حالة ما إذا وقع اعتداء عليهم لأي سبب، إما بتدبير حادثة كحادثة المنشية الذي كما نعلم لم يدبره الإخوان، أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للإخوان، أو لأية أسباب أخرى تجهلها الدولة، أو تدس عليها، وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية. هذه الأعمال هي الرد ـ فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم ـ بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومدير مكتب المشير، ومدير البوليس الحربي، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة، لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها، وفي خارجها، كمحطة الكهرباء، والكباري، وقد استبعدت فيما بعد الكباري”
وحينما يظهر في المشاورات الجارية أن الإمكانات العملية غير مستكملة لتحقيق هذه الأهداف، وأن الرجال والأسلحة دون المستوى المطلوب لتنفيذ هذه المهمات، فإن الرجل يعطي توصياته بذلك:
” بناء على ذلك اتفق على الإسراع في التدريب بعدما كنت أرى تأجيله، ولا أتحمس له، باعتباره الخطوة الأخيرة في خطة الحركة وليس الخطوة الأولى”.
ورغم أن أحد قادة الإخوان وهو الأستاذ “منير الدلة” قد حذره، وأبدى تخوفه من شباب متهورين مدسوسين على التنظيم من قبل قلم مخابرات أجنبي ـ أمريكا ـ عن طريق الحاجة “زينب الغزالي”، وأن المخابرات المصرية تعرف هذا الأمر، وتتابعه، فإن قلب الرجل كان مطمئنا، يقول سيد: “ولم يكن عندي خوف من ناحية أن يستخدمها أي قلم مخابرات لأنها مكشوفة”.
وكما لم ينظر الإخوان المسلمون في تحالفهم مع الديكتاتوريات المصرية والسودانية إلى مواقف هذه النظم من القضية الوطنية، أو الاجتماعية، فأقاموا التحالف معها، وهي ما هي عليه من التفريط بالحق الوطني، ومن إقامة أعلى أشكال التحالف مع الغرب الاستعماري، ومن قيادة عملية الاستغلال الاقتصادي والتخريب للوضع الاجتماعي ، فإنهم حين اصطدموا مع نظام الثورة في مصر لم يضعوا في اعتبارهم المعارك المستمرة التي كان يخوضها هذا النظام في مواجهة الغرب الاستعماري، ودون أن يعيروا أي اهتمام لشعارات هذا النظام في التصدي للأوضاع الاجتماعية، حتى قبل أن تتحول هذه الشعارات إلى وقائع، واستمروا في إقامة تحالفهم مع أشد القوى رجعية وارتباطا بالغرب الاستعماري وفي المقدمة من هذه القوى على المستوى العربي النظامين السعودي والأردني