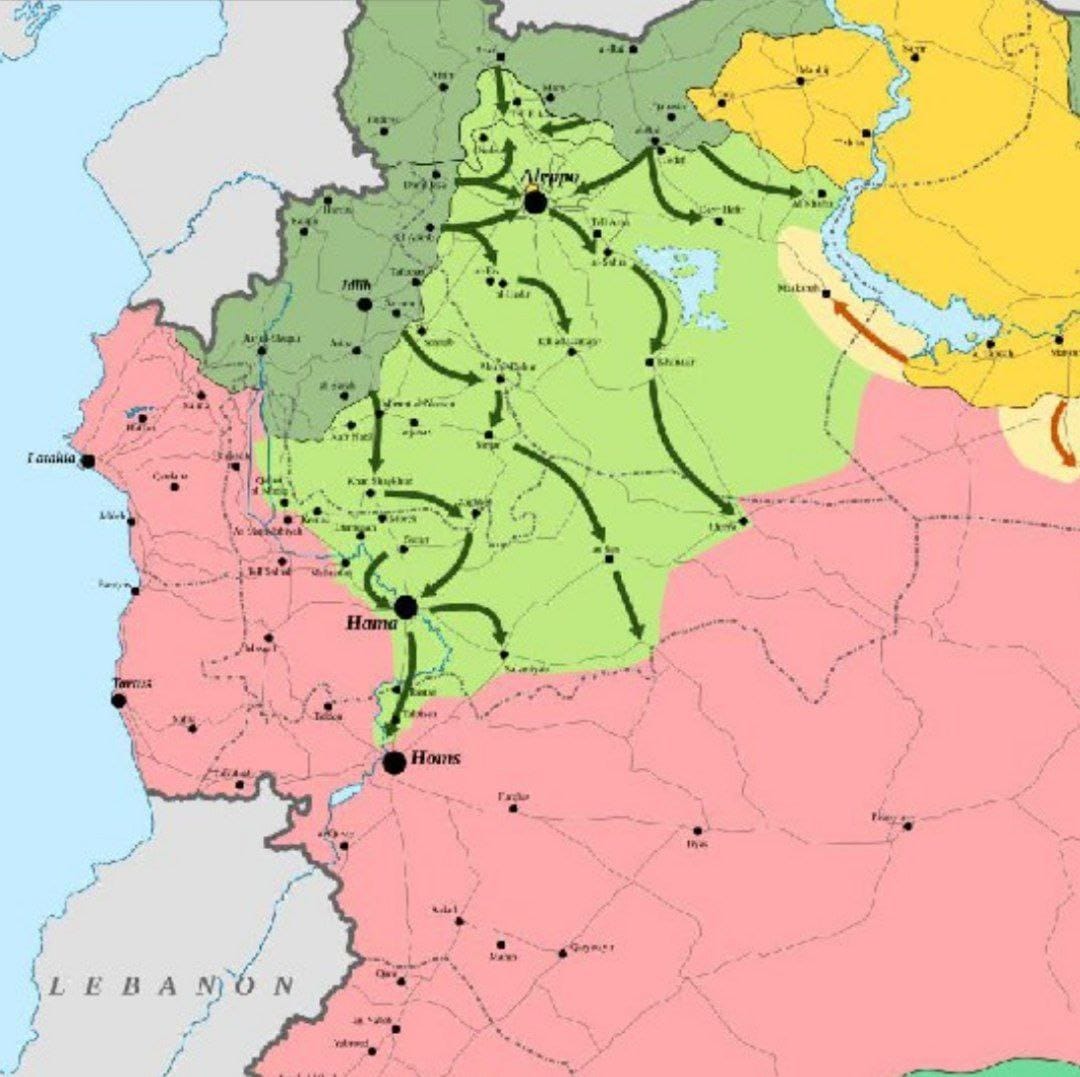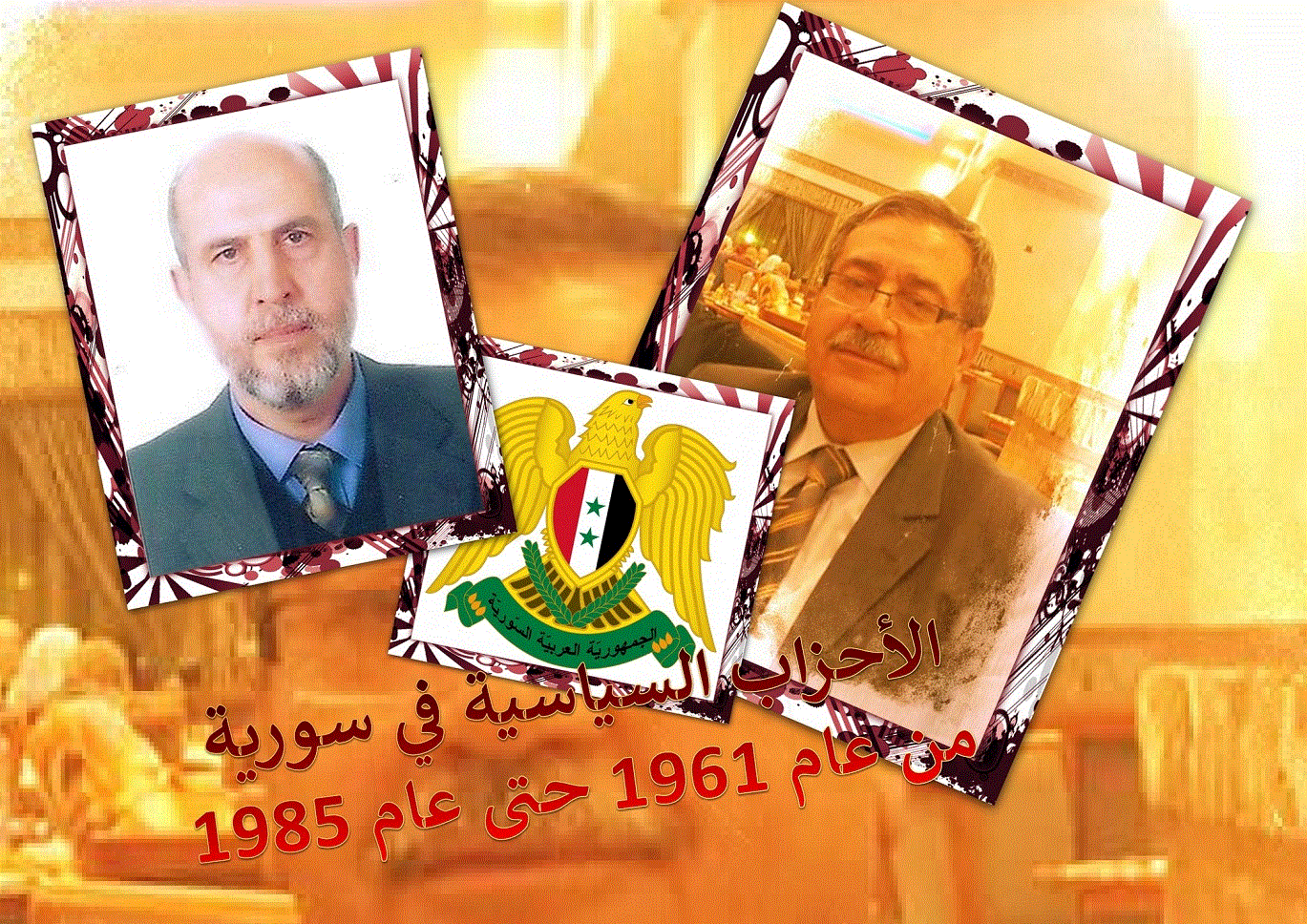رجاء الناصر ـ مخلص الصيادي
مايو 25, 2023
الحلقة الثامنة “البرنامج السياسي، وقفة حاسمة في حياة الحزب” 4/6
بنية الحزب
مما يلفت الانتباه، ويثير الجدل العميق. أن الحزب الشيوعي السوري حين عقد مؤتمره الثالث عام 1969 كان قد مضى على مؤتمره الثاني ستة وعشرون عاماً. قضاها الحزب دون أي مؤتمر. وهي ولا شك مرحلة طويلة، طويلة جداً بالنسبة لأي حزب، أياً ما كان موقعه على هذه الأرض.
وإذا كانت الفترة الزمنية وحدها ليست دليلاً كافياً على حاجة الحزب للمؤتمر، فإنها حين تسبح على هذا القدر من الامتداد، تغدو كافية بذاتها للتدليل على مدى الخلل في حياة الحزب، ويزداد هذا الدليل قوة وموضوعية حينما يخص الحزب الشيوعي السوري، ذلك أن سوريا على وجه التحديد قد مرت خلال سنواتها الست والعشرين التي أعقبت عقد الحزب لمؤتمره الثاني بأحداث، ومنعطفات، وتطورات، توجب على أي حزب أن يقف أمامها أكثر من مرة، وأن يراجع مسيرته، وينقدها، فيقوي عناصر الصحة فيها، ويشذب عناصر الضعف والخلل، وأيضاً فإن الحزب الشيوعي ذاته لم يكن خلال هذه الفترة الممتدة، هادئاً أو ساكناً، ولا كان بعيداً عن الأحداث، غير منفعل ومتفاعل معها. بل كان في قلبها، يدفع بها، أو يقف في وجهها، يتصادم، أو يتحالف.
عام 1943 كان المؤتمر الثاني للحزب، وفي عام 1969 عقد المؤتمر الثالث، ومن المهم أن نرصد الاتجاهات العامة للتطور في سوريا خلال هذه المرحلة، لنرى مقدار الحاجة الموضوعية لانعقاد أكثر من مؤتمر للحزب، ومقدار التجاوز الذي خلفه عدم عقد مؤتمر، وأثر ذلك كله في بنية الحزب، وفي خطه ومواقفه.
1ـ في العام 1946 استقلت سوريا عن الاستعمار الفرنسي، وما لبثت أن راحت تبحث عن طريق لها، للنمو، وللتحرر، وللتفاعل العربي، ووسط عملية البحث، ووسط تطاول تحالف الإقطاع مع الرأسمالية، برز دور الجيش، ودخلت سوريا دوامة الانقلابات العسكرية.
ومنذ اللحظة الأولى للاستقلال بدأت رياح الجذب للمحاور والأحلاف تهب على سوريا، فمن مشروع سوريا الكبرى، والهلال الخصيب، إلى معاهدات الدفاع المشترك. والنقطة الرابعة، وحلف بغداد.
ونمت تدريجياً القوة الجماهيرية، وفرضت نفسها على التحالف الرجعي الحاكم، وعلى السلطات العسكرية المتتالية. واستطاعت أن تعزز وتراكم تجاربها الديموقراطية، وإن تهز عبر نضالها حكم الديكتاتوريات العسكرية، وأن تفرض سياسة شعبية حمتها من الوقوع في مطب الأحلاف، والاتحادات المشبوهة، ودفعتها لإقامة نوع من التوازن في العلاقات الدولية. هيأ له بالإضافة إلى الجهد الشعبي الداخلي، الجو التحرري الذي شاع في المنطقة العربية بعد ثورة 23 يوليو 1952، وكان أحد عناوين هذا الوضع الاتفاقات العسكرية والاقتصادية التي عقدت بين سوريا والاتحاد السوفياتي في وقت مبكر عقب الاستقلال.
2ـ وكشفت تطورات الأحداث التي بدأت تتسارع مخطط الإمبريالية والاستعمار العالمي تجاه فلسطين والأمة العربية. فصدر عام 1947 قرار تقسيم فلسطين. وأعلنت الأمم المتحدة عام 1948 قيام “دولة إسرائيل”. على أرض فلسطين المغتصبة، ودخلت توازنات القوى السياسية السورية، والسياسة السورية محك التعامل مع هذه القضية، وقد فجرت في محكها هذا الكثير من المؤثرات، وإذا كان أبرزها موجة الغضب الشعبي والعسكري. الذي وجد متنفساً خاطئاً له في الانقلابات العسكرية المتتالية، فإنه جعل الموقف من هذه القضية أداة فرز، ونقطة علام، في الحكم على القوى السياسية، وفي تحديد اتجاه سوريا لمرحلة ممتدة من الزمن لا زالت جارية حتى الآن.
3ـ وفي هذه المرحلة تفجرت حركة الثورة العربية قومياً، وتمثل صاعق التفجير في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ذلك العدوان الذي جاء رداً على سياسات الثورة التقدمية: القومية التحررية، والذي اتخذ قرار تأميم قناة السويس مبرراً رسمياً له، وانهزم العدوان وقواه، وقامت في العام 1958 أول وحدة في التاريخ العربي المعاصر، وغيرت هذه الوحدة طبيعة وخريطة المنطقة العربية، فسقط حلف بغداد، والاتحاد الهاشمي، حينما استطاعت قوى النضال العربي أن تسقط حكم الملك فيصل وعبد الإله في بغداد، واهتز عرش الحسين في عمان، واستدعيت القوات البريطانية لحمايته، وأنزلت أميركا قواتها في لبنان حماية للرجعية الطائفية اللبنانية. واشتعل الوطن كله من المغرب فالجزائر حتى الأردن ولبنان تحت أعلام التحرر والوحدة، وتفجرت في العام 1954 الثورة الجزائرية لتنهي الوجود الفرنسي في الجزائر، ثم دخلت الأمة مرحلة نزاع مع رافعي شعارات الاشتراكية الرافضين للوحدة، وكان موقف الحزب الشيوعي السوري، ونظام حكم عبد الكريم قاسم في العراق هو البداية.
4ـ وفي هذه المرحلة أيضاً بدأت سوريا خطوات مهتزة وخجولة في اتجاه تأميم الملكيات الأجنبية والمرافق العامة، وبعض المؤسسات الوطنية، وازدادت هذه الخطوات ببطء دون أن تغير من طبيعة السلطة، والقوى المسيطرة حتى جاءت الخطوة الكبرى المتميز والمختلفة نوعياً التي وضعت سوريا على طريق التحول الاشتراكي. وذلك حين صدرت قوانين يوليو /تموز 1961 التي أممت الصناعات الكبرى في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة، الإقليم الشمالي (سوريا) والإقليم الجنوبي (مصر).
وردت الرجعية الداخلية، والعربية، وقوى الاستعمار على هذه الخطوة بالتآمر على دولة الوحدة، وفصل سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، مستفيدة من أخطاء وقصور سلطة دولة الوحدة، وكان من الطبيعي أن تكشف الرجعية بسرعة عن دواعي قيامها بفصل سوريا عن جسم الجمهورية العربية المتحدة، حدث ذلك حينما قامت تلغي التأميم، وتجهض قانون الإصلاح الزراعي، وتقيم علاقات تحالف وطيدة مع الرجعية العربية ممثلة بالنظام الأردني والسعودي. وبالنظام الشعوبي الديكتاتوري في العراق، وتعلن العداء لكافة حركات التحرر العالمية، وتتخذ موقف الحذر والترقب من الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية، وتقيم علاقات تحالف وتعاون واضحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية، وتلقى التفهم الكامل من الكيان الصهيوني.
5ـ وفي هذه المرحلة تغير وضع الاتحاد السوفياتي في المنطقة العربية، فلم يعد ذلك العدو الذي تعقد لمواجهته الأحلاف، ولا الدولة التي تحاول أن توجد لها موطئ قدم في هذه المنطقة الحساسة، وإنما تحول إلى قوة فاعلة تؤثر في مجريات الأحداث كلها، وإذ جاء هذا – في بعض منه – نتيجة المواقف المناصرة لقضايانا التي جعلها الاتحاد السوفياتي خطاً ثابتاً. فإنه في الأصل صدى لحركة الثورة العربية، وتجاوباً مع اتجاهاتها الرئيسية.
إن كسر احتكار السلاح لم يكن مؤشراً لدخول السلاح السوفياتي للمنطقة العربية، فقد كان هذا – رغم مكانته – أقل الأشياء أهمية من المنظور التاريخي. وإنما كانت هذه المعركة إيذاناً بانتهاء احتكار الغرب الاستعماري لشؤون المنطقة العربية، وعلامة حاسمة على اتجاه تلك الإرادة. وجاءت معركة السويس وبناء السد العالي ليؤكد هذا المعنى بوضوح وجلاء. وإذ بدا أن النفوذ الاستعماري الغربي يطارَد في الأرض العربية، وأن عروش الملوك، وقصور الرجعية العربية تهتز، وأحلاف الغرب تتهاوى، فإن هذا كله كان صدى للتحول العظيم الذي عاشته هذه الأمة مع ثورة يوليو، وأعطى آثاره في إفريقيا وفي آسيا، وحتى في أمريكا اللاتينية.
6ـ ولعل أكثر التغييرات دلالة وعمقاً من المنظور الشيوعي، ذلك التغيير الفكري الذي جعل مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفياتي – وهو الحزب الأم للأحزاب الشيوعية الأخرى – تتحدث عن طريق التحول اللارأسمالي، عن إمكانية دخول ميدان الاشتراكية عن غير طريق الحزب الشيوعي. وبغير قيادة الطبقة العاملة، ومن غير تحقيق ديكتاتوريتها.
ولم يأت هذا التطور نتيجة دراسات نظرية وفقهية وإنما نتيجة تغييرات اجتماعية جارية على الأرض. وتقودها قوى سياسية غير شيوعية. ولعل أهم هذه التجارب التي فتحت الأعين على هذه الحقيقة، وأهم الإجراءات هي تلك التي كانت تقوم بها الثورة العربية. والتي عبرت عن نفسها نظرياً بميثاق العمل الوطني. هذه الوثيقة التي وصفها العلماء والسياسيون السوفيات بأنها “برنامج وطني ديموقراطي يمكن تسميته بمجمله طريق التطور اللارأسمالي”.
7ـ ومنذ 28 أيلول 1961. تاريخ الانفصال الرجعي عاشت سوريا حركة تمرد شعبي مستمرة، ودموية، لم تهدأ أبداً، حتى العدوان الإسرائيلي عام 1967. “استمرت بعد ذلك وإن بأساليب مختلفة، وكان وقود هذه الحركة باستمرار العمال، والطلاب، والضباط والجنود الثوريون. ورغم إجراءات التصفية للعسكريين إبان الانفصال الرجعي، وبعد حركة 8 آذار سنة 1963، ورغم العنف الدموي الذي ووجهت به هذه التحركات، والتي جاءت أحداث 18 تموز 1963 قمة لها، فإن الحركة الشعبية لم تهدأ، واستطاعت أن تفرز القوى السياسية والاجتماعية السورية إلى اتجاهين متضادين. تماماً كما عبر مشروع البرنامج السياسي:
- اتجاه انفصالي، رجعي أياً ما كانت الشعارات، والرايات التي يرفعها.
- واتجاه وحدوي تقدمي.
وكان الفيصل بين الاتجاهين الموقف من الوحدة العربية، وليست الوحدة في هذا المعيار شيئاً مجرداً، وإنما كانت تعني بالتحديد، الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة، الدولة العربية المركزية التقدمية، القومية، التي تقف على رأسها قيادة ثورية من طراز فريد.
وفي جو هذا النضال سقط الانفصال الرجعي، ودفعت الجماهير باتجاه الوحدة، فكان “ميثاق الوحدة الثلاثية”، الذي ما لبث أن سقط نتيجة أوهام “الانفصاليين – التقدميين” في إمكانية بناء وحدة ضد الحركة التاريخية التي كانت تجسدها مصر بقيادتها الثورية. وما لبث القوة السياسية “البعث” التي اندفعت خلف هذا الوهم أن بدأت بالتمزق، وبالتناحر الداخلي. مما أدى في سوريا إلى انقلاب 23 شباط /فبراير 1966.
8ـ وقد اختتمت هذه الفترة بالعدوان الإسرائيلي على الأمة العربية في 5 حزيران سنة 1967، وهو العدوان الذي أريد منه أن ينهي وجود الثورية العربية، وأن يكسر مرة واحدة إرادة التحرر العربي، وأن يعيد المنطقة إلى الأسر الإمبريالي تماماً كما كان عليه الحال قبل ثورة يوليو، ولكن باختلاف الوسائل، وباختلاف مميزات القوة الأمريكية الإسرائيلية.
هذه ملامح التطورات، والأحداث التي مرت بها سوريا، وواضح أن حزباً سياسياً مسؤولاً وعقائدياً مدعو حتماً إلى عقد الكثير من المؤتمرات يقف من خلالها على دلالات هذه الأحداث، ويرسم عبرها خطه السياسي، وحركته العامة، والمرحلية، ويعالج بنيته التنظيمية وفق آثار هذه المتغيرات عليها، ويستطلع اتجاهات الرأي في الحزب تجاهها. ولعل سلوك الحزب الشيوعي السوري. ومواقفه خلال هذه المرحلة الممتدة، كانت تقتضي – أكثر من أي سبب آخر – عقد مثل هذه المؤتمرات، نقول هذا لأن الحزب لم يستطع أن يحافظ على موقف متماسك تجاه هذه التطورات، ولا أن يقيم سياساته على أسس واضحة، فقد انتقل من الشيء إلى نقيضه، ومن الموقف إلى الموقف المضاد من ذات المسألة، في القضايا المبدئية والاستراتيجية، كما في المسائل التكتيكية. والمتتبع لتاريخ الحزب، أو للحوارات والمداخلات التي أجريت حول البرنامج السياسي يعرف ذلك معرفة يقينية:
فمن موقف معارض لتقسيم فلسطين، إلى موقف مؤيد له “كلمة ظهير عبد الصمد”.
ومن موقف ملتزم بالخط السوفياتي إلى خروج على هذا الخط في مسألة رئيسية لها علاقة فيما يجري على أرضنا هي مسألة طريق التطور اللارأسمالي والموقف من الجمهورية العربية المتحدة “خالد بكداش، وظهير عبد الصمد”.
ومن عداء للرجعية، إلى تحالف معها ضد الوحدة، وضد التأميم، وضد الإصلاح الزراعي “ظهير عبد الصمد”.
ومن موقف يعتز بالقومية العربية ويلتزم بها، إلى موقف ينكر وجود الأمة العربية كأمة مكتملة التكوين “خالد بكداش، بدر الطويل”.
ومن موقف وحدوي واضح قبل إبرام الوحدة إلى موقف انفصالي واضح عقب الوحدة، وعقب الانفصال أيضاً.
ومن موقف يرى الصهيونية شراً كاملاً، إلى موقف يعارض تصفية المؤسسات الصهيونية ويتبنى عملياً وجود “إسرائيل” “خالد بكداش، أحمد فايز الفواز”.
وما كان لهذه المواقف أن تأتي على هذا النحو من التناقض، والتضارب، لو أن الحياة الحزبية الداخلية سليمة، لو أن مؤتمرات الحزب جارية، ومستقرة، لو أن مؤسسات الحزب، ومواقعه القيادية آتية، عبر الانتخاب، وعبر مصافي المؤتمرات، حيث النقد والنقد الذاتي، وحيث ضرورة أن تعكس هذه المؤتمرات الاتجاهات العامة لحركة القاعدة الحزبية، ولرؤيتها.
إن الاتجاهات التي ظهرت في المؤتمر الثالث، والتي انتظمت كغالبية حول البرنامج السياسي، تتيح لنا أن نفترض أنه لو كانت الحياة الحزبية سليمة، لأمكن للحزب الشيوعي السوري أن ينأى بنفسه عن كثير من المواقف الخاطئة التي وقع بها. وأن يلعب دوراً إيجابياً فعلياً ومؤثراً في اتجاهات التطور التي مرت بها سوريا.
ولا يجوز أن يخطر على بال أحد أن عدم انعقاد مؤتمر للحزب عبر تلك الفترة الطويلة كان بفعل أجواء ضغط أو إرهاب، عاشها الحزب، فإن هذا الخاطر غير صحيح البتة، إذ بتجاوز سنوات الوحدة التي لم تصل إلى أربع سنوات، وضع فيها الحزب نفسه في مواجهة فكرة الوحدة ودولتها، فإن بقية تلك الفترة البالغة اثنين وعشرين عاماً، كانت بالإجمال فترات راحة واستقرار له.
لقد كان الامتناع عن عقد مؤتمر للحزب، موقفاً مباشراً من قيادات الحزب، موقفا ليس له أي مبرر، وكان من نتيجته أن حققت قيادته سيطرتها الكاملة، على مواقع التشريع والتنفيذ في الحزب، فصنعت اللجنة المركزية تدريجياُ على الهيئة التي ظنت أنها تحقق تبعيتها للقيادة، وأخضعتها نتيجة قرارات التعيين والإضافة لعضويتها للهيمنة المباشرة لها، ولم تكن القيادة جسماً واحداً يتحمل مسؤولية العمل، وإنما انفرد فيها “الأمين العام” ليكون في الموقع المميز في الحزب، وليمارس دور السلطة العليا على كل الحزب.
إن الرسالة التي وجهها المكتب السياسي المنتخب عقب المؤتمر الثالث وقبل حدوث الانقسام تكشف لنا دواعي عدم عقد مؤتمر للحزب، كما تكشف عن الأوضاع الشاذة التي خلفها هذا الوضع على بنية الحزب، وعلى سياساته. يقول المكتب السياسي في رسالته:
“وخلال السنوات العشر الأخيرة ظهرت بعض الأصوات التي تطالب بعقد مؤتمر للحزب، ولكنها أهملت، وكان من المفروض أن تستجيب الهيئات المسؤولة لمثل هذا الطلب المشروع خصوصاً بالنسبة لحزب كحزبنا مضى على مؤتمره السابق ستة وعشرون عاماً.
إن الأسباب الحقيقة وراء مثل هذا الموقف هو الحذر من مراجعة الماضي على أساس الانتقاد والانتقاد الذاتي، والتشدد أمام تقديم الكادرات، بالإضافة إلى اعتماد الأساليب القديمة. ولذلك ورد في تقرير اللجنة المركزية في هذا الموضوع ما يلي: “ولا شك أن عدم عقد المؤتمر ليس صدفة، وإنما هو خطأ كبير، طبع الحزب بطابعه طوال فترة طويلة من الزمان، وسببه الرئيسي هو الخوف من الانتقاد، والانتقاد الذاتي، والثقة المبالغة بالنفس، وبإمكان تجنب الأخطاء”.
ثم توضح الرسالة أثر غياب المؤتمر على بنية الحزب، وعلى خطه السياسي فتقول:
“أدى ذلك عملياً إلى خرق العمل الجماعي، ومبادئ المركزية الديموقراطية، وعدم احترام الهيئات الحزبية، كما أدى إلى ضعف دور اللجنة المركزية، وخاصة أن أكثر أعضائها لم ينتخبوا انتخاباً، وإنما جرى تعيين بعضهم من قبل المكتب السياسي، كما أدى إلى وصاية المكتب السياسي على اللجنة المركزية، وبروز العمل الفردي والإداري، وحلولها أحياناً محل الهيئات، والعمل الجماعي … وتبني بعض المواقف الفكرية والسياسية غير الصحيحة خلال فترة من الوقت، كموقفه من التأميم أيام الوحدة، وفي مرحلة الانفصال مثلاً”.
هذا المكتب السياسي، الذي أصدر رسالته، وهذه اللجنة المركزية، قومت الوضع الداخلي للحزب حين كان “خالد بكداش” ما زال يتمتع بموقع الأمين العام بينما كان الانقسام لم يحدث بعد، لم يأته صاعق التفجير …
أما وقد تفجر الوضع بعد ذلك. فإن الأمين العام يرفض كل هذه التحليلات، والتقويمات للوضع الداخلي، ولا يرى مواقف غير صحيحة للحزب، سياسية، وفكرية، ويشن حملة عنيفة على أولئك الذين ينقدون هذه الأوضاع معتبراً أنهم بنقدهم هذا “يسودون تاريخ الحزب” يقول خالد: “في حزبنا الشيوعي السوري لم يكن الانضباط نتيجة أساليب فردية، ولا أساليب ديكتاتورية كما يقول البعض! كلا! بل كان هذا الانضباط نتيجة تطور تاريخي برهن صحة مواقف الحزب الأساسية في معظم المسائل الكبرى، والانعطافات الكبرى التي جابهتها بلادنا، وقرارات المؤتمر الثالث لحزبنا تؤكد هذه الناحية بوضوح كامل. وبكل إخلاص وكل صراحة أقول أيها الرفاق، ما دام الانضباط الحزبي كما يعلمنا لينين، وكما تدل التجارب بما فيها تجربة حزبنا، يتكون تاريخياً. أفلا ينتج من ذلك أن كل تشويه، وكل تسويد لتاريخ الحزب لا بد أن يؤدي إلى ضرب هيبة الحزب، وضرب الانضباط الحزبي وهلهلته”.
في مقابل هذا الموقف يتقدم “بدر الطويل” في اللقاء نفسه الذي يتراجع فيه خالد بكداش ويرفض تقييمات المكتب السياسي واللجنة المركزية، يتقدم ليكشف الفارق الجوهري، بين النقد والتسويد، بين نقد فرد أو قيادة، وبين التشهير بتاريخ الحزب، بين رؤية الحقائق كما هي والجرأة في مواجهتها، وبين الالتفاف عليها ومحاولة إخفائها. يقول الطويل:
“إن مراجعة الماضي وتقييمه هي عملية ضرورية في كل مرحلة معينة من الزمن وليست مؤتمرات الحزب إلا شكلاً جدياً لهذه المراجعة المبدئية، فالمراجعة النقدية لا تهدف ضرورة إلى رؤية الجوانب السلبية فقط، بل هي محاولة لرؤية السلب والإيجاب في العملية … فتقييم تاريخ حزبنا ضروري بعناصره الثلاثة: رؤية الجوانب الإيجابية، ورؤية ودراسة المواقف السلبية والخاطئة، ثم استخلاص العبر من الموجهين …
وإذا حدث وساهم فرد من الأفراد أكثر من غيره في صياغة العديد من المواقف الإيجابية، وليس مستبعداً أن يكون قد حصل في حزبنا بالنسبة للعديد من الأفراد ـ والإشارة إلى ذلك ضرورية عند تقييم الماضي ـ فلماذا لا يتمتع هذا الرفيق بقدر مرموق من الجرأة، والتواضع ليشير إلى دوره في صياغة المواقف الخاطئة! ومعروف أنه إذا هو لم يفعل ذلك بمحض إرادته فإن الحزب سيقيم بصورة صحيحة مواقفه، ومسؤوليته، ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك عاجلاً أم آجلاً”.
إن الطويل “يحاول الاقتراب الحذر من الوضعية الخطرة التي عاشها الحزب فترة طويلة من الزمن، وحذره هذا منبعه أن “الآخرين” لم يكونوا قد حسموا وضعهم بعد وكان الأمل لا يزال يراود قيادة الحزب ومؤسساته في تجاوز الأزمة، أما وقد خرجت الأقلية على إرادة الحزب، وأصدرت بيانها الانشقاقي في 3 نيسان / إبريل، فإن أحمد فايز الفواز يتولى وضع النقاط على الحروف في هذا الجانب. فيقول:
“إن عبادة الفرد – كعقلية وممارسة، كمدرسة في الفكر والسياسة والتنظيم – هي السبب العميق في ارتكاب الأخطاء الكبرى، والمواقف السياسية والفكرية – التي أوردت أمثلة عنها – مسؤول عنها الأمين العام للحزب نفسه، وليس هيئات الحزب القيادية. وبحكم ممارسة الرفيق خالد للأمانة العامة في الحزب خلال خمسة وثلاثين عاماً، وبأساليب عبادة الفرد، فإنه منع انعقاد مؤتمرات الحزب، وصياغة البرامج السياسية، وألغى النظام الداخلي وأحل إرادته الذاتية محله، جاعلاً إياها قانون حياة الحزب”.
بعيداً عن كل الصراع الذي تفجر حول البرنامج السياسي، والذي كشف بوضوح كل الإشارات والإيماءات التي أتت عليها الوثائق الرسمية للحزب، نستطيع القول إن الحزب نفسه، من خلال وثائقه الرسمية، قد شخص المرض الذي وقع فيه، عبر ربع قرن من الزمن، منذ المؤتمر الثاني، وحتى المؤتمر الثالث، واختصرها بأن الآلية الحزبية كانت معطلة تماماً. فالأنظمة، والقوانين، والنظام الداخلي كانت في إجازة كاملة، وكان الاعتماد يجري على فرد أخذ موقع ومكانة مؤسسات الحزب، ومثل باستمرار عقل الحزب وإرادته، وحدد له مواقفه وقراراته السياسية.
وإذا كان هذا الوصف يصيب فرداً بعينه فإنه أيضاً يصيب قيادته كلها بشقيها “المكتب السياسي، واللجنة المركزية”. فلولا ضعف هذين الموقعين لبقي دور هذا الفرد ومكانته، في الإطار المطلوب والمرغوب فيه.
وإذا كان كشف هذا الخلل يثير الكثير من النقد على مسيرة الحزب، فإن قدرته الذاتية على تحديد هذه الأمراض، وتشخيصها، والوقوف لمواجهتها بمثل الحزم والصراحة التي كشفت عن نفسها، تعطي الحزب أكثر مما تأخذ منه، وتجعل إيجابياته مرجحة بتفوق على سلبياته، وتدل على مقدرة ذاتية على التجدد، ولولا حركة الانشقاق لكان الدرس أعمق حيث الحزب لم يستطع أن يقوم مسيرته فقط، وإنما قوم أخطاء الأفراد دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاطهم. بل هو عزز مواقعهم لكن في اتجاه الممارسة الصحيحة، وبعد التقويم الصحيح.
إن حركة الانشقاق لم تطعن في هذا الدرس، وإنما كشفت عن حالة عجز الأفراد عن تقبل الأوضاع الجديدة في الحزب.