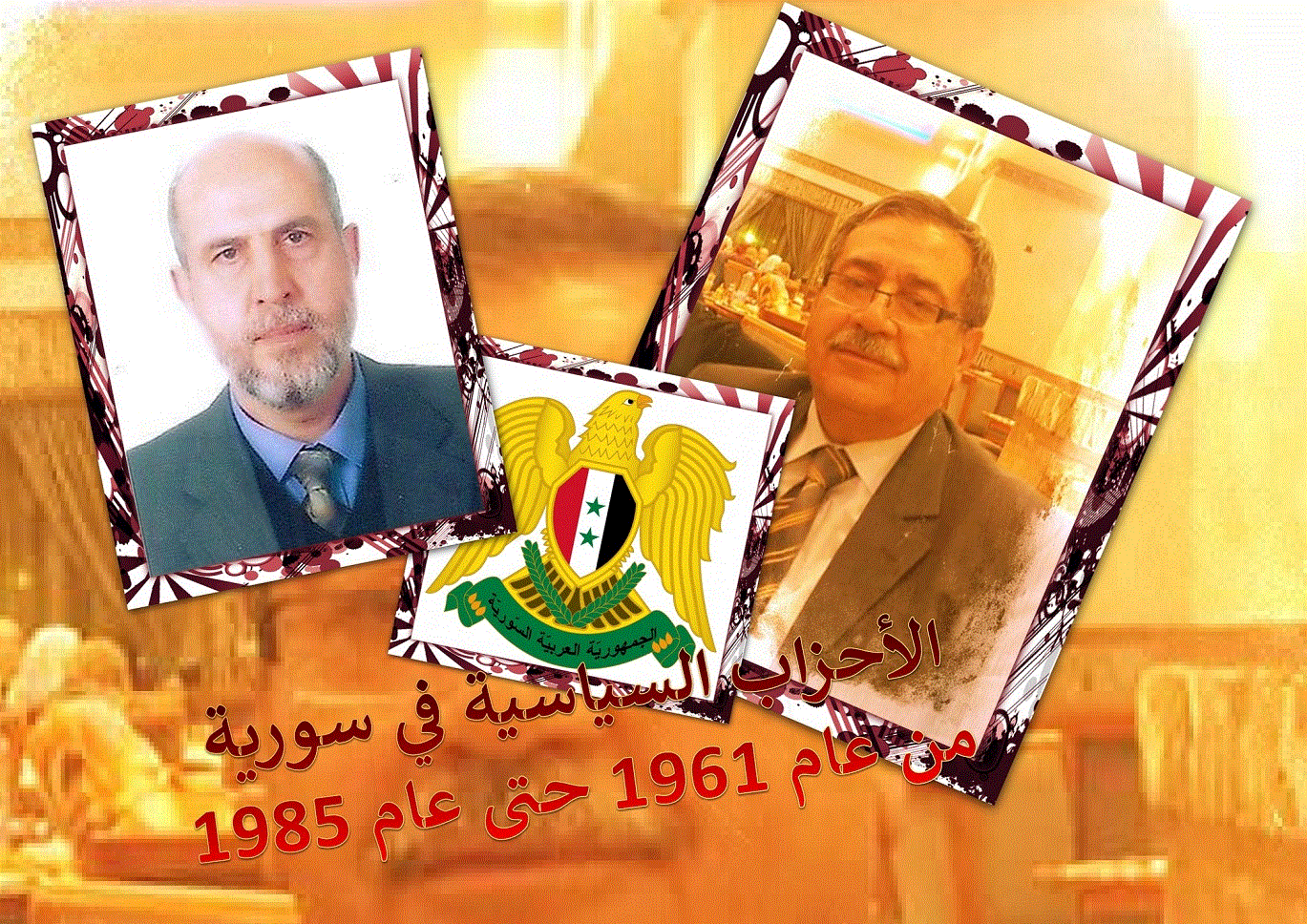بقلم أ. رجاء الناصر
الحلقة الثانية
البحث الأول:
الخلافة والقيام على الخليفة بين الفقه والواقع، ونعرضه في خمس حلقات
أولا: الخلافة والقيام على الخليفة في الفقه الإسلامي 1 / 5
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “…. قالَ أعجزتُم إذ بعثتُ رجلًا منْكم فلم يمضِ لأمري أن تجعلوا مَكانَهُ مَن يمضي لأمري “؟ (مسند الامام أحمد وأبو داوود)
مدخل عام
مسألة الخلافة، وأسلوب الحكم، قضية حيوية لدى المسلمين على امتداد تاريخهم، وهي مثار جدل عنيف وصراعات شديدة، ابتدأت منذ انتقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى – وقبل دفن جثمانه الطاهرـ. واستمرت إلى انتهاء عهد الخلافة الإسلامية، بنهاية حكم آل عثمان في منتصف القرن الرابع عشر الهجري.
أخذت الأزمة ملامحها الأولى في “سقيفة بني ساعدة” (1)، فقد برز خلاف حول أسلوب إدارة شؤون المسلمين – بعد غياب الرسول القائد-، وحول قواعد اختيار أمير المسلمين.
هذه كانت أولى القضايا التي تطرح في هذا الاجتماع، فقد طرح الأنصار خيارين:
الأول: مبايعة سعد بن عبادة كبير الخزرج أميرا على المسلمين.
الثاني: توزيع السلطة بين أمير قرشي من المهاجرين، وأمير من الأنصار.
أما المهاجرون فقد كانت لهم رؤية أخرى، انطلقت من إصرارهم على وحدة الإمارة تعبيرا عن وحدة الأمة، و كان حرصهم على وحدة الأمة قد دفع بعضا من كبار الصحابة للمسارعة إلى السقيفة (بني ساعدة) وجثمان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يسج بعد في مرقده الأخير، كي يمنعوا الأنصار من مبايعة أمير منهم، مما يفتح الباب واسعاً أمام احتمال صدام يفرق الأمة، وقد أصر المهاجرون المتواجدون في السقيفة على وحدة الأمة، وعبر عن هذا الموقف بوضوح عمر بن الخطاب حين ردّ على مقولة الحباب بن منذر الأنصاري: “مناً أمير ومنكم أمير”، بعبارة حاسمة قاطعة:
“هيهات أن يُجمَع اثنان في قرن”، وفي راوية أخرى: “لا يَجتمعُ سيفان في غمد”.
ورأوا أن وحدة الأمة لا تتوفر إلا بتوفر عاملين اثنين: شرع الله ورسالة نبيه التي تركها بينهم، والسلطة الدنيوية الممثلة في السلطة التنفيذية المتمكنة من مظاهر القوة.
في الجانب الروحي/ الديني لم يتبادر إلى أذهان المجتمعين أي خلاف، أما الجانب الدنيوي فقد طرح المهاجرون منطقهم على لسان عمر أيضا حين قال: والله لا ترضى العرب أن يُؤَمِّروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم، وَوَلِيُّ أمرها منهم، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته، ونحن من أوليائه وعشيرته، إلا مدل بباطل، أو متجانف لإثم ومتورط في هلكة.
على ضوء هذه القاعدة -وحدة الأمة- انصاع الأنصار بعد أخذ ورد، وهرج ومرج، وعَبَّرَ عن مبررات هذا الانصياع بشير بن سعد “أبو النعمان”، وهو من عشيرة مرشح الأنصار للإمارة، سعد بن عبادة، حين قال:
“ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحق به وأولى، وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداً، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم” (2).
ومن جهة أخرى مثل اجتماع السقيفة، وما دار فيه من جدل وحوار انتهى إلى توافق المجتمعين ـ أوأغلبيتهم الساحقة – شكلاً من أشكال الشورى التي طالما أكد عليها الشرع الإسلامي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم (3).
والجدل والحوار كانا يدوران حول رؤية المجتمعين عما هو الأنسب لمصلحة المسلمين، ولم يكن الحوار حول تنظيرات فقهية شرعية مجردة.
والقضية الثانية التي أبرزها اجتماع سقيفة بني ساعدة وما تلاه أن المجتمعين نظروا إلى الإمارة نظرة اختلطت فيها المصالح الدنيوية بالمصالح الأخروية: فأمير المسلمين يقوم على المجتمع كما يقوم الملوك والسلاطين، ولكنه في الوقت نفسه مقيد بشريعة ودستور سماويين ليس له أن يخرج عليهما، أو أن يمد عينيه إلى غيرهما من الدساتير والشرائع السماوية أو الوضعية.
إنه يخضع لهذا الدستور كما يخضع له المسلمون جميعا، وهو ينزل عند حكم الشريعة كما ينزل عندها المسلمون جميعا، ليس له إلا ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، ليس له أن يُحِلَّ حراما، أو يُحَرِّمَ حلالا مما جاءت الشريعة بحله أو حرمته، كما أنه ليس للخليفة أن يضع للمجتمع الذي يقوم عليه، تشريعا لحياته الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية يخرج عن المبادئ العامة التي جاءت بها شريعة الإسلام.
وعلى هذا فإن الجدل الذي ثار حول وجوب الخلافة هل وجبت بالعقل أم بالشرع ؟ وانصراف طائفة إلى القول:
“إنها وجبت بالعقل لا بالشرع لما في طبع أصحاب العقل السوي من البشر من التسليم بوجود سلطة تقوم بتنظيم شؤون الرعية وفرض الجزاءات”، وانصراف طائفة أخرى إلى القول: “بأنها وجبت بالشرع دون العقل لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان جوزا في العقل ألا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن المظالم والتقاطع.. ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليًه في الدين ” (4). ويستند هؤلاء إلى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) .. [النساء59] ،
ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا، وهم الأئمة المُتَأَمِّرُون علينا (5).
إن مثل هذا الجدل لم يكن له حضور في تلك المرحلة، وهو يبقى دونما معنى حين نفهم أن الشرع ليس بعيدا عن العقل، ولا عن مصالح البشر، فالشرع الإسلامي هو نظام دين ودنيا، إذ أن نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل اليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والسكن والأقوات. والأمن هو آخر الآفات، ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الاحوال بل في بعضها، فلا ينتظم جميع وجوه الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان يمضي أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوته من الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل، وهما وسيلتان إلى سعادة الآخرة.
إذن فإن نظام الدنيا -أعني مقادير الحاجة- شرط لنظام الدين (6)، وإن ولاية الناس من أهم واجبات الدين، بل لا يقام الدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماعهم، لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع إلى “رأس”، وهذا يستند إلى حديث رسول الله ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم). ومن هذا يتضح أن الإمامة أي الخلافة أو إمارة المسلمين (7)، متوجبة شرعا وعقلا بآن واحد وهي قضية موضوعة في الأصل لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ” (8).
والقضية الثالثة تتعلق بطبيعة اختيار الإمام أو الخليفة، فلقد ثار اللغط والجدل حولها، ففريق، وهم أهل السنة والجماعة ومعظم أهل الفرق ماعدا الشيعة، قالوا: أن طريق عقد الإمامة في هذه الأمة الاختيار لمن يرونه الأقدر على تحمل أعبائها، لا فضل لأحدهم على آخر إلا بتوفر الأهلية فيه لأداء واجبات هذا المنصب، واتفاق أغلبية المسلمين، أو أهل العقد والحل فيهم على توليه هذا المنصب.
وفريق آخر وهم الشيعة وقفوا على النقيض تماما، حين اعتبروا أن حراسة الدين تتضمن شيئا من معاني النبوة، وتقتضي العصمة عن الخطأ، وهي بهذا ليست محل اختيار البشر الذين قد يخطئون في الاختيار، ولا يعقل أن يترك الله ورسوله هذا الأمر دونما تحديد، فالإمامة محددة سلفاً وبالاسم لـ “علي بن أبي طالب” يخلفه فيها أئمة من نسله.
وبين النص والاختيار دار آخرون فنزع بعضهم إلى تحديد الاختيار في أقوام معينين سواء من قريش أو من بعض أفخاذها، واختلف آخرون على تحديد الأئمة المعصومين فيمن يقولون بالنص على الإمامة.
والصراع الدائر منذ اختيار الخليفة الأول أبي بكر الصديق، وتشتت آراء الصحابة بين مؤيد لاتجاه معين أو لآخر، ولخليفة محدد أو لغيره، ولأسلوب بعينه في اختيار الخليفة ومبايعته، يشير بشكل واضح إلى أن الأمر متروك للمسلمين في اختيار ما يرونه ملائماً لهم، ولولا هذه الحرية لما اختلف الصحابة، ولما تباينت آراؤهم كل هذا التباين، ولما تصارع بعضهم، وسمح لنفسه بإهدار دماء المسلمين بالباطل.
إن قاعدة “تبدل الأحكام بتغير الزمان” تنطبق تماماً على هذه القضية التي تحكمها رؤية المسلمين لمصالحهم إذ يسود قول الفقهاء: “حيث المصلحة فثمة شرع الله”.
وضمن هذا السياق يقول ابن القيم الجوزية: “إن الشريعة مبنية على مصالح العباد في المعاش والمعاد.. فمبناها أساسها على الأحكام، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها…وفيها نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس… ثم يطابق بين هذا وهذا.. فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع…. فالمفتي والحاكم والعالم من يتوصل بمعرفة الواقع، والتفقه فيه، إلى معرفة حكم الله ورسوله” (9).
القضية الرابعة تتعلق بالقيام على الخليفة، و”الثورة” على سلطان المسلمين، وهي بدورها قضية شديدة التعقيد، إذ أن معظم أقوال علماء المسلمين تنصرف إلى نبذ الخروج، بينما يعج تاريخ المسلمين بالثورات والانتفاضات التي شارك بعض الصحابة وكبارهم فيها ضد الملوك والخلفاء والأمراء، ومن أجل المطالبة بالخلافة والإمارة، مما يقتضي منا الإمساك بخيوط العلاقة بين آراء العلماء، وبين المواقف العملية للعديد من الصحابة والتابعين، خصوصاً أن الخروج والثورات لم تقتصر على طائفة من المسلمين معينة بذاتها، ولا على إتباع مذهب محدد، وإنما جاءت لدى معظم الطوائف الإسلامية وإن غلب لدى بعضها القيام على ولاة الأمور “بغي وثورة عند البعض….”و”جهاد عند آخرين”، وبين الفتنة وبين الجهاد، تتشعب الطرق والمسالك، وتتبرز المصالح الدنيوية متسترة حيناً بتأويلات فقهية، وتبرز أيضا اجتهادات متضاربة يصعب فهمها ما لم توضع في إطارها المجتمعي والتاريخي، إطار برز واضحا لدى جميع المتصارعين، تركز لدى الكثيرين منهم على مصالح الأمة الدينية والدنيوية، وتغلبت فيه قاعدة اختيار أفضل الحلول، وأهون الشرور، وهذه القضية -ستكون الموضوع الرئيس في البحث- محاولين الوقوف عندها، واستخلاص مواقف المذاهب الإسلامية المختلفة منها، هادفين من كل ذلك إلى فهم الخلفية الفقهية لتلك القضية التي تؤرقنا جميعاً، ونحن نشهد وندعو لصحوة يراها بعضنا عبر جهاد وثورة، ويراها آخرون عبر تبشير ودعوة.
بعد هذا التقديم العام سنتناول بالبحث مسألتين:
المسألة الأولى: تتناول الإمامة والخلافة في الإسلام، حيث نتعرض الى بعض المواقف العملية من هذه المسألة، قبل أن نقف على طبيعة الامامة والخلافة وشروط انعقادها ومهام الخليفة وواجباته وما يتوجب له من طاعة.
المسألة الثانية: تتناول قضية الخروج على الخليفة والسلطان عند اهل السنة والجماعة، ثم عند الفرق لأخرى.
يتبع / حلقة 3
الهوامش
- على الأثر من وفاة الرسول اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لترشيح أحدهم لإمارتهم، وسمع بذلك بعض الصحابة من المهاجرين فلحقوا بهم كي لا ينفردوا بالأمر (مسند الامام أحمد 368ـ375).
- تراجع تفاصيل اجتماع سقيفة بني ساعدة في تاريخ الطبري، طبعة دار المعاف المصرية ،١٣٤٠، ص ۲۱-۲۲، أيضا: 3 ـكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، ص ٤، وأيضا ابن خلدون المقدمة.
- قال الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم/ الشورى 38) – (وشاورهم في الأمر/ آل عمران159
- الأحكام السلطانية للماوردي (ص4)
- توجد تفاصيل المواقف ومراجعها فيما يلي من أقسام البحث5
- أبو حامد محمد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص214
- استخدم المسلمون الاصطلاحات الثلاثة بمعنى واحد، لمزيد من التفصيل تُراجع مقدمة ابن خلدون
- الماوردي ـ الاحكام السلطانية ص48
- ابن القيم ـ أعلام الموقعين ص39