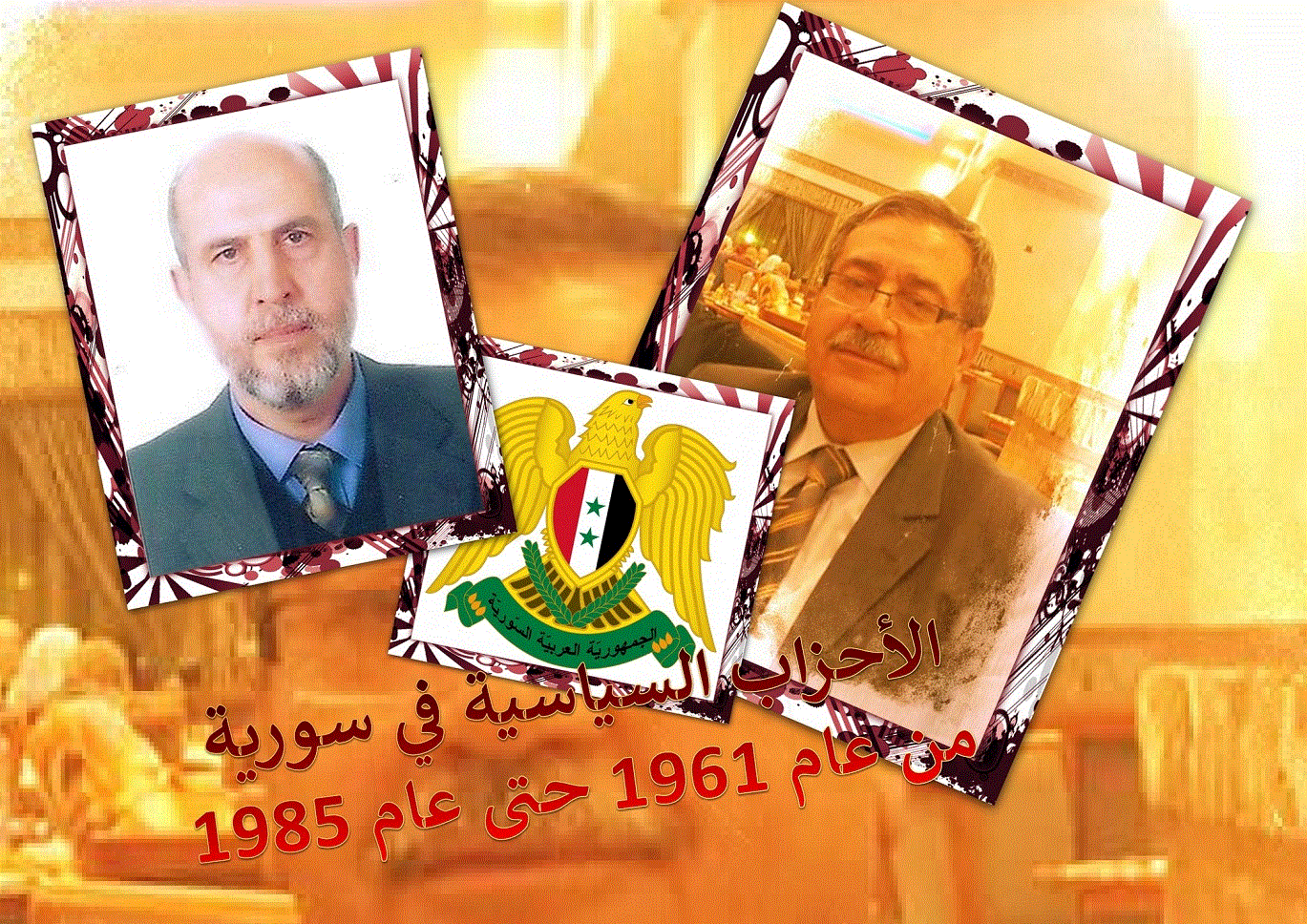رجاء الناصر ـ مخلص الصيادي
يونيو 4, 2023
الحلقة السادسة: الإخوان المسلمون ـ محاولة تفسير 2/6
محطات رئيسية في تاريخ التنظيم في سوريا
يعتبر العام 1945 تاريخ الولادة الحقيقية للإخوان المسلمين في سوريا، حينما قام الدكتور مصطفى السباعي من موقعه كمرشد عام بعملية دمج الجمعيات الإسلامية المختلفة تحت لواء جمعية ” الاخوان المسلمين”.
منذ ذلك التاريخ وحتى العام 1965 فإن الإخوان المسلمين بقوا ـ قياسا للقوى الأخرى ـ على هامش الحركة السياسية في سوريا، ولم يكن لهم تأثير أو وجود فعال.
بدءا من هذا العام 1965 تصاعد وجود وتأثير الإخوان في سوريا، ووصل إلى ذروته في المواجهة الدموية التي شهدتها الساحة السورية بينهم وبين السلطة الحاكمة، وأثبتوا في هذه المواجهة فاعلية وتأثيرا فاقت توقعات الكثير من المراقبين السياسيين، ومع ذلك فإن مشوار الصدام والتغيير الذي مشوا فيه لم يكن على وتيرة واحدة، بل تراجع وخفت تدريجيا، قبل أن يتصاعد مرة أخرى في السبعينات.
هذه المسيرة للإخوان المسلمين في سورية تحتاج إلى كثير من البحث والتحليل، لأنها تجمع في طياتها كل عوامل التفكير والممارسة السياسية، وتختزن كل مدركاتهم، وآفاقهم الاجتماعية والسياسية، وتبين حجم المغامرة السياسية لديهم.
وحتى تكون وقفتنا على هذه المحطة بالقدر الكافي، فإننا مدعوون إلى النظر في بعض المفارقات التي يثيرها هذا التاريخ.
لم تأت ولادة الإخوان المسلمين في سوريا بين عامي 1944ـ1945 مفاجئة ولا عفوية، فقد سبق أن شكل الاخوان جماعة في حلب عام 1935، وسبق ذلك العديد من الجمعيات الإسلامية والخيرية منذ نهايات القرن التاسع عشر، وأشرفت قيادة هذا الحزب في مصر التي كان على رأسها حسن البنا على رعاية البناء المتكامل الذي قام على يد مصطفى السباعي، تلميذ الأزهر، وصديق وتلميذ الشيخ البنا.
واستندت البنية الاجتماعية للإخوان المسلمين في سوريا، وعبرت عن “الطبقة المتوسطة” وأدناها من أبناء المدن، وتجار البازار، والعلماء، والمدرسين، وأصحاب المهن، والبيروقراطية، وكانت هذه القوى الاجتماعية في خضم الحركة السياسية التي تجتاح سوريا، لذلك كان واضحا على الإخوان المسلمين في سوريا أنهم كانوا أكثر انخراطا في العمل الحزبي من قرنائهم في مصر، وأشد ميلا إلى الحياة البرلمانية، وانفتاحا على الحياة الاجتماعية، ولم يكن معروفا وجود قطاع خاص مسلح عندهم.
هذا الاتجاه المميز لهم يمكن أن نفهم ظروفه ودواعيه إذا نظرنا إلى المرحلة التي كانت تمر بها سوريا آنذاك والتي يمكن أن نوجزها في عدد من المؤشرات العامة:
*الاندفاع الغربي نحو التهام سوريا ضمن مخططات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
*بروز القضية القومية كرد فعل على حالة التفتت التي تعيشها سوريا، وكتجاوب طبيعي مع نهوض الفكرة القومية من بدايات القرن العشرين.
*تردي الوضع الاجتماعي، وعنفوان الظلم الواقع على القوى الاجتماعية الفقيرة.
*دخول سوريا مبكرا في متاهة الانقلابات العسكرية المتتالية، التي بان ارتباط العديد منها بتوجهات الغرب وسياساته.
ويبدو أن الشيخ السباعي الذي قاد حركة الاخوان المسلمين حتى العام 1961 كان يدرك هذه المؤشرات، وكان يعيشها، ويتحسس آثارها في بروز أحزاب وأفكار تحاول الرد على هذه الأوضاع.
من هنا نفهم حديثه عن “اشتراكية الإسلام”، وتخصيصه كتابا كاملا لشرح جذور العدالة “الاشتراكية” في الدين الإسلامي، وتأسيسه لجبهة عمل وطني تحت اسم “الجبهة الاشتراكية الإسلامية ” في أوائل الخمسينات، وكذلك موقفه المميز من محاولات ضم سوريا لمقترحات الدفاع الغربية، حينما أعلن باسم هذه الجبهة في آذار 1950:
“نعتزم التوجه إلى المعسكر الشرقي إذا لم ينصفنا الديموقراطيون… ونجيب أولئك الذين يقولون إن المعسكر الشرقي عدونا، متى كان المعسكر الغربي صديقنا، إننا سنربط نفسنا بروسيا ولو كانت الشيطانَ نفسه”.
ولم يصطدم برغبة عبد الناصر في حل الأحزاب حينما عقدت الوحدة السورية المصرية، فقام بحل جمعية الإخوان المسلمين.
ومنذ بداية الخمسينات، وحتى الانفصال فإن عملية فرز مستمرة كانت تجري لهذه الكتلة الاجتماعية المتسعة، وبسبب التعفن الشديد، والفساد المزرى للبرجوازية السورية، والتي قابلها نشاط واسع للقوى السياسية التي ترفع شعارات اجتماعية، وفي المقدمة منها “حزب البعث، والتجمع القومي في الجيش، والحزب الشيوعي”، وكذلك جاءت الإجراءات والسياسات الاجتماعية: الإصلاح الزراعي، التأميمات، لتنزع الكثير من القوى التي شكلت السند الاجتماعي لحركة الاخوان، ولتدفع بجزء آخر إلى الموقف المضاد للحركة والإصلاحات الاجتماعية، كل ذلك في وقت كانت تخاض فيه أعتى المعارك في مواجهة الغرب الاستعماري، وتشع فيه أعلى المشاعر الشعبية القومية في الإقليم السوري.
وإذ تقدم جمال عبد الناصر إلى الوحدة وهو يحمل انتصار السويس العظيم، فإن حركة الإخوان المسلمين افتقدت ـ نتيجة ذلك كله ـ حتى ذلك الهامش الذي كان لها أيام حكومات الاستقلال الأولى.
العوامل نفسها التي واجهها الإخوان في مصر، واجهتهم في سوريا، لكن الظروف كانت مختلفة جدا، على صعيد القوة الذاتية لهم، وعلى صعيد القدرة الاجتماعية لقيادة جمال عبد الناصر، وإذا كان الأمر في مصر احتاج إلى مواجهة دامية معهم، فإنهم في سوريا كانوا دون ذلك بكثير، وأيضا كانت تسري في تربيتهم طبيعة مميزة تجعلهم أقرب إلى التفاعل السياسي السلمي، ويبدو أن طبيعة الدكتور السباعي المنفتحة والسلمية لعبت دورا مهما في تحديد وتميز سلوك الإخوان في سوريا.
لقد خسر الإخوان المسلمون في سوريا، وفي مصر، مواقعهم الاجتماعية في مواجهة عبد الناصر، ولم يخسروها بحكم جولات العنف التي دارت بينهم ـ في مصر تحديداـ وإنما بحكم النظام الاجتماعي والسياسي، أي بحكم المشروع الذي حمله جمال عبد الناصر إلى الأمة العربية، والذي استطاع أن يجمع حوله كل القوى الاجتماعية الفاعلة في الوطن.
فقط مع قدوم حزب البعث إلى السلطة في سوريا، ومع ذلك الصدام الدامي بين البعث وبين التيار الناصري، بدأ حزب الإخوان المسلمون بالنمو مجددا، إن ملاحظتنا هذه تستدعي الوقوف على طبيعة هذا الحكم، وأثر الصدام البعثي الناصري في تنمية الاخوان المسلمين، ودفعهم مجددا الى الفعالية السياسية.
إننا لا نبغي الوقوف على دواعي ذلك الصدام، ولا أن نتعرض بالتقييم اللازم لحزب البعث العربي الاشتراكي، وإنما نحاول ان نكشف عن الخلل الاجتماعي والسياسي الذي رافق أو تولد عن حكم هذا الحزب، وصدامه مع التيار الناصري:
**إن أولى هذه المظاهر التي رافقت وصول حزب البعث إلى الحكم كان اصطدامه مع الأغلبية الشعبية التي كانت ترى في استمرار الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة، استمرا لانتصار منطق التجزئة، وإرادة الغرب في إيقاف عجلة الوحدة، وبعيدا عن كل التفصيلات، والوقائع التي كانت وراء أحداث هذه المرحلة، فإنها إذ بدأت بإفشال مشروع الوحدة الثلاثية بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق، فإنها توجت بشكل سريع بالصراع الدموي الذي كانت أحداث 18 تموز 1963 علامة بارزة فيه، وصار الصدام بين قوى كان المفروض أنها قوى قومية هو الغالب.
**وثاني هذه المظاهر بروز حكم القلة في سوريا، وإذ جسدت هذه القلة في البدء خليطا من المجتمع السوري، فإنه صار يتضح يوما بعد يوم أن هذه القلة يهيمن عليها، ويسيرها تكتل طائفي يضم عددا من الأقليات المذهبية في سوريا، وإذ بدا هذا الأمر واضحا في انقلاب 23 / 2/ 1966، فإنه كان معروفا قبل ذلك، وبالتحديد منذ حركة 8 /3 / 1963، وعاد ليبرز بشدة عقب حركة 16 / 10 / 1970 التي قادها الرئيس الحالي حافظ الأسد.
**وثالث هذه المظاهر تكمن في الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي قام بها حكم القلة هذه، وهي إجراءات اتخذت طابع المزايدة على الثورة الاجتماعية الجارية في مصر، وإذا كان من المفروض في هذه الإجراءات أن تضيف إلى حكم البعث طبقتي العمال والفلاحين، وتساهم في عزل قوى الاستغلال في المجتمع، فإنها بحكم طبيعتها، وطبيعة السلطة التي تجريها عزلت هاتين الطبقتين، وتصادمت معهما، ونمت قوى جديدة، عرفت فيما بعد باسم ” الرأسمالية الطفيلية”.
** وما لبث هذا الحكم أن عكس طبيعته الطائفية على مسلكه الفكري والإعلامي، فشهدت سوريا لأول مرة حالة استهتار مخجلة بالقيم الدينية، وبدا هذا الحكم بعد حركة 23 شباط 1966 وكأنه متبن للماركسية، ومزاود في تجاوز الجانب الديني حتى على الحزب الشيوعي نفسه.
لقد فعلت هذه المظاهر الأربعة، وبجانبها الكثير من التفصيلات فعلها في المجتمع السوري، فعملت على ضرب شعاري الوحدة والاشتراكية، وعزلت قواهما، وأنبتت المظهر الطائفي في السلطة والمجتمع، وصدمت جذور الشعب الإسلامية، فميعت بذلك الحدود بين الطبقات الاجتماعية، وكان طبيعيا في مثل هذا الوضع أن يسترد الإخوان المسلمون الأرضية التي افتقدوها سابقا، وأن يعاودوا النمو، ولم يقتصر الأمر عليهم، وإنما صارت هناك نهضة عامة ومؤثرة للقوى الدينية سواء تمثلت في هذا الحزب أم في جمعيات وأحزاب متفرعة.
وحينما جاء حكم الأسد في سوريا، تعززت كل المظاهر السابقة، وعلى وجه الخصوص النمو الهائل للرأسمالية الطفيلية، مع ما صاحب ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية، وكذلك السمة الطائفية في الحكم بعد أن افرزت هذه السمة تشكيلاتها السياسية والعسكرية.
إن خلاصة حكم حزب البعث تشير إلى أنه أعاد تشكيل القاعدة الاجتماعية التي اعتمد عليها حزب الإخوان المسلمين في جو تفوح منه رائحة الطائفية.
كانت حركة 8 آذار 1963 وحتى 23 شباط 1966 هي البداية، وقد تصاعد هذا الوضع ونما في فترة صلاح جديد، ثم أعطى ثماره في حكم حافظ الأسد، وصار المجتمع السوري مهيأ للرد على هذا الواقع، فكيف جاء الرد؟
كل ما أتينا عليه كان بغرض أن نبسط الواقع لنتعرف إلى سلوك هذا التنظيم في مواجهته:
1ـ لقد بنى الإخوان المسلمون صراعهم مع السلطة على أساس ” ديني ـ مذهبي”، أي على أساس طائفي، وشهدت المرحلة الأولى من صراعهم التي اتسمت بقاعدة “اضرب واهرب” تجسيدهم لهذا الأساس، حيث قامت عمليات الاغتيال على قاعدة أن العلويين “كفرة”، ويجب قتلهم، ولم يوفروا في هذا السبيل أحدا، ثم لم ينظروا إلى مواقف أبناء هذه الطائفة الوطنية أو القومية، ولم يعيروا أي انتباه إلى حقيقة أن الحكم القائم يضطهد الأغلبية الشعبية سواء كانت سنية أو علوية.
إن تحليلهم الذي انحصر في هذه الزاوية الطائفية، التي لا تعبر عن أي حقيقة اجتماعية راسخة، كان لها آثار خطرة، ومن أخطرها أنها دفعت أغلب “العلويين” إلى التكتل حول السلطة، ليس حبا فيها، وإنما لحماية أنفسهم من عمليات الاغتيال المتصاعدة.
لقد أقاموا من أنفسهم حَكَما على ضمائر الناس، ومعتقداتهم، فوضعوا بذلك الحجر الأول والأساسي في ضرب الوحدة الوطنية للمعارضة في الإقليم السوري.
وعلى طريق هذا الصراع أقاموا تحالفاتهم الخارجية مع قوى رجعية ظاهرة أو مستترة، تمثل أشكالا متعددة من حكم القلة، ومن الديكتاتوريات العاتية.
لقد كان النظام الأردني والعراقي حليفي هذا التنظيم في معركته، وإذا كانت طبيعة النظام السوري وسياساته تضعه في صف القوى المواجهة للأغلبية الشعبية، والغارقة في دوامة التغريب، فإن من الصعب على أي ناظر أن يضع حليفي الإخوان خارج هذا الإطار.
وأقام الإخوان هذا التحالف في وقت كانت فيه مسيرة الاستسلام التي قادها أنور السادات تخترق العديد من النظم العربية، وفي المقدمة منها النظامين الأردني والعراقي.
لقد استفاد الإخوان المسلمون كثيرا من المعركة التي فتحها النظام السوري مع المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية في آذار / مارس 1976، والتي وقف فيها إلى نصيرا للقوات الكتائبية، وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المعركة التي زادت من عزلته الداخلية، لكنهم إذ استندوا في موقفهم إلى دعم نظامي عمان وبغداد فإن مواقف هذين النظامين من الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية كانت مواقف واضحة، ومعروفة، وهي بطبيعتها تسقط أي قيمة نضالية، وأي مصداقية لاعتراضهم على الدور السوري في لبنان، وعلى سلوك النظام السوري في هذا الإطار.
لقد أفقدهم هذا التحالف مصداقية حديثهم عن المآخذ التي بدا أن الاخوان يأخذونها على النظام السوري.
3ـ وفي إبان الصراع فإنهم رفضوا بإصرار إقامة أي تحالف وطني داخل سوريا، بل إن أحاديثهم المباشرة كانت تضع كافة القوى الوطنية من قوميين ناصريين إلى شيوعيين قوميين، إلى بعثيين مناهضين للنظام القائم على قدم المساواة مع هذا النظام، واستمروا في موقفهم هذا حتى وضح لهم عجزهم عن تحقيق النصر، حينذاك أقاموا تحالفهم في إطار ” جبهة إسلامية لتحرير سوريا”.
إن من الخطأ التكتيكي الفادح تكتيل قوى الخصم، وزيادة فاعليتها، وقد فعلوا ذلك حينما بدأوا معركتهم على أساس طائفي.
ومن الخطأ السياسي الفادح أيضا صد القوى المناهضة لذلك الخصم، وقد فعلوا ذلك حينما رفضوا أي تحالف أو تعاون.
ومن الخطأ أيضا إقامة تحالفات مع قوى تحمل خصائص الخصم نفسه على مختلف الصُعد، وقد فعلوها أيضا حينما تحالفوا مع النظامين العراقي والأردني.
وإذ نلحظ هذه الأخطاء فمن السذاجة أن نردها إلى مجرد خطأ التقدير، وإنما علينا البحث عن دواعيها في فكرهم، وطبيعتهم السياسية والاجتماعية.
4ـ وقد خططوا في معركتهم ضد النظام للوصول إلى مرحلة الحرب الأهلية، والتفجير الوطني، وتقدم حادثة ” مدرسة المدفعية” في حلب مثالا على ذلك، حيث دخلوا إلى هذه المدرسة العسكرية، وسيطروا عليها، وأخرجوا منها طلاب الضباط العلويين، وأعدموهم،… وفي مرحلة لاحقة تمترسوا في مدينة حماة، وأعلنوا بدء عملية “التحرير” عبر إذاعتهم الخارجية الموجهة، وحرقوا مؤسسات القطاع العام في عدد من المدن السورية …..وفي كل هذه الخطوات لم يحسبوا أي حساب للتضحيات التي سيدفعها الشعب، حيث سقط من أبنائه في مذبحة حماة عشرات الآلاف من القتلى، ولم يتجاوز المصابون من الإخوان العشرات.
5ـ نستطيع أن نفترض أن القيادة السياسية للإخوان أدركت تلك الأخطاء التي وقعت فيها، فعملت على تشكيل جبهة من عدد من القوى السياسية تحت شعار إسقاط النظام، ولخصت أهداف هذه الجبهة في نقاط عدة أهمها:
*الطلب من عقلاء العلويين الوقوف مع الجبهة ضد نظام الأسد من أجل الحيلولة دون وقوع حرب أهلية.
*الدعوة إلى تحرير كل المواطنين من الطغيان، وإلغاء السجون السياسية، والإقرار بحرية الفكر والرأي، والحفاظ على حقوق الأقليات، وضمان الحريات الفردية.
*تأييد ملكية المزارعين الكاملة للأرض، واستبعاد الوسطاء، والدولة من القطاع الزراعي.
*نقل ملكية الصناعات العامة من الدولة إلى العمال الذين يجب مكافأتهم بطريقة مناسبة وبدون بذخ.
*معارضة دور الدولة في التجارة، والمطالبة بحرية القطاع الخاص في الاتجار بالمنتجات، وتشجيع الحرفيين.
هذه الأهداف تسلط الضوء على التوجه الاجتماعي، وبالتالي على القوى الاجتماعية التي تستند إليها هذه الجبهة، وتحاول التعبير عنها، وهي أهداف تخلو من أية إشارة إلى “مشروع سياسي ـ اجتماعي” جدي يمكن أن يستقطب حوله قوى المجتمع.
إن نقطتين من هذا البرنامج تستدعي الانتباه، ويمكن أن تثير بعض الظلال على طبيعته:
النقطة الأولى: تتمثل في قضية الحريات العامة، وهي قضية لا نجد لها فهما واضحا في تاريخ الإخوان. وبعض الأمثلة التي وقفنا عليها تخبرنا عن فهمهم لطبيعة الحريات فيما كانوا هم عماد السلطة، والقوة الرئيسية المنظمة فيها، إضافة إلى حقيقة أن هذه القضية أصبحت جزءا من “المفاهيم الاجتماعية غير الطبقية”، أي أنها أصبحت من القيم العامة التي تشير إلى مدى تقدم الوعي العام في الأمة، أكثر من إشارتها إلى إيديولوجيا محددة، ورغم اعتقادنا بدقة هذا التوصيف فإن مسلك الإخوان تجاهها لا تضعهم في مكان يخالف موقع السلطة نفسها من هذا الشعار، ويزيد من صحة حكمنا هذا أن القوى المشاركة للإخوان في هذه الجبهة هي قوى تمارس اليوم، على الأرض، أشكالا عالية من الحكم الديكتاتوري ” بعث العراق”.
النقطة الثانية: تتمثل فيما ورد بشأن نقل ملكية الصناعات العامة من الدولة إلى العمال، وهو نص غامض لا يحتوي على معنى حقيقي غير رجعي، وهو أيضا نص متناقض، حيث لا معنى للقول بمكافأة العمال بطريقة مناسبة، وبدون بذخ، حينما نعتمد إسناد ملكية هذه الصناعات لهم، إلا إذا كان المقصود إعادة سيطرة الرأسماليين على المصانع.
إن النص في جوهرة يدعو إلى التشدد مع العمال سواء كان المالك ” دولة أو فرد”، ويصف حياتهم الحالية بالبذخ، وهذا وصف حين نقارنه بواقع العمال الحالي فليس أمامنا إلا الدهشة من غرابة هذا الفكر.
يبدو لنا أن الدافع الأساسي لإيراد هذا النص، وهذا الغموض والتناقض فيه، لم يستهدف معالجة الآثار السلبية المرافقة لملكية الدولة للقطاعات الإنتاجية، وإنما بروز واقع موضوعي أمامه، واقع متمثل بأن الغالبية العظمى من المؤسسات الصناعية الموجودة الآن هي أصلا من إنشاء الدولة، وأن ما تم تأميمه قياسا لما هو موجود لا يعدو أن يكون جزءا يسيرا ليس له وزن.
هذا البرنامج، والذي يمثل العقل السياسي والاجتماعي للقوى المتحالفة يدفعنا لتذكر موقف الإخوان في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن، من مسألة الملكية في القطاعات الثلاثة: الصناعة، الزراعة، والتجارة، وهو موقف قائم على الإباحة الكاملة غير المقيدة إلا بالمحرمات الإسلامية المحددة بنص. ويشير في الوقت نفسه إلى مدى الجمود في تفكيرهم الاجتماعي، بل وفي التراجع عن مناحي تفكير متقدمة نجدها عند عدد من مفكري الإخوان المسلمين في مراحل سابقة.